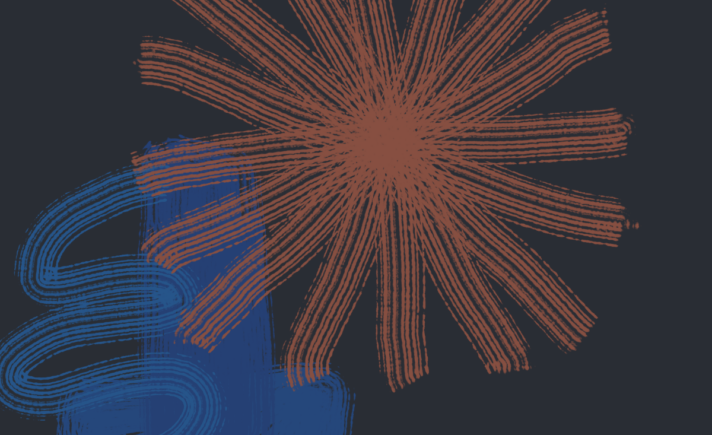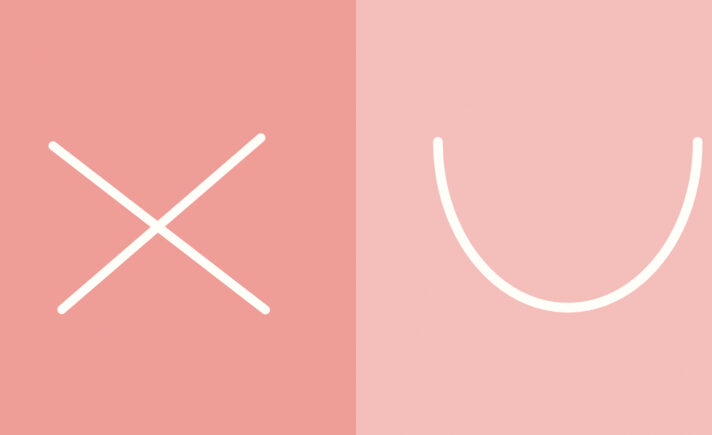منذ ما يقارب الثلاثة أعوام وجدتُ نفسي لاجئة، ورغم أن اللجوء حق يكفله القانون للإنسان، إلا أنه أبغضُ الحقوق عند الإنسان.
منذ بداية مسيرتي كلاجئة عانيت، كسائر اللاجئين، من النمطية الساذجة التي نُقابَل بها، النمطية السلبية التي تقوم على معاملتنا كوافدين من خارج التاريخ. كان هذا في المراحل الأولى، أما بعد دخولي في عدة برامج لتعلّم اللغة والاندماج، واحتكاكي مع فئات مختلفة في المجتمع، بدأت أواجه نمطية مختلفة، نمطية تطالبني بأن أكون «سوبر لاجئة»، أن يكون لدي معاناة «سيكسي» تجعل الحنك يسقط حين أروي قصتي، ونتيجة نهائية تجعل العين تدمع والقلب يمتلئ فخراً بحسن انتقاء فرنسا لهذه اللاجئة، متجاهلة أنني لم آت إلى هنا لأصنع الأمجاد، وأنني لا أحتاج لقصة نجاح مبهرة كي أنال حقي في الحصول على حقي. بالنتيجة بدأتُ أحنّ وأحتفي بـ«عاديّتي»، وقد يبدو هذا للوهلة الأولى جحوداً من طرفي، إذ ما هو السيء في الاحتفاء «بنجاحي»؟ حسناً، المادة محاولة للإجابة عن هذا السؤال.
اللاجئون في فرنسا، المسيرة الإدارية نحو قرار اللجوء
خائفاً من الاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية أو بسبب آرائه السياسية، يجد نفسه خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع، أو لا يريد نتيجة هذا الخوف، العودة إليها. هكذا تُعرّفُ اتفاقية جنيف الشخص اللاجئ، وأقول الشخص اللاجئ محاولةً الالتزام بالصوابية السياسية المُشجَّع عليها بين العاملين مع الأشخاص اللاجئين، على اعتبار أن مصطلح «لاجئ» يحوي اختصاراً غير مبرّر للأفراد حاملي صفة اللجوء، أو الحاصلين على حق اللجوء.
ظهر هذا النوع من النقاشات في السنوات الأخيرة في فرنسا، مترافقاً مع موجة اللجوء، ولا يكفي بالطبع أن تنطبق المعايير المذكورة في اتفاقية جنيف على الفرد ليحصل على قرار اللجوء، بل على الواصل أن يثبت أحقيته، ويتم هذا عبر سلسلة من الخطوات التي لا يمكن إتمامها دون إتقان الفرنسية إتقاناً كاملاً، أو بالطبع طلب مساعدة من يتقنها.
تُعدُّ مرحلة إعداد الملف لتقديمه للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أكثر المراحل حساسيةً وتأثيراً في مصير طالب اللجوء، حيث يجد الشخص نفسه مطالباً بسرد قصة حياته بالتفاصيل الدقيقة، وضعه العائلي والمهني، الأسباب التي دفعته لمغادرة بلده وتمنعه من العودة، تفاصيل عن حوادث بعينها شكّلت الخطر الأكبر على حياته، مع ذكر تواريخ وأسماء ومواقع، كل ذلك بالطبع مع الحفاظ على التسلسل الزمني والمنطقي لكل المذكور، باللغة الفرنسية التي لا يتحدثها معظم طالبي اللجوء.
يلجأ الواصلون في هذا الحالة إلى الجمعيات المتخصصة بمساعدة طالبي اللجوء، ويصلون إليها إما عبر شبكة معارفهم من مجتمع اللاجئين، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق مراكز الإيواء المؤقتة، وأحياناً يعثرون عليها بالصدفة البحتة في طابور الانتظار للبصمة.
ولا يقتصر دور الجمعيات هنا على الترجمة، الأهمية الحقيقية والأمر الذي يصنع فارقاً هو إلمام الفريق بقوانين اللجوء، وقدرته على صياغة القصة بحيث يضيء على جوانب تزيد احتماليات حصول الفرد على حق اللجوء، واستخدام المصطلحات والعبارات الواردة في اتفاقية جنيف، ويمتدّ الأمر إلى توفير طرق للالتفاف على قوانين من نوع اتفاقية دبلن، التي قد تقف عائقاً بين طالب اللجوء والورقة المنتظرة.
بعد أن يسرد الشخص قصة حياته بتفاصيلها الدقيقة، التي لا يمكن أن تخلو من الحميمية والخصوصية والأحداث الحساسة التي يتجنب أحياناً التفكير فيها ناهيك عن التحدث عنها مع غريب تماماً عنه، تأتي مرحلة التحضير لمقابلة اللجوء، الجلسة التي يجد اللاجئ فيها نفسه مقابل «محقّق» يشكّك في كل ما يقوله، وهنا يتحدث طالب اللجوء بلغته حيث يحقّ له طلب مترجم، ومجدداً يفرد حياته أمام غريبين، ويستعرضها قطعةً قطعة على أمل أن تفوز إحدى هذه القطع بانتباه المحقق وتكفل له تصنيفه ضمن اللاجئين، أو الأشخاص اللاجئين.
الخدمات المقدّمة في هذه المرحلة تختص بها الجمعيات الحقوقية التي توفّر المساعدة القانونية وتسهّل المسيرة البيروقراطية على الواصل حديثاً، ويبدو هنا واضحاً أهمية المجتمع المدني منذ اللحظة التي تطأ فيها قدم الفرد أرض اللجوء المحتمل، فدونها يصاب الواصل بسهولة بالشلل الإداري الكامل، وبالطبع لا ينتهي الدور عند هذه المرحلة، إنها مجرد خطوة أولى على طريق تُرافق فيه الجمعياتُ الأفرادَ في سعيهم لـ«الاندماج» على اختلاف تعريفات ومجالات هذا المصطلح.
الاندماج، بين دور الدولة ودور المجتمع المدني
قد يتساءل المرء هنا أين الدولة الفرنسية من كل هذا؟ في الحديث عن حقوق الشخص اللاجئ وفق معاهدة جنيف يُذكَرُ حق السكن، حق الرعاية الصحية، الاستحقاقات الاجتماعية والعائلية، الحق في لم الشمل وحق طلب الجنسية وبالطبع حق العمل.
منذ اللحظة التي يحصل فيها الفرد على حق اللجوء يصبح مطالباً بحضور دورة أو تدريب مدني، وهو تدريب يمتد على يومين، يشمل اللاجئين والمهاجرين؛ في اليوم الأول يستعرض قيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية، وبحسب المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج فإن الهدف هو معرفة المجتمع الفرنسي، وفهم قيم ومؤسسات الجمهورية، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة في فرنسا لتحضير اندماج جمهوري في المجتمع الفرنسي، فيما يركّز اليوم الثاني على العيش والحصول على عمل في فرنسا، ويدور حول ستة محاور، الاستقرار في فرنسا، الحصول على الرعاية الصحية، الحقوق الاجتماعية، التعليم، السكن والعمل.
بالإضافة للكثافة والاختصار الذي يؤثر على فاعلية هذا التدريب، فإن هذه المحاضرات تعطى باللغة الفرنسية، يمكن طلب مترجم لكن الحاضرين يأتون من جنسيات مختلفة، وعند تحدّث المحاضر وعدة مترجمين في وقت واحد، حسناً… يمكنكم تخيّل ما يحدث عندها.
أما عن تعلم اللغة الفرنسية، فيخضع الفرد لامتحان تحديد مستوى، ويتم على أساسه تحويله إلى دورات اللغة المناسبة له، إما بـ 200 ساعة أو 100 أو 50، شريطة ألا يتجاوز مستواه الـB1، أي أن الدروس تبقى للمبتدئين، وتبقى بعدد ساعات محدود وغير كاف لإتقان اللغة.
والدولة الفرنسية واعية تماماً لقصور هذا الدور، وتعمل منذ سنوات على تلافيه؛ في 2017 عبّر عن ذلك مدير اللجوء في وزارة الداخلية رافائيل سوديني بقوله «يجب تعزيز فرص الحصول على عمل وتعلم اللغة»، وبالفعل بدأ العمل عليه عبر وضع استراتيجية وطنية وتأسيس إدارة بين وزارية لاستقبال واندماج اللاجئين، واقتراح زيادة الميزانية المخصصة للاندماج بنسبة 40% في عام 2019، بما يتضمن دعم المجتمع المدني الذي يشكّل ضرورة حيوية لاندماج اللاجئين في المجتمع الفرنسي. تدرك الدولة أهمية هذا الدور، وترعى المبادرات المتعلقة باللاجئين مادياً وقانونياً.
ولادة «سوق اللاجئين»
تنقسم تخصصات الجمعيات والمؤسسات المتخصصة بمرافقة اللاجئين إلى عدة أقسام، بدايةً نرى الاستجابة العاجلة المتعلقة بالإنقاذ والرعاية الطارئة، وهي قليلة في فرنسا مقارنة باليونان وإيطاليا؛ جمعيات حقوقية وإدارية؛ جمعيات التوعية بالحقوق الأساسية ومحاربة التمييز؛ جمعيات تعنى بتوعية المجتمع المضيف؛ جمعيات تختصّ بتعليم اللغة والمساعدة على الاندماج؛ جمعيات المرافقة المهنية التي أخذت حيزاً هاماً من الاهتمام المادي والمعنوي في فرنسا نظراً لحيوية الدور الذي تلعبه والنتائج المباشرة والواضحة لعملهم، وتلك الأخيرة تتركز بصورة رئيسية في العاصمة والمدن الكبيرة.
عند البحث في مصادر تمويل الجمعيات نرى الاهتمام الكبير الذي تحظى به، المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي سنوياً لأكثر الجمعيات تأثيراً فيما يتعلق بسؤال المهاجرين واللاجئين، والمواقع التي تعرض فرص التمويل الحكومي وغير الحكومي المقدّم من قبل المنظمات الدولية والشركات الكبرى مثل توتال، والمواقع التي تشرح كيفية طلب فرص التمويل وتعظيم فرص الفوز بها، وبالطبع كيفية الإبقاء على نسب نجاح تكفل تجديد التمويل والحصول على فرص تمويلية جديدة، بالإضافة إلى تأسيس جمعيات لمرافقة اللاجئين أو التطوع فيها من قبل الطلاب الجامعيين كمشروع تخرّج أو واجب لأحد المقررات أو متطلبات التخرّج.
وتحتدّ المنافسة في هذا السوق، الذي يتصدّر اللاجئ فيه كسلعة رئيسية، وتصل أحياناً لتشويه سمعة جمعية منافسة أو رفض التعامل مع جمعيات معينة، وفي كل دفعة مشاركين يكون من الضروري إيجاد مشارك واحد على الأقل يمكن استخدامه كقصّة نجاح.
قصص النجاح، أداة المنافسة في السوق
قصص النجاح، أحاول منذ مدة إيجاد تعريف مناسب لهذا المصطلح الفضفاض، تجد عند البحث «شخص أو شيء أصبح ناجحاً جداً» أو «شيء أو شخص حقق هدفاً أو ثروة أو شهرة»، وتجبرك هذه التعريفات على المزيد من البحث عن تعريفات للنجاح والثروة والشهرة، أما عند متابعة دليل قصص النجاح للـ NGOs الأَشهَر، تجد نصائح متعلقة بصياغة وتقديم قصة النجاح، التركيز على النتيجة النهائية وليس الرحلة، استخدام صور لوجوه حقيقية وأنسنة الحكايات، وغيرها من النصائح التي تمكّنك، بالإصرار الكافي، في الحقيقة من تحويل القصص، أي قصص، إلى قصص نجاح.
الوصاية واحتكار اللاجئين، واقعان تواجههما عند متابعتك لأعمال بعض الجمعيات أو حين تكون مشتركاً في برامجهم، فكما يحدث في أي سوق تظهر سريعاً نتائج المنافسة، التي تخضع لشروط المنافسة حتى حين تحصل للأسباب «الجيدة». منذ بداية مشواري كلاجئة، عشتُ مواقف يتحول فيها المساعد إلى وصي، يعتقد أنه الأقدر على تحديد مصلحتك وما ينفعك، وأنه الأكثر فهماً لمعاناتك، أكثر منك أنت أحياناً.
أستعير هنا قصة صديقة فرنسية قامت بتحضير ورشة عمل مجانية عن السينما، موجهة لتعريف مجتمع اللاجئين بالسينما الفرنسية والتحاور معهم حولها، وباعتبارها تجربتها الأولى قامت بالتواصل مع جمعيات مرافقة اللاجئين في باريس للإعلان عن الورشة واستقطاب جمهورها؛ لم تكن قادرة على إخفاء صدمتها عند الحديث عن ردود هذه الجمعيات، حيث أنها كانت مُطالَبة بتقديم شرح مفصّل إما أن توافق عليه الجمعية وتعرضه على المستفيدين، أو أن ترفضه دون أن تترك للأشخاص خياراً.
وحالة الوصاية هذه ليست الأولى بالطبع، وأورد هنا تجربة شخصية مع مؤسسة لمرافقة الفنانين المنفيين في باريس. كنتُ مطالبة مع مجموعة من الطلاب بإجراء بحث متعلّق باللاجئين فاخترنا هذه الجمعية. تواصلتُ مع أحد أصدقائي فيها وقمنا بزيارتها، وعند تعريفنا بأنفسنا وغرض زيارتنا ورغبتنا بالتحدث إلى الفنانين، استدعت موظفة الاستقبال المديرة التي أتت غاضبة ومحتقنة، وبدأت بسرعة في تفسير أن هذا المكان ليس حديقة حيوان بشرية، وأننا لا نملك الحق بالحديث إليهم لأنهم يأتون إلى هنا بهدف نسيان ماضيهم وحياتهم السابقة، وحين أخبرتها أنني بدوري لاجئة سورية وأرفض هذا التعميم حيث أن اللاجئ لا يهدف بالضرورة إلى الانسلاخ عن ماضيه ونسيانه، ويملك الحق في قبول أو رفض الحديث عنه، ورغم وجود طالبة تعمل مع اللاجئين منذ ستة أعوام، فقد ظلّت المديرة مصرّة على أنها الوحيدة القادرة على تقرير مصلحتهم، ولم تهدأ إلا عند تذكيرها باسم جامعتنا التي تعتبر نخبوية، حيث بدأت تتقلص النبرة العدائية وتهدأ، وأخذت تتحدث عن شراكة مع الجامعة تقبل بموجبها بعرض «لاجئيها» على الطلاب، وذهبت أبعد من ذلك بأن شجعتنا على الحديث عن المركز مع زملائنا ودعوتنا لزيارته.
وكنتُ سآخذ هذا الموقف بحسن نية لولا أنني وعند زيارة أحد الأصدقاء في مقرّ الجمعية ذاتها شهدت حواراً مثيراً للاهتمام، طالبت فيه صديقي بالتواجد في الصباح التالي لدى زيارة أحد الممولين، شارحة أهمية إضفاء مظهر حيوي ومزدحم على الجمعية، وأصرّت على أن يقبل رغم رفضه الشخصي الذي عبّر عنه في أكثر من مناسبة عن التحول إلى فنان لاجئ، وإصراره على تقييم فنه بمعزل كامل عن وضعه القانوني. تُقدِّمُ حالة الوصاية والاحتكار نفسها بصور وأشكال مختلفة، لكنها تدور في الفلك ذاته.
«السوبر لاجئ» التنميط الجديد للاجئين
ظاهرة «القرد الناطق» وتوظيفها في التنميط
يقابل التقديرَ الاستخفافُ على الطرف الآخر من المعنى، وقد يشعر المرء أن التقدير احترامٌ بطبيعته، لكنّ الواقع يحوي ما يقول عكس ذلك؛ الحقيقة أن التقدير المبالغ به قد ينطوي على قدر كبير من الإهانة، ويمكننا رصد هذه الظاهرة بوضوح في علاقة اللاجئ بالمجتمع المضيف، حيث أنه يجد نفسه في مواقع عديدة وقد تحول إلى «قرد ناطق»، ليس بالمعنى الفلسفي أو التطوري للمصطلح، إنما ببساطة بالمعنى المسلي للكلمة، حيث يكون أي تصرّف يقوم به اللاجئ مصدراً للانبهار، فكيف للاجئ أن يتحدث لغة أجنبية أو أن يملك شهادة جامعية أو أن يرتدي ملابس نظيفة ومرتبة؟
في مجموعة على فيسبوك تضم شباباً سورياً مهاجراً طرح أحد الأعضاء سؤالاً حول الاعتقادات المسبقة التي واجهت السوريين في الخارج، بعض الإجابات أتت مفهومة بجذور قابلة للتفسير، الإجابات الأخرى جاءت على قدر لا يخلو من الغرابة بالدرجة الأولى، وبالنظر للإجابات يمكنك سريعاً ردُّ الأمر إلى الجهل، الجهل بالمجتمعات التي يأتي منها اللاجئون، والاستعداد الشديد للتعميم بناء على شخص واحد أو مقالة واحدة قرأوها عن دولة قد لا تشبه دولتك في أي شيء. يطول الحديث عن الـ single story وأخطارها، لكن الحقيقة أن المجتمعات المضيفة لا تبذل المجهود الكافي لفهم خلفية هؤلاء الوافدين، وهنا يأتي من جديد دور المجتمع المدني في التوعية.
وللانتقال من الانبهار إلى الإبهار، يبدأ بعض العاملين مع اللاجئين بـ «تلميع» صورة اللاجئ، وتسليط الضوء على اندماجه في المجتمع الجديد، مجدداً استخدام استراتيجية القرد الناطق، حيث يتم الحديث عن أي تفصيل صغير على أنه إنجاز لمجرد صدوره عن لاجئ، ويتم اختيار الإنجازات التي تشابه المجتمع الجديد، فلا يتم الاحتفاء بالاختلاف هنا، ويدخل اللاجئ في حلقة مفرغة من التنميط والتنميط المعاكس.
كيف تبدو حياة السوبر لاجئ خلف الكواليس؟
لا يمكن بالطبع إغفال الآثار الإيجابية لقصص النجاح على الشخص «الناجح»، في كتابه قلق السعي إلى المكانة، يقول آلان دو بوتون «يعدّ اهتمام الآخرين مهماً لنا لأننا مبتلون بانعدام يقين نحو قيمتنا الخاصة»، ويتحدث آلان عن الناس، كل الناس، ناهيك عن إنسان فقد كل ما يملك ووجد نفسه في مكان جديد وغريب يحارب ليحظى بالقبول منه.
تأخذ هذه الآثار الإيجابية أهمية خاصة في حياة اللاجئ، الذي يصل إلى بلد يكون فيها بالضرورة نكرة، الأمر الذي قد يسبب له صدمة بناء على وضعه السابق، فالإنسان في بلاده يمتلك حداً أدنى من العلاقات الاجتماعية وفهماً لمحيطه على الصعيد اللغوي على الأقل، ويمكن لوضع السوبر لاجئ التخفيف من أعباء صدمة الأمية اللغوية والاجتماعية الحاصلة. دفقة الاهتمام هذه التي تندلق على اللاجئ تترافق بارتفاع ثقته بنفسه لأن الشعور بتقدير المحيط غالباً ما يترجم بتقدير أفضل للذات، وتفتح له أبواباً لتشكيل شبكة أمان اجتماعية، تساعده في الحصول على فرص على مختلف الأصعدة، وقد تعود بفائدة مادية أحياناً.
لكن هل يحدث هذا دائماً دون أثمان؟ للإجابة على هذا السؤال استشرت عدداً من أصدقائي الذين تم تصديرهم كقصص نجاح من قبل الجمعيات المرافقة لهم، ما الذي يحدث بعد الـ 15 دقيقة من الشهرة التي يحصل عليها اللاجئ؟
يقول أحدهم إنه انتقل من تقدير منخفض للذات إلى تقدير مُرضٍ، حيث أصبح يشعر بالعار من طلب المساعدة على اعتباره فرداً ناجحاً ملهماً؛ وتؤكد صديقة لي أنها على عكس المتوقع فقدت الحافز للعمل، انخفض سقف طموحها عند رؤيتها لما يعتبرونه نجاحاً، وتحاول منذ سنتين تدارك الفجوة التي أحدثها التقاعس الذي جاء متأبطاً ذراع هذا الانخفاض؛ تخالفها صديقة أخرى وجدت نفسها مستنزفة بالكامل وهي تحاول المحافظة على صورة السوبر لاجئة، حيث باتت ترى نفسها ممثلة لمجتمع اللاجئين، ومجبرة على تحصيل إنجاز يتبعه الإنجاز للإبقاء على منصبها كلاجئة ناجحة، ولم تعد تعرف ما ترغب به فعلاً، ولا تخفي أنها تشعر بالزيف أحياناً، خاصة حين تجبر نفسها على قول أو فعل ما يتناسب مع الوضع الذي وجدت نفسها فيه وليس فعل ما يشبهها حقاً.
أسأل صديقاً متعثراً في دراسته عن الجمعية التي كانت ترافقه قبل دخوله الجامعة، يخبرني أنه تواصل مع المتطوع المسؤول عنه لكنه لم يرد اتصالاته أو رسائله، وعند بحثه عن الأسباب اكتشف أن تطوع الطالب معه كان مفروضاً عليه من الجامعة للحصول على علامات في مقرر، وبعد ذوبان فقاعة النجاح لم يعد يجد تجاوباً من المرافقين. وهذا الصديق لم يكن قصة نجاح بارزة تستحق الاحتكار، بل كان قصة نجاح معدة للاستهلاك السريع وتدخل في الأرقام ونسب النجاح التي تساعد في الحصول على تمويل جديد للجمعية.
ويمكنني إضافة نقطة متعلقة بالهوية هنا، حيث أن قصص النجاح هذه تربط الفرد بوضعه القانوني بصورة يصعب الهروب منها، فتعرّف الفرد على أنه لاجئ ولا تفصل بين إنجازات الفرد ورحلته، ولا يرغب الأفراد اللاجئون دائماً بالتعريف بأنفسهم كلاجئين، فرغم أن اللجوء حق ووضع قانوني لا عيب فيه، لكن الإنسان يملك حق اختيار ما يعرّف نفسه به، خاصة عندما تكون صفته القانونية مقابلة لوصم مجتمعي ما.
وماذا عن «العاديين» وحقهم في الوجود؟
حسناً، ماذا عن مجتمع اللاجئين؟ سائر «العاديين» الذين لا نرى صورهم في المواقع الالكترونية والشاشات، ولا نقرأ لقاءات معهم ولا نسمعهم في الراديو؟ ماذا يحدث لو نجحت المساعي بالفعل في تبديل الصورة النمطية السلبية عن اللاجئ بصورة نمطية جديدة هي السوبر لاجئ؟
يعود تبديل الصورة النمطية للاجئين بصورة أكثر إشراقاً بمنافع على مجتمع اللاجئين ككل، فهذا يعني تمويلاً أكبر للجمعيات، اهتماماً أكبر، قبولاً أكبر، وبالطبع ينعكس إيجاباً على حق اللاجئ بالوجود، المهدد دائماً بصعود اليمين المتطرف واستخدام اللاجئين كورقة رابحة في الانتخابات.
مجدداً مكاسب غير مجانية، كحال الصديقة التي تحرق نفسها للمحافظة على صورة السوبر لاجئة، يحرق عدد كبير من اللاجئين أنفسهم للوصول إلى هذا المركز. منذ حوالي الشهر تابعتُ منشوراً في مجموعة للاجئين في فرنسا، يقول صاحبه إن قناة تلفزيونية تطلب أفراداً ناجحين لعرض قصصهم في برنامج، ويمكن القول أن العرض شهد إقبالاً ملحوظاً، كان لديَّ معرفة شخصية ببضعة متطوعين بالمشاركة، طلاباً وموظفين، هم إما في وضع نفسي سيء جداً أو في وضع مادي لا يحسدون عليه، أو أنهم واقفون في المكان ذاته منذ سنين، يحاولون «عصر» إنجاز ما، حتى أن أحدهم كان يسأل منذ فترة ليست بعيدة عن خيارات العودة الطوعية إلى سوريا، لكنهم راغبون فعلاً بتصدير أنفسهم كقصص ناجح.
مجدداً لا يمكن لوم هؤلاء الأفراد في ظل الضغط المجتمعي، سواء من مجتمع اللاجئين أو خارجه، فاللاجئ مطالب بالنجاح من قبل عائلته وأصدقائه والناس الذين يراهنون على نجاحه، ومن قبل الذين يراهنون على فشله أيضاً، فيحاول أحياناً صناعة قصة النجاح الخاصة به ومشاركة إنجازاته على مواقع التواصل الاجتماعي والمبالغة في الحديث عنها، وهو أحد آثار الهوس بقصص نجاح اللاجئين.
بالإضافة إلى الضغط الذي يشكله بعض السوبر لاجئين، فقد يقود هذا الموقع إلى الشعور بالغضب من بقية اللاجئين، غضب مبني على ارتباط اسمهم باسمه، واعتبارهم عبئاً على جسد اللاجئين، ما يولّد بالتالي نظرة دونية وحديثاً متعالياً. لو أنني أستطيع إحصاء عدد المرات التي سمعت بها عبارة «هؤلاء يشوّهون صورتنا»، مع كل التبعات الناتجة عن هذه الفكرة، بدءاً من التعبير اللفظي وصولاً إلى المطالبة العلنية بعدم استقبال لاجئين جدد أو حتى ترحيل من لا تلائمهم معاييره.
ولا يمكنك إخفاء دهشتك حين تقابل سوبر لاجئين في الحياة العادية. كنتُ أرغبُ في لقاء شاب قرأت كتاباً عن قصة حياته، وقابلت الكاتب وحدثني عنه، وقد أمّنوا له قبولاً في جامعة عريقة والجميع كانوا يتحدثون عن نجاحه، ولكن حين قابلته اكتشفتُ أنه يرسب منذ عامين، وهو أمر عادي يحدث حتى مع الفرنسيين في السنوات الجامعية الأولى، لكنه قرَّرَ ترك الدراسة وانضمَّ إلى برنامج للاجئين حيث يُعامَلُ كنجم، وتستمر قصته بتقديم الرضا الكافي عن الذات بالنسبة له.
الإنسان «العادي» أصبح يشعر بالدونية والكسل، ولم يعد ينظر بعين الرضى إلى حياته حتى عندما تكون مستقرة ومريحة، فالصورة اللامعة للسوبر لاجئ تجعله «يستخسر» نفسه في المكان الذي هو فيه، والأسوأ من كل هذه النتائج هو التشويه الحاصل في عمل الجمعيات، تشويه جديد يضاف لسجل تشوهات الـ NGOs.
أختار هنا التحدث عن تجربة شخصية، عن مرة كنتُ فيها متطوعة على جهة الجمعية، ومرة أخرى كنتُ فيها مستفيدة على الطرف الآخر من الطاولة. شاركتُ كمتطوعة في مقابلات اختيار مشاركين في برنامج يهدف إلى إيجاد فرصة عمل أو دراسة للمشارك دون أن يَعِدَ بها بالطبع، وكان سير المقابلات مضحكاً بالنسبة لي، نستجوب لاجئاً حول أحقيته بالحصول على مقعد من المقاعد المحدودة ونفاضل بين المشتركين، عملية منطقية حين تكون مسؤول توظيف في شركة ما، لكن الأمر هنا مختلف، في نقطة معينة من المقابلات كانت المسؤولة منبهرة بأحد المرشحين، يتحدث الفرنسية بطلاقة، لديه درجتا ماجستير من فرنسا، عمل في عدة ستاجات بمجال دراسته؛ كلُّ هذا جيداً دون خلاف، لكن ما الذي يدفعنا لقبوله في برنامج يركّز في 70% منه على اللغة؟ وما الذي يدفعنا لرفض شاب كان يعمل راعياً للأغنام أو فتاة تنطبق عليها كل المعايير لكنها طالبة لجوء لم تحصل على قرار اللجوء بعد؟ أو فتاة لم أكن لأعرف عنها شيئاً لولا تحدثي العربية وإصراري على سؤالها عن عملها السابق بعد تكرارها لعدم امتلاك أية مهارات، واكتشافي أن خجلها وحالتها النفسية منعاها من ذكر خبرات مهنية وصفات شخصية أدت إلى قبولها في البرنامج؟
الأرقام، كانت هذه الإجابة التي انتزعتُها من المسؤولة، علينا المحافظة على نسبة معينة من النجاح، وعلى أساسه كان يتم اختيار المرشح الآمن، الذي يضمن دخوله نسب النجاح وإمكانية تحويله إلى وجه للجمعية، وعلى أساسه يتم تصميم استبيانات رضا وتقييم لاحق للمشاركين، فضفاضة وتحوي ما يمكن إدراجه ضمن نسب النجاح، وعلى أساسه يتم حرمان فرد من المساعدة التي تم تمويل الجمعية أصلاً لأجلها.
وبالنتيجة نجد أنفسنا هنا أمام المعاكس، السلبي أيضاً، للقرد الناطق، حيث يتم تجاهل كل المشكلات التي يعاني منها اللاجئ، الإدارية والنفسية والسكنية واللغوية والهوياتية وأضف ما تريد مما ينتهي بـ«ية»، ويطالب بأن يكون فعالاً ومنتجاً وملتزماً، ولا مانع إذا كان وسيماً أيضاً، لتتوفر له فرصة الحصول على حقوقه كلاجئ.
وفي السعي للوصول إلى مصاف السوبر لاجئ، والحصول على فرص التعليم والعمل، يجد اللاجئ نفسه مجبراً على الانتقال إلى العاصمة أو المدن الكبيرة، وإنفاق معظم دخله على السكن، ومعظم وقته في المواصلات، الأمر الذي وجدتُ نفسي مجبرة على فعله.
أما عن تجربتي كمستفيدة فقد كان الأمر مشابهاً، تمّ استجوابي والانبهار بكل ما أقوله؛ لاجئةٌ غير محجبة تتحدث الفرنسية دون «لهجة» ولديها شهادة جامعية، أمرٌ يدعو للإعجاب. وعند قبولي في الجامعة لدراسة الماجستير تمت دعوتي كقصة نجاح إلى عدة مناسبات نظّمتها الجمعية، وكنتُ ممتنة بالفعل لعملهم قبل أن أنضم إلى فريقهم. عند استلامي لعملي في قسم التقييم وقياس الأثر، تساءلتُ عن سبب اعتبار قبولي في الجامعة، التي كنت أعرف بوجودها سابقاً وتقدمت إليها قبل قبولي في البرنامج، كقصة نجاح للجمعية؛ كان الردُّ أنه لولا الثقة بالنفس التي منحني إياها البرنامج لما تمّ قبولي، ردٌّ دبلوماسي جاء بعد تفكير، علماً أن القبول في برنامج الماجستير كان يعتمد بشكل رئيسي على الأوراق والمستندات وليس على الثقة بالنفس. عند تكليفي بمهمة إعداد قصص النجاح لأن هذا «بالتأكيد سيسعدني»، اعتذرتُ عن العمل معهم أو حضور مناسباتهم كقصة نجاح.
أن تكون لاجئاً ليس أمراً سهلاً، تجد نفسك فجأة ساعياً للحصول على الشرعية والقبول من مكان لا تقبله بالضرورة، وثنائية حقوق-واجبات التي ترافق المواطنة تصبح أكثر تعقيداً في حالتك، الحق يتحول إلى وصم وأمر واجب الانتزاع، والواجب يصبح عبء المستحيل. سأقولُ لكَ ما أذكّرُ نفسي به كثيراً، خُذ نفساً عميقاً، انظر حولك، وتأكد من أنك في طريقك إلى ما ترغب به بالفعل، ولا تتحول إلى ورقة لجوء على قدمين.