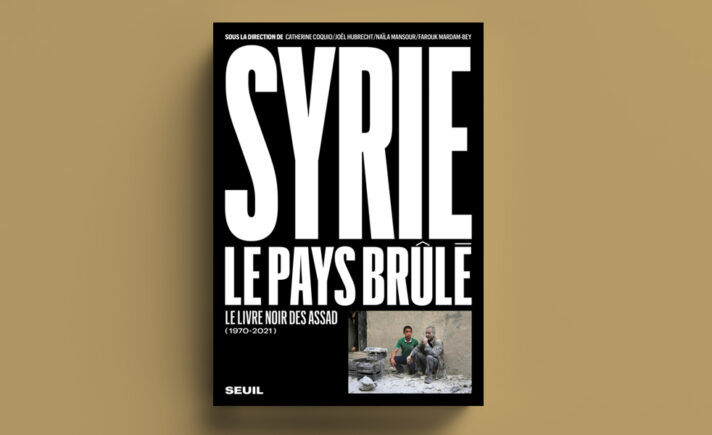كنتُ في الثالثة عندما تعودتُ ألّا أنامَ قبلَ أن يقوم جدّي باصطحابي في مشوارٍ صغير؛ كنّا نستقلّ سيارته الفولكس فاكن البيضاء الصغيرة، التي كنتُ أسميها السلحفاة، وندور شوارع حمص حتّى أغفو. كنتُ الحفيدة الأولى لجدّي، ولذا كان من السهل أن يتحوّل هذا المشوار إلى طقس يوميّ. كبرتُ وبقي هذا الطقس موجوداً.
وفي مرّةٍ عندما كنتُ في الخامسة، سألتُ جدّي عن ذلك الرجل الذي نرى تماثيله في كلّ مكان. تماثيل فولاذيّة المظهر قاتمة اللون، ملامح غير واضحة، حركات غريبة في يديه، تختلفُ كلّ مرّةٍ وعند كلّ مفترق. «هاد جدّو الكبير، جدنا كلنا» أجابني جدّي، وبدأت بعدها رحلة الفضول، كنتُ في العمر الذي أحفظ فيه الهويّة والانتماء، وأسألُ عن كلّ فرد في العائلة؛ من يكون وكيف تكون صلة القرابة معه. فمثلاً عمّي هو أخٌ لأبي، خالتي هي أخت أمّي، جدّتي هي أمّ أبي أو أمّ أمّي، الجيران هم أناسٌ نعرفهم لكنهم ليسوا من العائلة، وهكذا. أمّا هذا الرجل، فقيل لي أنّه جدّ الجميع؛ هو ليسَ قريباً لأمّي أو أبي، لكنّه هو فقط الذي يمكنهُ ألّا يكون من العائلة ويكون جدّنا جميعاً في الوقت نفسه. لم يكن ذلك منطقيّاً، لكنني قبلتهُ كواقع مثل كلّ المعطيات الأخرى.
كبرتُ قليلاً، ولم أعد أسأل كثيراً عمّن يكون هذا الرجل، أرى صوره في كلّ مكان، تماثيله في الشوارع، يتحدّث إلينا من خلال التلفاز، والجميع، الجميع دون استثناء يعرفونه.
سألتُ مرّةً لماذا لا يزورنا جدّنا هذا كما يقوم آخرون بزيارتنا، وقيل لي إنّه مشغول جدّاً وليس لديه الوقت لزيارتنا جميعاً. سألتُ مرّةً بعدها لماذا لا نحتفظ بصوره في المنزل كما نحتفظ بصور باقي أفراد العائلة، فأحضروا لي صورةً له وأضافوها إلى صور العائلة.
استمرّ الحال على هذا إلى أن كنتُ أركب في سيارة تكسي في دمشق، ورأيتُ صورةً له مع أمّرأة أكبر منهُ وهو يقبّل يدها. ولم أكن قد رأيت صورة له قطّ مع أحد، فهو دائماً مركز الصورة، مبتسماً أو عابساً، وحيداً، بعيداً، إمّا صورٌ قريبةٌ تبدو فيها ملامح الوجه فقط، أو صورٌ لكامل جسمه وهو يعتلي شيئاً ما، وكأنهُ يقسمُ السماء ويقفُ فوق في مكان ما لينظر إلينا من الأعلى. سألتُ من تكون هذه، وقيل لي إنّها أمّه، وهنا قمتُ بالتعليق بأنّها «بشعة» وكبيرة جدّاً في السنّ، وسألتُ كيفَ للجدّ الأكبر أن يكون له أمّ؛ تنهار منظومة الكبر في رأسي إن كان له أمّ.
شعرتُ بأحدهم يقرصني أن أسكت، لم أفهم، نظرتُ إلى مرافِقتي كما لو أنني أريدُ أن أسأل شيئاً. «بدنا ننزل هون بعد اذنك»، قال صوت مرتبك يجلسُ قربي. ترجّلنا من السيارة. نظرت إليَّ وبدأت تصرخ في وجهي أنني يجب ألّا أقول شيئاً كهذا أبداً، وأننا كنّا سنقع في مشكلة، وأن الله نجّانا منها. لم أفهم، لكنني أدركت أنني يجب ألّا أسأل. لقد نجونا ويجب أن نتعلّم الدرس. «كنّا رحنا كلنا فيها!!»، قالت مستنكرة!
«بس…».
«خلص لا عاد تقولي شي، امشي قدامي».
ومنذُ تلك اللحظة ارتبط اسمهُ ببعض من الخوف والتوتر.
في أوّل يوم من أيّام المدرسة الإبتدائيّة، الصفّ الأوّل، تروي لنا الآنسة نهلة ما سنقومُ بتعلّمه هذا العام، وتذكر شيئاً لم أسمع عنهُ قطّ: القوميّة.
هنا بدأت رحلة جديدة من مراحل التعرّف إلى هذا الكائن، جدّنا الكبير.
في الصفّ الأوّل تعلّمت بأنّ أقوال جدّنا الكبير لا تُحرَّف أبداً، تُحفظ فقط، لا تُناقش، ليس من المسموح الخطأ فيا أبداً، وخطأٌ كهذا قد يعني شيئاً أسودً جدّاً، قاتماً وأكبر من كلّ المخاوف الأخرى.
ولذا، وضعتُ مقاربة سهلة، الله في السماء، ولا يمكن أن نُخطئ أو نُحرّف أو نناقش آياته، وجدّنا الكبير على الأرض؛ كلاهما يعرف كلّ شيء عنّا ونحنُ لا نعرف شيئاً عنهما، كلاهما أقوياء جدّاً ويتحكمون بالمصير. الفارق الوحيد بينهما هو أننا نرى أحدهما ولا نرى الآخر. واحدٌ اسمه الله، والآخر اسمه الرئيس. وكطفلةٍ في السابعة كان هذا أهمّ أكتشاف، لأنّه من هذه النقطة بات كلّ شيء أسهل.
سألتُ مرّةً إن كان جدنا الأكبر نبيّاً، بعد أن تعرّفتُ إلى الأنبياء وقصصهم في المدرسة، وقيل لي أنّهُ ليسَ نبيّاً دينيّاً لكنّه نبيٌّ وطنيّ. فاستسهلتُ محاولة الفهم وإعتبرتهُ آدم، آدم السوريين. فكما كان للبشريّة آدمُها، الذي منهُ خلقت كلّ البشريّة، فحافظ الأسد آدمنا كسوريين، وكلّنا أبناء لهُ أو أبناء أبناء، ورفضُ ذلك في أيّ تفصيل منه، صغيراً كان أم كبيراً، سيودي بنا إلى الرعب الأسوَد.
لم أتخيّل يوماً ما هو هذا الرعب الأسود، في كلّ الأشياء الأخرى التي يمكن أن نُعاقَبَ عليها عقوبات مرعبة، تبدو العواقب معروفة. فمثلاً، إذا قمتُ بالمشاغبة في الصفّ، فسوف أُعاقَب بأن أخرج من الصفّ، أن أُضرب، أن أُوبَّخ، وبناءً عليه أستطيعُ تقدير إن كنتُ أريدُ القيام بهذا الفعل أم لا. إن لم أقم بتنظيف غرفتي سوف أُحرم من المصروف، وإلخ. العواقب واضحة وما نخشى الوقوع فيه واضح، أمّا الخوف من شيء أسود غير معروف، يبدو من الحديث عنهُ أنّه أسوأ من أكبر عقاب أعرفه، فكانَ شيئاً لا أعرف إن كنتُ أستطيع وصفهُ قطّ لشخصٍ لم يعش التجربة.
فحتّى العقاب الديني في أسوأ حالته يبدو أوضح، إن لم تقم بالإلتزام فسوف تتعذّب في النار إلى الأبد. أمّا هذا الرجل، فالخوف الذي زرعهُ هو الخوف من أيّ شيء، نخافُ دونَ أن نكون قد ارتكبنا أيّ شيء، لا العقوبة واضحة ولا الفعل الذي سيؤدي إلى تلك العقوبة واضح، لذا يجب أن نتجنّب أيّ شيء يخصّه، نسمع ونطيع ونحبّ، نَدفِقُ هذا الحبّ، ونلتزم ونحترم ولا نفكر.
عشوائيّة الخوف هذه كانت ثقيلة جدّاً.
كنتُ أفكّر بيني وبين نفسي أحياناً بأنّهُ غريب الأطوار، تراهُ مرّةً فاتح الذراعين ومرّة ممسك الكفين ومرّةً رافع اليدين. تماثيلهُ تلك لم تكن جميلة، كما أنّه لا يحبنا فعلاً، فهو دائماً بعيد، صوره عالية، تماثيلهُ عالية وبعيدة ومسوّرة أحياناً. لكنني كنتُ أقنع نفسي دائماً بأنني يجب أن أكفّ عن التفكير في الأمر، فهو يمكنه أن يعرف ما يدور في رأسي. كنتُ أحاول أن أمنع هذه الأفكار من أن تأتي إلى رأسي بأن أغنّي بصوتٍ عالٍ، أو أن أرقص.
فماذا لو سمعني؟
قلّةُ ما نعرفه من تفاصيل عن هذا الخوف الذي نعيشه، دفعتني، كما الجميع، إلى تلبيسه قدرات خارقة، فهو يعرفُ كلّ شيء، تماماً كالله، وبالتالي فإنه يمتلك القدرة على زيارتنا وزيارة قلوبنا ومعرفة كلّ شيء يدور فيها.
في المدرسة، كان التعامل معهُ أسهل، فقط أفعلُ ما يفعله الجميع، نقومُ بإلقاء التحيّة عليه عدّة مرّاتٍ في اليوم، صوره تملأ المكان، له صورة كبيرة في كلّ صفّ وغرفة وممرّ، وواحدة كبيرة جدّاً في غرفة الإدارة. نرفع صوره مع أعلام أخرى في مناسباتٍ معينة، نحفظُ أقواله في دروس القوميّة، نرددها طيلة أيّام السنة وفي المناسبات، ننادي اسمه بطريقة معيّنة، ونهتف لهُ دائماً بالأشياء الجيدة.
وبدا كلّ شيء طبيعيّاً، توقفتُ عن طرح الأسئلة، ومضت الأيّام.
ثمّ أتت مرحلة «تجديد البيعة» لتُعيدَ كثيراً من الأسئلة إلى الطاولة. «نعم»، الكلمة التي كانت تملأ كلّ مكان. لم أفهم، ما هو «تجديد البيعة»، فإذا كان هو جدّنا جميعاً، لماذا نحتاج إلى أن نقول نعم أو لا؟ أليسَ هو أمراً مُعطىً مثلهُ كمثل الهواء والماء والأشجار وباقي أفراد العائلة؟
ماذا سيحصل لو قلنا لا؟ سألتُ مرّة وانهار الكوكب بعدها. قيل لي إنّه من غير الممكن أن يقول أحد لا، وإن هذا ليس خياراً، وعليًّ ألّا أقومَ بطرح مثل هذه الأسئلة.
طيّب، إذا كان من المستحيل أن يقول أحدٌ لا، فلماذا نحتاج أن نقول «نعم» التي لا خيار غيرها؟ سألتُ نفسي ولم أجرؤ أن أشارك هذا السؤال علناً.
كنتُ دائماً أمتلك كثيراً من الأسئلة التي أخشى التفكير فيها أو طرحها، وبعناية تامّة رحتُ أقومُ باختيار ما أسمح لهُ بأن يصبحَ سؤالاً حتّى بيني وبينَ نفسي. أفكّر بالتهمة التي ستوجَّه لي إن سمعَ الجدّ الأكبر بسؤالي، فمثلاً: كيف تجرؤين على التفكير بالـ لا كخيار لتجديد البيعة؟
أفكّر بالجواب أن يكون شيئاً مثل: أريدُ أن ألغي هذا الشيء الذي يسمّى بتجديد البيعة، لتكون رئيسنا دائماً.
وعندما أجدُ عذراً أقتنعُ أنّه مناسبٌ وربما لا يوقعني في ورطة، أسمح للسؤال بأن يدخل منطقة الوعي في رأسي، ومنهُ باتجاه أن يُطرَح على الآخرين في أحيان نادرة.
أعتقد أنّ مشكلتي الرئيسيّة مع هذا الرجل كانت الغياب المطلق للمنطق، بل والمعاقبة على التفكير المنطقيّ. فلقد أراد أن يكون خارج المنطق وخارج الخيال، أقوى من الإثنين معاً. فمثلاً كانت الإجابة الصحيحة عمّا إذا كنتُ أحبّ جدّي أكثر أم الجدّ الكبير، هي اختيار الجدّ الكبير. وكنتُ أجرّبُ أحياناً بيني وبينَ نفسي أن أجلس وحيدةً وأسأل قلبي إن كان يحبّ جدّي أكثر أم الجدّ الكبير، وكان دائماً ما يجيب بأنني أحبّ جدّي أكثر. فكيفَ لي أن أحبّه أكثر من جدّي وهو لا يعرفني؟ لم أرهُ في الواقع قطّ؟ كيفَ لي أن أحبّه أكثر وهو دائماً بعيد ويرمز للخوف؟ لكنّ لا المنطق ولا الحقيقة تتطابقان مع الإجابة الصحيحة للنجاة، فأحاول أن أقنع نفسي بأنّ الجميع يحبّه أكثر من جدودهم، الأمر ليس مستحيلاً إذن، ولذا فأنا أيضاً يجب أن أحبّه أكثر، وأحاولُ أن أغمض عينيّ وأركّز بقوّة كي أحبّه أكثر، ليتطابق الواقع مع الإجابة الصحيحة.
قبل تلك المرحلة كنتُ لا أمتلك كثيراً من المشاعر حوله، كان شيئاً من الأشياء المعطاة في هذا الكوكب، وكنتُ أتعايش معه، أمّا بعد تجديد البيعة، بدأ شيءٌ من الكره يلوح في الأفق. توقفتُ عن البحث في منطقيّة الأشياء حوله، وبدأتُ أشعر أنّ هناك شيئاً مفروضاً من قبل هذا الشخص.
تعرّفتُ بعدها في المدرسة على نُظُم الحكم حول العالم، وتعلّمنا حينها بأنّ هناك الجمهوريّة والملكيّة، والدولُ الجمهوريّة تقوم بإجراء انتخابات لاختيار الحاكم، أمّا الملكيّة فهي تورّث.
همممم، وما هي سوريا؟ سألتُ المدرّسة.
جمهوريّة، قالت. ثمّ استطردت: لكنّ كمّ المحبّة التي نكنّها للرئيس، يجعلنا نريدهُ أن يكون رئيساً دائماً هو وعائلته.
لماذا لا نقوم بالتحوّل إلى مملكة إذن؟ سألت.
الأمر معقّد، ولا تكفي رغبة الشعب بتحويلها إلى ملكيّة كي نتمكّن من ذلك، ولكن إن شاء الله نصير مملكة الأسد. ثمّ تضحك.
هنا تخيّلتُ ولأوّل مرّة كيف سيبدو شكل الحياة إن كان الرئيس شخصاً آخر، وبدا الخيال ثقيلاً، لم أستطع أن أتخيّل الحياة مع وجود رئيس آخر، فأنا لا أعرفُ شكلاً لها من دون وجوده.
للأبد، واحدٌ من الشعارات التي دفعتني لمقارنته مع الله في سنين المدرسة الأولى، فكلاهما لا يموت. هذا كان واحداً من الأشياء المشتركة بينهما، إلّا أنّ الله مرتبط بيوم القيامة، وحافظ الأسد مرتبط بالأبد، الشيء الذي يأتي بعدَ يوم القيامة، نُحرَقُ أو نعيش بسعادة في الآخرى، وإلى الأبد.
وجاء الأبد!!
مات حافظ الأسد، وشعرتُ بأنّ اللحظه قد أتت وأنّه يوم القيامة، وبأننا الآن سنموت جميعاً كتجمعات بشريّة. حتّى الآن لا أستطيع أن أصف شكل ذلك الشعور، كيفَ يموت حافظ الأسد؟ ماذا سيحصل الآن؟ أنا صغيرة لا أريد أن أموت، كنتُ أفكّر في نفسي وأخافُ وأحزن.
بدأتُ أتخيّل السيناريوهات المحتملة لموتنا، وكان السيناريو الذي يشبهُ الوضع هو أن نقع جميعاً أرضاً ونموت، وفقط. أذكرُ أنّ شقّاً من عائلتي تجمّع في المنزل، وأُغلقت كلّ النوافذ والأبواب وكلّ مصادر الضوء والحياة، تعطّلت كامل الحياة، لم يقم أحد بالاستعداد لهذا الشيء أو تموين الطعام، فخبر وفاته أُذيعَ فجأةً، وكان من المعيب أن يشتكي أحدنا من الجوع. لم يسألني أحد يومها إن كنتُ قد قمتُ بتنظيف أسناني ولبس بجامتي قبل النوم، وهو الأمر الذي لم يحصل يوماً من قبل. كان الحدث أكبر من أيّ شيء آخر؛ كلّ التفاصيل الخاصة انهارت يومها، وبتنا عبارة عن فئران في منازلها، التي مهما كانت مساحتها راحت تضيق وتصغر وتصبح أصغر من قدرتنا على الهرب أو المواجهة. الموت يعمّ المدينة، الشوارع هادئة وفارغة تماماً، النوافذ جميعها مغلقة، شمسُ الصيف وحرارته تزيد من توتر اللحظات، حتّى الذباب اختفى يومها وتحوّلت سوريا بأكملها إلى قبور صغيرة دفنّا أنفسنا فيها، وباقي ما تبقّى هو صحراء لا يجرؤ شيء على الحركة فيها.
كنتُ خائفة وفي رأسي ألف سؤال وسؤال عن الذي سيحصل الآن، ولكنّ انطباعاً عاماً أخبرني بأنّ هذا الوقت ليس للأسئلة، وأنّ الصمت هو ما أريد أن أتحلّى به.
كنتُ في دمشق يوم إعلان وفاتهِ، وكانَ يجبُ أن نرجع إلى بيتنا في حمص قبل وقوع الكارثة. في اليوم التالي لوفاته رأيتُ الشمس مجدداً؛ «عيونكم بالأرض، ما بتشيلوها لو شو ما صار، ما بتحكو ولا كلمة إلّا إذا في شي كتير ضروري، مين ما وقفنا وشو ما سألوكم انتو ما بتعرفوا شي وبتخلوني أنا أحكي»، هكذا كانت التعليمات من قبل مرافقنا قبلَ مغادرة المنزل. «قلتلك البسي كنزة سودا، ليش في هالنقطتين الحمر، هلأ تعمليلنا مشاكل؟ يلّا خير اتكلنا على الله، حطّي إيدك هيك غطّي هالنقطتين الحمر بلا مشاكل!»، أنظرُ إلى الأرض ببعض التأفّف، وأنا أثبّتُ يديَّ على مكان النقطتين الحمر كمن يشتكي ألماً في الخاصرة.
يُفتح الباب، ونخرج.
نظري في الأرض، ولكنني أتلصّصُ النظر إلى المحيط بينَ الحين والآخر. لا شيء، لا أحد، عدد قليل جدّاً من السيارات. كانت تنتابني رغبة شديدة بالضحك لا أعرف من أينَ مصدرها، لربما كنتُ خائفة حدّ الرغبة بمواجهة ذلك المجهول، أو هو خيالي عندما أتخيّل كيفَ يبدو مظهرنا لمن يراقب من بعيد؟ كيفَ أمشي وأنا أضع يدي على خاصرتي لأغطّي نقطتين حمراوتين على كنزة سوداء لأنني يجب أن أكون حزينة جدّاً على موت شخص لا أعرف عنهُ سوى الخوف منه، وكان يجبُ أن أعرفَ قبلاً أنّه سيموت اليوم، وأن أشتري كنزة سوداء قاتمة. أمشي وأنا أنظرُ إلى الأرض، وكأنني أريدُ أن لا يعرف أحد بأنني موجودة، وكأنني يجب أن لا أكون هنا أصلاً، لا أرى أحداً ولا يراني أحد، أمرُّ كشبحٍ في المدينة.
في حمص كان الوضع أفضل بقليل، فلم أضطرّ أن أنظر إلى الأرض أو أن أغطّي النقطتين الحمراوتين على كنزتي المشؤومة هذه.
لحسن حظّي، كان أباجور غرفة نومي معطّلاً، وكان باستطاعتي أن أتلصّصَ عن شكل الشوارع، وعلى مدى أيّام كانت نفسها تماماً، تقريباً خالية، لا شيء ولا حركة.
وها قد مرّت عدّة أيّام ولم نَمُت، وبدأتُ أشعرُ بالملل من انتظار الموت، من الخوف من الموت، من محاولة تخيّل السيناريوهات، ومن محاولة كبت نفسي عن أن أسأل. وقررتُ أن أعود لممارسة حياتي بشكلٍ عاديّ.
ظهرَ بعدها بشار الأسد، وأصبح رئيساً. سار كلّ شيء واستمرّت الحياة؛ لم نَمُت.
كنتُ سعيدة جدّاً بأننا لم نَمُت، وبأننا انتصرنا على شيء غائم كاد يقتلنا. كما وكنتُ سعيدة بأنّ الرئيس الجديد هو شاب في مقتبل العمر، يمكنُ أن نراهُ يضحك ويلعب، وليس فقط صورة جامدة وبعيدها وليس فيها أيّ روح.
بالرغم من أننا نجونا، وعلى الرغم من تغيّر كلّ شيء منذُ ذلك الحين إلى اليوم، لم أستطع حتّى هذه اللحظة أن أفسّر المشاعر التي كانت حاضرة إبان موت حافظ الأسد. كلّما استعدتُ الذاكرة حول اللحظة التي أعلن التلفزيون السوريّ فيها وفاته أجد نفسي مندهشةً لا أصدّق، فالمشاعر التي أصابتني وأصابت البلد يومها هي مشاعر لا تصيبُ الناس العاديين الذينَ تربوا كي يصدقوا بأنّ حافظ الأسد هو الله على الأرض.
أمّا يومَ ركلَ أحد المتظاهرين صورة حافظ الأسد أعلى مبنى نادي الضبّاط في حمص، فقد اكتمل المشهد. كان الشاب يركل ويركل ويركل ويركل بقوّة وعزم، كأنّه يعلن موت ما لم يمت يومَ مات حافظ، الخوف. في المرّة الأولى عندما أعلن التلفزيون العربيّ السوريّ وفاته، جاء إعلان الخبر همساً في آذان الشعب، وأدى إلى دفننا في منازلنا رُعباً. أمّا يومَ أعلن ذلك الرجل الخبر من أعلى مدخل بوابة نادي ضبّاط حمص، متمسكاً بكلتا يديه بالسماء، مرتبكاً بثقلِ ما ينبتُ في داخلهِ من رغبة بالتغيير، فقد جاء الإعلان صارخاً عالي الصوت، بينما كان آلاف السوريين يتدفقون إلى الشوارع تسبق حناجرهم وهتافاتهم الريح. لقد هشَّمَ ذلك الرجل الصورة التي رافقتني مدى الحياة، الصورة نفسها التي كانت تراقبنا دائماً وفي كلّ مكان؛ الصورة التي كانت ترفعُ فوق رؤوسنا ونحنُ نُربّى على أن نكون جنوداً ينفذون ولا يعترضون، الصورة نفسها التي كانت تأتي إلى رأسي عندما أفكّر بأن أطرح أيّ سؤال عن قدراتها فأغنّي بصوتٍ عالٍ كي لا تسمعني؛ الصورة نفسها التي كنتُ أمسكها وأغمض عينيَّ لأقنع نفسي بأنني أحبّها أكثر من جدّي.