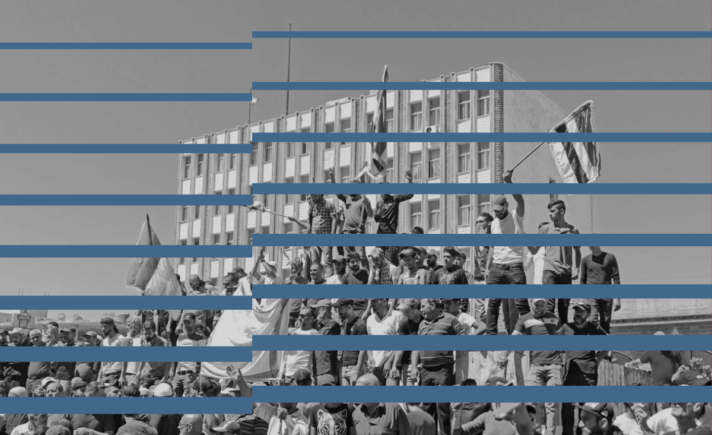عَقب بحثٍ مُضنٍ؛ أشبه بالتنقيب عن شيءٍ ثمين، اهتديت إلى طبيبِ أسنانٍ يتقاضى أجرةً مَعقولة. تبدو كلمةُ «معقولة» محطّ شكٍّ، فلا شيء «معقولاً» في بيروت، وربما تُخفي هذه الكلمةُ وراءها مُصيبةً ما. منطقُ الشك هذا مبالغٌ فيه، لكن في كل مرةٍ ستدخل فيها إلى لبنان، سيهبكَ الإحساسَ بالخفة والطمأنينة المعقولة. حينها تكون قد وقعت في فخٍّ، سيصفه مارون بغدادي في فيلمه خارج الحياة على لسان السجّان لسجينه: «هذه لبنان، لا تثق بما تشاهده عيناك!».
منذُ سنتين والتسوس يَفتكُ بأسناني. بلغ الألمُ أن نَفخ في وجهي كُرةً جعلت من مظهري محطّاً للسخرية. لا بدّ أن كثيراً منكم تعرض لمثل هذا الموقف، وتساءل: لماذا تُثير أشكالنا التعيسة السخرية! تقبّلتُ تلك السخرية برحابةِ صدرٍ غير معهودة، وتوسلّتُ للساخرين أن يدلوني على طبيبٍ (رخيص).
ألمُ الأسنان ألمٌ تراجيدي؛ ملحميُّ الانقباضاتِ والأسئلة. ألمُ الأسنان هو ألمُ جلجامش وهاملت والدونكيشوت وفاوست، وكلّ الأبطال التراجيديين حين يَعصفُ الألم بروحهم مثلما يَعصفُ السوس بالعصب أَسفلَ السنّ المنخور، فيعصر العقل كإسفنجة. وكما المقاتلين المهزومين تحت سماءٍ مُمطرةً هرباً من العدو، حُسمت المعركةُ في فكي وانتصر التسوس. خارَ جسدي لشراسة ضربات السوس المتواصلة في الأضراس والأنياب. «اثبت»… قُلت لنفسي تحت المطر المنهمر أمامَ عيادة الطبيب، مُستذكراً مرارةَ غَرْزِ الإبرَ في اللثةِ وهي تَهتكُ رهافتها فَينتشر الخدرَ في عظم الرأس، وتُصبح كالمشلول فاقداً القدرة على الكلام.
استقبلتني كوليت بملامح وجهها التعيسة. رمقتني بنظرةٍ فاحصة، ودوّنت بعض الملاحظات، ثم أدخلتني إلى الطبيب. ومثل مُمثلٍ مَسرحيٍّ بشعرٍ أشيب وابتسامةٍ مَغرورة، قال (مازحاً) وهو يُطلُّ في فكّي كأنه يؤدي دورَ مُغامرٍ مجنون: «لديك مصيبة، ولكن لا تقلق». كوليت التي قالَ عنها الطبيب «وَقعت في غرامي» ارتبكتْ لإيحاءاتِه وغَمزاته، فأصابني الخجل أمام حيائها، ولم أنتبه أنَّ ذلك كان إيذاناً ببدء مونولوجٍ طويلٍ ومتُكرّرٍ من نُكات سمجة وارتباكاتٍ مُفتعلةٍ كان خِتامُها أن اقتطعت كوليت قلبي ثمناً للعلاج. قام السفاح بعلاج سنّين مُقطّعاً أوصال أعصابي، أما الثالث فَبقي مفتوحاً تصفر فيه الرياح دون حشوة، فقررت ألا أعود لتصلبني كوليت وتُمطرني بتقريعٍ تلاشى فيه خفرها، عندما سألتُها عن السبب في ارتفاع الأجر إلى هذه الدرجة.
استحكمَ أَلمُ الأسنان رأسي شهوراً طويلة. تجاوزت سنَّ الثالثة والثلاثين واكتمل ضرسُ العقل لدي. نما (أزورَ) متسوساً دافعاً كلَّ الأسنان أسفل حَنكي إلى التراصف. قُلت في سري: هذا أَكملُ وصفٍ لمنطقي في الحياة، فَسنُّ العقل لديّ مثل دماغي؛ إذ كانت تقول عني جدتي: «هذا الولد عقله أزور». تسلّل التسوّسُ إلى دماغي، قضمه رويداً رويداً، وأفسد ما جهدت في الحفاظ عليه طيلة الثلاثين عام. نخر الأفكار والعواطف والخيالات. أتلف أثمنها وأحاله إلى هلوسات. وربما أثناء هذيان وجع الأسنان والتأمل من شرفة الطابق الخامس في حي الجعيتاوي الفقير، خطرَ على بالي إنجازُ فيلمٍ قصيرٍ عن احتجازي في لبنان، وأثناء البحث في تاريخ المدينة تعرفت إلى مارون بغداي، وستتقاطع قصته في رأسي مع قصة انتحار خليل حاوي. مخرجٌ وشاعرٌ قتلتهما الحرب يخرجان لشابٍّ يعيش زمناً آخر للحرب. سحرتني أفلام الرجل، وعلّقتُ له صورةً بالأبيض والأسود على حائط منزلي.
ينهض مارون في الليل، ويُحدقُ في وجهي. أُغمض عينيّ أكثر، وأتلو تعاويذَ لطردِ الروح الحزينة: ماذا تُريد أيّها الطيف؟ أَنهضُ من السرير بتثاقل، نَسير معاً في ظُلمةِ البيت. يَجلسُ على الأريكة، فأجلسُ بجانبه وأشعرُ بدوارٍ شديد، فاللثة تتشقق وتنزُّ دماً؛ ماذا لو أنجزَ فيلمه الأخير! هل كانت الحرب ستنتهي؟ يَحومُ على نفسهِ كما لو أنّ نهاية الحرب سينجِزها مُخرجٌ مات قبل أوانه. ماذا تَستطيعُ الصورة اللعينة أن تُخبر يا مارون؟ ماذا تعني كلّ هذه الاستعادات المتكررة للحكاية منذ عهد آدم وحتى هذه اللحظة؟ أليس مرعباً ذلك المصير السوداوي: أن يتماهى المؤلف مع هواجسه فتقتله؟ هل قتلتك الظلمة والوحدة؛ ذراع الحرب الخفية؟
سيرافق مارون وخليل هذياني المستمر طيلة ثلاث سنوات أمضيها عالقاً، ولا أَعرف إذا ما كان ألمُ الأسنان سبباً للخيالات الكثيرة التي كانت تظهر لي في المنزل؛ فرائحةُ الرطوبة والموت تنبعث من زواياه، والسيدة (ن) تَقتحِمُ كوابيسي غاضبةً، تَنهرُ رُوحي وتأمرني بالرحيل من منزلها. احترقت السيدة (ن) مع ولدها إثر سقوط قذيفةٍ أنهتْ كل شيء. لدى السيدة (ن) مشاعر مضطربة تجاه إقامتي في منزلها: تارةً توقظني من نومي بأشنع الكوابيس، وتارةً تُرحّب بوجودي فتتنزّلُ عليّ السكنية وأشعرُ أن هذا البيت هو بُقعة الأمان الوحيدة في بيروت. أشعر بها تطوفُ المنزل غاضبةً بملامح وجهها المحترقة؛ تعول من الألم والبكاء. يحوم قطي الأليف ميرو على نفسه راكضاً مُحطِّماً الصحون والكؤوس، ثم تمسكُ (ن) يدي وتجرّني لأجلس معها على الأريكة، فينهض مارون من الصورة مُنهدّاً على نفسه فاقداً البصيرة مثل أوديب. أجلس مع السيدة (ن) وميرو ومارون نتفرجُ على انحدار القمر نحو الشمال؛ حيث تسقط القذائف والبراميل، كأننا أمام حفلة ألعاب نارية.
يوماً إثر يوم يكبر الألم. يستحيل كائناً أسطورياً يُطاردني في الأحلام وزوايا البيت ووجوه المارة في الطرقات. حينها رددت عبارة ميلان كونديرا: «اليومَ أعلنتُ نفسي حماراً تامّاً». وستوحي لي هذه العبارة بشخصيتي في الفيلم، والتي ستكون إنساناً برأس حِمار. أَردتُ السخرية من ذاتي، ومن فكرة البطولة؛ البطلُ في (الواقع)_ البطل في (الفيلم)، ثم كيف يتحول البطل إلى وحشٍ بائس. لماذا نَسعى لإيجادِ أبطالٍ في الواقع وفي الحياة؟ الوحش الذي يُطاردني هو ذاته مَنْ قتلَ مارون؛ وحش الحربِ ذو الأذرع الخفية التي تتسلّل في كلِّ مكان.
صنعِ مارون أفلامه عن الحرب، وستقتله الحرب بطريقةٍ أو بأخرى. الرجل الجميل ذو النظرة الحزينة الساهمة سيكون بَطل إحدى أكثر القصص الدرامية التي تُلخص لبنان. سينطلق مارون إلى العالمية بفيلمه حروب صغيرة، وسينال فيلمه خارج الحياة جائزة التحكيم في مهرجان كان، وسيُنجز عدة أفلام مهمة ستفتح له أبواب هوليود. ماتَ مارون بطريقةٍ غامضة؛ قتله انقطاع الكهرباء أو تَصفيةُ حساباتٍ سابقة في حروب لم تنتهِ بعد. «الحروب الصغيرة» ستستمر في لبنان حتى وقتنا هذا: حروبٌ سيكون ضحيتها الكثير من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين على حدٍ سواء.
هل فقدت صوتي؟ لم أعد أميز إذا ما اختلط الحلم بالحقيقة. يتغلّلُ الصمت في روحي كما لو أنّ آلاف الشياطين يَحنِكُونني، وعبثاً أحرك الشفاه جاهداً بالكلام: هل فقدتُ اللغة وأنا أتحدث مع شياطيني؟ أخوض معهم نقاشاتٍ طويلة عن قتلةٍ متخفّين يَعبرون من زمنٍ إلى آخر. أنا وميرو عبرنا أيضاً من زمنٍ آخر كنا فيه فرساناً جوالين؛ مسّتنا اللعنةُ بعد أن أعتقْنا روحيْنا من كلّ سُلطة؛ كِتابُ اللعنات مسخهُ إلى قطٍّ ومسخني إلى كاتبٍ بخيالٍ رخيص، لكنّي بتُ ميالاً للشك بأنّ ميرو قاتلٌ متخفٍ بهيئة قط، يتحين الفرصة لغرز مخلبه في قلبي. منذُ زمنٍ بعيد أشعرُ أنّ ثمة شيئاً ما خفيّاً يطاردني، أحدق بمارون الذي قتله شيءٌ ما أيضاً. كُنت ألمحه منذ ثماني سنواتٍ يتخذُ هيئة صحفيين، وأحياناً هيئة مهندسين وشعراء وكتاب وباحثين. الشيء وضع الكلاشنكوف في رأسي على الطريق المظلمة نحو حي السكري عندما افتضحتْ هويتَه لغتهُ الفصيحة. هل أنجتني اللغة والآيات التي تلوتها بصوتٍ مرتفع ونحن على الموتور في حلكة الليل! قلت: ربِّ اشرَح لي صَدري، ويسّر لي أمري، واحللُ عقدةً من لساني يَفقهوا قولي؛ ثُمّ قُلتُ: مَا كَان لمؤمنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمناً خَطَأَ. ثم اختفى الشيء؛ تلاشى كما تتلاشى وجوه القتلة في وجوهٍ مألوفةٍ باسمة. يَقتلُ الشيء، الذي أسقطَ مارون في منورِ بنايته، الآلافَ بأطنان من البراميل والصواريخ.
تسلّل ميرو أَسفل معدتي، تحول إلى قطٍّ صغيرٍ كلّما هَممتُ الكلام قضمَ الكلمات، وها أنا أسيرُ في المدينة دون قدرةٍ على الكلام. تبلعُ المعتقلاتِ، والحربَ، و«الشيءَ» (اللغةُ)؛ تُحيلُهم أسئلةً صامتة. السؤال يفتح باباً آخر للسؤال؛
لماذا؟
وفيما أدورُ على نفسي في أحياءِ الأشرفية هائماً مثل شبح،
أستعيدُ العبارات الأخيرة لخليل حاوي:
فَاتني الإفصاحُ،
أدركتُ محاله.
أمام تَقدمِ الدبابات الإسرائيلية وضع حاوي بارودةَ صيدٍ أسفل ذقنه وأردى نفسه، ليسقط من على شرفة منزله أمام الجامعة الأميركية.
طارد الشيءُ حاوي، احتنك لغته، ضرّجه بدمائه.
حلم حاوي بالثورة، فكتب:
يَعبرون الجسر خفافاً،
أضلعي امتدت لهم جسراً وطيدْ.
من كهوفِ الشرق، من مستنقع الشرق،
إلى الشرق الحديد.
نبوءتهُ ستتطلب ما يقارب الثلاثين سنة لتندلع الثورة؛
لكنه سيقول في موضع آخر كأنه يصف سقوط البراميل والقذائف والحسرة التي تنبعث من هول المجازر:
وإذا صوتٌ يقول؛
عبثاً تُلقي ستاراً أرجوانياً على الرؤية اللعينة؛
وبكت نفسي الحزينة، كُنت ميتاً بارداً يَعبرُ أسوار المدينة. الجماهيرُ التي يَعلِكُها دولابُ نار؛ من أنا حتى أردّ الداء عنها والدوار. عمِّق الحُفرة يا حفّار، عَمِّقها لقاعٍ لا قرار.
نسير أنا وحاوي تحت السماء التي تحلق فيها الطائراتُ الإسرائيلية وتقصف في الشمال والجنوب. ها هي طبول الحرب قد قُرعت، والمجزرة تستمر على وقع الأغنيات والأمنيات. يحشرج الشبح الواقف إلى جانبي، يومئ بيده في محاولة شرح شيءٍ ما، تتحول حشرجته إلى عواءٍ حزين. هل تريد الانتحار مرة أخرى يا حاوي؟ يُعجزه القول، فيتناول البندقية مرة أخرى ويفرغ الرصاص في رأسه، فتنفر الدماء في وجهي وتسيل كما لو أنها شلالٌ ينزّ من خصر المجرة، وتغرقُ الكائنات السائرة إلى موتها كقرابين… أفردُ يدي التي طويتها مثل بندقيةٍ ووضعتها أسفل ذقني، وأعود إلى البيت.
ينمو ضِرسٌ في الطرف الآخر من فكي؛ يشق الجلد ويشلُّ الألمُ دماغي. إنه تعذيبٌ بطيءٌ تحت الرطوبةِ الخانقة. تَغيم الرؤية وأفقد التركيز، ثُمّ يَنتشرُ الخدرُ في أنحاء جسدي. يُشبهُ ألمَ الأسنان ألمَ الصاعقات الكهربائيةِ التي اختار المحقق المنطقةَ بين الإبهام والسبابة ليفرغها؛ في المنطقة الهشّة بين الإصبعين. قالت لي الطبيبة إنّ الأعصاب فيها تَتصلُ بالدماغِ مباشرةً. الصعقات الكهربائيةُ تُذهِبُ اللغةَ أيضاً؛ تُجمِّدُ الدهشة، وتجعل الأسئلة أكثر إلحاحاً أمام الموجات التي تلوي الجسد مثل سمكةٍ تتقافزُ بحثاً عن اليَمْ. أغلق عينيّ ثُم أفتحهما، أرى حاوي ومارون يجلسان على طرفي الأريكة. نحن الثلاثة نجلس وأكوام الزبالة تحترق من ورائنا. نقرأ فصلاً من كتاب الموتى:
عسى أن أنهضَ وألملم شتاتَ نفسي كما الصقرُ الذهبي الجميل برأس العنقاء.
يشتدُّ الألم. لم أعد أستطيعُ تحديدَ مصدره بالضبط. أتدلى من حبلٍ طويلٍ كما لو أنه يَصلني بحبل الكون السري. أَحلم بأسماكٍ فضية تقفز من صدري نحو سهول واسعةٍ وتلتفُ على جسدي كوشاح، ثم أرقصُ معها كما لو أنني ابتكرتُ الرقص. أشربُ أنهاراً من الخمر، وأتمايلُ مع الحبل الذي يلفُ عُنقي ويحزُّها، نرقص بعقولٍ ذاهلة وأجسادٍ مبتورة وعظامٍ مَطحونةُ، وآلافٌ بأشلائهم المبعثرة ينهضون من المدن المتساقطة ويلتفون حولي. ندور حول بعضنا بعضاً؛ ينهكنا الرقص ونجلس في الصمت. أمضي وقتاً طويلا في دفع شياطيني التي تَتسلّل إلى الغرفة، تنفذ من الشقوق وتهمسُ لي بأشياء مرعبةً؛ الأبالسة يقولون لي لا سبيل للنجاة سوى السؤال؛ دع المواخير العامرة لأصحابها حتى لو رجموك. أتحركُ نحو مقدمةِ السفينة _ أقف على زاوية الشرفة. يَقفزُ ميرو إلى جانبي:
اثبتْ..
لن تبلعنا العاصفة التي تَهيج في الشرق. سَتحتدمُ المعركةُ عمّا قليل، وسيتسلّلُ القتلة يا ميرو مع أمواج الظلام، فَكن درعي لأكون سيفك.
*****
عُدت للتوسلِ لدلّي على طبيبٍ (رخيص)، وأوصلتني المحاولات الجاهدة بَعد لأيٍ إلى رقمٍ معنونٍ باسم الدكتور بغدادي. لم تكن عيادة الدكتور بغدادي بعيدةً عن المنزل؛ عشرات الأمتارِ نَحو فسوح. مشيت باتجاه كنيسة السيدة، وفيما كُنت أنظر نحو الشرفات والآرمات، انتبهت الى رجلٍ ثمانينيٍّ يقوم بسقاية نباتاته. ابتسم لي وأشار بيده للصعود. صعدت بناءً قديماً بممراتٍ واسعة. فاحت رائحة الغرابة منه، ولا أدري لماذا تذكرت مقتل الصحفي سليم اللوزي: عُذِّبَ لثلاثة أيام، قالوا إنهم مزّقوا عظم يديه قبل أن يقتلوه. أطبق شيءٌ ما على صدري، ثُم شعرت بثقلٍ في قدمي؛ كأن ثمة أيادٍ خرجت من قاع الأرض لتجذبني نحو الأسفل. استقبلني الحكيم مُسرعاً ورحَّبَ بي. جلستُ على الكرسي أتأمّل الرجل. اشتعل رأسه شيباً، وتهدّلت عيناهُ عن حزنٍ عميق. انحنى ظهره قليلاً، لكنه كان يتمتعُ بصحةٍ جيدة. انسابت موسيقى كلاسيكية بهدوءٍ كما لو أنها تصدرُ من أسطوانة الحرب: هل ذلك معقول! أن تكون الموسيقى لحن الدمار الأليف!
ابتسم بعذوبةٍ وقال لي: ماذا تشتكي في أسنانك؟
أجبت مازحاً: أشتكي من جيبي حكيم.
شرحت له قصتي مع كوليت التي اقتلعت قلبي، فابتسم وقال:
العتب على عمتك التي تملك بئر نفطٍ وجف.
تمددت على كرسي العلاج، نظر بيأسٍ ثم قال:
هل تعرضت لقصف؟
ترددتُ بالإفصاح عن موقفي، فاكتفيت بتدوير عينيّ باسماً.
ثم سألني: إلى أين العزم؟
لم أفهم في البداية، ثم أردف يشرح لي كيف سافر الكثير ممن جاؤوا إلى هذه العيادة إلى أوروبا هاربين من جحيم لبنان وسوريا. عالج الحكيم مئاتٍ من السوريين. حكى لي بعض قصصهم، شتم بلطفٍ السياسيين الفاسدين وتحريضهم ضد السوريين. أعياه الفساد المستشري في البلد، فراح يشرد وهو يتحدث. عيادته في التباريز استولى عليها السوليدير، وضاعت مثل آلاف البيوت التي استُولي عليها تحت عنوان «إعادة الإعمار». نمت المدينة الجديدة على جثث الآلاف من الضحايا الذين قضوا دون عدالة.
كزّ على أسنانه وقال:
لو أسطيع السباحة لما بقيت لحظةً في هذه البلد.
أنهى الحكيم جولته في فكي، ثم سألني: ماذا تعمل؟
أجبته: أصنع أفلاماً وثائقية.
ابتسم بمرارة، وعاد ليكزّ على أسنانه، ثمّ قال: أخي كان صانع أفلام، لكنه رحل باكراً… كانت السينما شغفه؛ كما لو أنها في جيناته. صَمَتَ قليلاً، ثم قال: أخي مخرجٌ من الجيل القديم؛ اسمه مارون بغدادي.
مارون يحدّق في وجهي. الأصدقاء الذين رحلوا صغاراً يحدقون في وجهي. نكبر فيما هم عالقون في الصور. خليل حاوي يحدّق في وجهي؛ آلاف العيون الجامدة تحدق في وجهي؛ وأنا أحدّق بوجه الحكيم الذي هَرِمَ فجأةً مثل شجرةٍ تآكلت على نفسها.
روى الحكيم تفاصيل كثيرةً قرأتُها أثناء بحثي عن شخصيات الفيلم. حكى لي عن أفلام مارون الأولى، وعن لقائه بكوبولا، وعن يأسه من لبنان وأوروبا. ثم قال: سمعت الكثير من القصص عن موته. بعضهم قال اغتيل… لكن ذلك ليس صحيحاً.
لقد سقط في منور البناية بسبب انقطاع الكهرباء، ثم تنهد قائلاً: لقد مات ميتةً تشبه البلد.
تقاضى الحكيم أجراً زهيداً مع نصائح دافئة للعناية بالأسنان. سار معي إلى باب العيادة وودعني كأب. سرتُ في أحياء الجعيتاوي، وبدت الطرقات أكثر قسوةً؛ كما لو أن الذي حدث قد ابتكرتُه في خيالي، كما لو أنني ألّفتُ هذه القصة المليئة بأشباح الحرب وأدورُ فيها دون نهاية. لم يتوقف الألم، ولم تختفِ الأشباح التي كنت أجرّها خلفي.