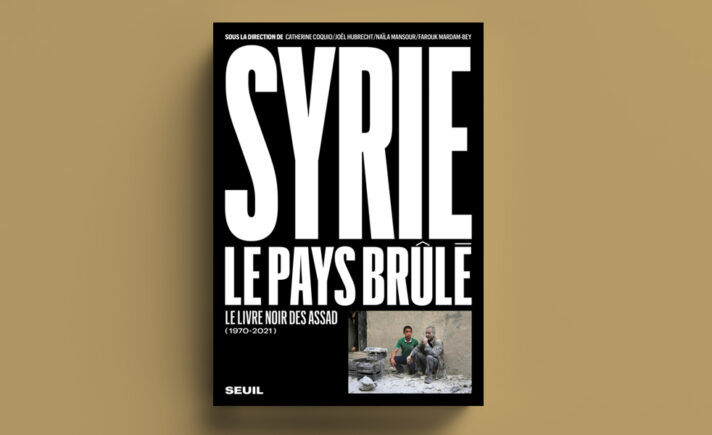في يعفور، البلدة الصغيرة غرب دمشق، وضعتُ فوق رأسي خوذة قذرة يزيد وزنها عن الثلاثة كيلو غرام – اضطررت أن أحك رأسي لثلاثة أيام بعد نزعها – وارتديت زي محارب أموي واسع المقاس، أكمامه غطت معظم أصابعي. لم تكن هنالك بدلة تناسب حجمي. حملت سيفاً وترساً، وقاتلت بهما الأعداء من شروق الشمس حتى مغيبها لأجل قضية لا أعلم عنها أي شيء.
وبعد المعركة أحضرت حلة كبيرة إلى ساحة العسكر، وسرعان ما وقف الجنود حولها في طوابير. كنت واحداً منهم على أي حال. أمسكت بكأس بلاستيك بيضاء، بينما كان الجند أمامي يُدخلون أيديهم المتسخة داخل الحلة الكبيرة ويغرفون شاياً، تاركاً كلٌّ منهم قذارته الخاصة بالشاي في الحلة.
بعد أن شربت الشاي، ناداني المخرج لأؤدي دوراً ثانوياً صغيراً في المسلسل التاريخي الذي يصوره، والذي أكاد فيه أنطق نصف سطر مكتوب وتلمحني الكاميرا من جانبي الأيسر. ولما حاولت التمثيل لثلاثين ثانية، أدركت صعوبة الأمر؛ أن أقوم بانتحال شخصية ما، وأن أصبح ممثلاً؛ أن أتقمص شخصيةً ما وأنطق بكلامها. من أنا ومن هذا الذي أنطق بلسانه؟ ولماذا علي أن أعيد تصوير هذا المشهد لخمس عشر مرة، وسط صراخ المخرج الذي يلوم الإنتاج قائلاً: «أحضروا لي أشخاصاً تجيد التمثيل، لن أضيّع وقتي مع الكومبارس كي أوفر عليكم بضعة آلاف».
وبعد نصف ساعة، يئس مخرج العمل من إنجازي للمشهد كما يريده أن يظهر، وقرر الاستغناء عني وعنه. لم يلمْني المخرج وقتها، ولم ألُم نفسي أيضاً، لقناعتي التامة بأنني لست ممثلاً، وأن الفضول ومن قبله «جريدة الوسيلة» التي كان يحملها صديقي ورأى إعلاناً فيها عن فرصة عمل لكومبارس وأدوار ثانوية هما من دفعني لأذهب إلى استوديو التصوير في يعفور، حيث شاركت في التمثيل مقابل مبلغ زهيد صرفت نصفه على علب الشامبو كي أتخلص من حكة الرأس والقمل الذي عشعش في رأسي لأيام بسبب الخوذة القذرة.
*****
في دبي، دعتني صديقة لمشاهدة فيلم في سينما – نسيت اسمها، وفي الحقيقة منذ غادرت الإسكندرية لم أعد أحفظ أسماء الأماكن التي أقصدها، كما لم أعد أحتفظ بتذاكر الدخول كما كنت أفعل في سينماهات محطة الرمل.
وبعد الفيلم، اتجهت معها بصحبة أصدقائها لمطعم صيني. كنت لأول مرة أراهم، وكالعادة لم أبادر للتعرف عليهم، كما لم أتهافت لأفتح لائحة الطعام. وكنت قد أخبرت صديقتي بأن تطلب لي وجبة كالتي تطلبها.
وبأسئلة قصيرة وغير مباشرة حول منشئي وعملي والأماكن التي قصدتها، وبالتأكيد استناداً على تعريفي مسبقاً من قبل صديقتي، بدأ أحدهم يلعب لعبة أن يدير الحديث حول ما يراه مثيراً بالنسبة لي. أراد أن يكسر تحفظي بأية طريقة، وأن يقودني لنقاش يمتحن فيه قدرتي على المجاراة في الحديث أمام صديقتنا المشتركة.
لم أكن ندّاً في هذا الحوار. كنت شديد الاختصار، ولم أفكر كثيراً فيما أقول كما كان يفعل هو. حقيقةً لم أكترث بأن أرسم صورتي أمامهم. كنت أراقب ابتسامته وهو يعُدّ الجولات التي فاز بها. هل هي معركته إذن؟
وبعد أن أدركت تماماً أنه من الأشخاص الذين يحفلون بلقب الجوكر؛ أي الأشخاص القادرين على التواصل اجتماعياً مع فئات مختلفة من البشر والتماهي مع انطباعاتهم واهتماماتهم، ويُتقنون تمثيل حالة الاستمتاع والاندماج بالأحاديث التي يقولونها ويسمعونها على حد سواء، سألته عن مصطلح كان قد ذكره لتوّه، ووضعته في مقام الأستاذ ووضعت نفسي مقام التلميذ.
وبابتسامة أومأت له: هل تقبل استسلامي؟
في ستاربكس – أذكر اسمه لأنه يذكرني بأفرعه في الإسكندرية – وضعت اللابتوب فوق الطاولة وطلبت من فتاة تجلس على طاولة مجاورة أن تضع شاحنه في المقبس القريب منها. ردت علي بلهجة سورية، رغم أن ملامحها لا تشير لذلك. سألتها «هل أنت سورية؟». قالت «لا، مصرية ولكن أتكلم كل اللهجات، فأنا ولدت هنا في دبي ولدي أصدقاء من كل الجنسيات».
حنّق وجهي وأجبتها بخمس كلمات خرجت دفعة واحدة من فمي: «لا، لا، لا أظن أن من الضروري أن تتحدثي بلهجة أحدِهم ما دمت تستطيعين التواصل مع الآخرين بلهجتك الأصلية».
بعد أن غادرت المطعم التونسي، كنت أفكر بماهية الحياة في مدينتي الجديدة، وفي احتمالية أن تُرغمني الظروف على أن أتحول إلى جوكر – أو إلى شخص مستهلِك بتوصيف أدق – أو على أن أتنازل قليلاً وأتقبل الجواكر الكثر من حولي، خصوصاً وأن فرص الحياة وسعادتها تتوفر هنا للجواكر والمستهلكين قبل أي أحد.
تذكرت وقتها أيضاً عنوان كتاب عديم القيمة، لعلّه أُلّف خصيصا للجواكر، اسمه كيف تتحدث عن كتب لم تقرأها. دُهشت لما رأيته على الرفوف الأولى في المكتبات! لماذا علي أن أتحدث عن كتب لم أقرأها! هل من الضروري أن أدعي المفهومية في كل شيء! ألا أستطيع الصمت قليلاً والاستماع لمن هم حولي؟ هل ستفرض علي هذه المدينة التمثيل وأنا لا أجيده لثلاثين ثانية؟
*****
أحياناً أتخيل أذنيّ تعملان كمسجل، أكثر من كونها أداة سمع. فمن مهامها تفسير الأصوات وتحليلها، وإعطاء الإشارات الآنية، ومن ثم الرد بإيعاز جديد للجهة المسؤولة عن الحديث.
أنا أشك حقيقةً بأن المخ عندي يعطي أي إشارات آنية للتفاعل مع أي أمر، بل يفضل أن يكرس لحظاته في العمل كمخزن بدل اجتهاده في الرد الآلي على ما يراه ترّهات.
ولا أنكر بأن العمليات الفكرية في رأسي تخضع لسيطرتي المطلقة كنظام يعتمد على قرار فردي ديكتاتوري، إذ أستطيع متى أشاء أن أفرض إرادة معينة، أما قناعاتي فأتخيل أنها باتت تخضع لشيء أكثر تعقيداً؛ شيء يشبه مجلس الشورى.
منذ يومين كانت خالتي تحدثني عن سبب خلافاتها مع جارتها. كنت مصطنعاً إلى حد كدت أفتقد فيه أقل درجات التلقائية؛ حتى هزة رأسي وابتسامتي كانت تنفذ بأمر رئاسي. شعرت للحظة بأنني تحولت لمخرج سينمائي – إضافة لدوري كممثل – عندما اشترك زوجها بالحديث، فكان علي أن أقلب النظر بينهما بشكل منضبط عندما ينتقل الكلام بينهما. كنت أحاول أن أتتبع الصوت لأنقل نظري على المتحدث.
وقد جرى وأن تحدثا سويةً حتى تُهتُ بينهما، فلم أعد أعلم مَن الأجدى في لقطتي الآن – وأقصد هنا نظرتي – فقررت أن أبقي كادري على آخر من كان يتحدث، والثاني الذي دخل حديثاً في الحوار أتجاهله، إلى حين تمكُّني من تطوير آلية النظر من خلال إيمائي للمتحدث الثاني لثوانٍ معدودة لأُظهر اهتمامي قليلاً قبل أن أعود للمتحدث الأول.
يبدو أن تكون مخرجاً أمراً شاقاً، كما أن تلقائية العقل في توزيع اللقطات واختيار زواياها شيء شديد التعقيد.
لا أدري إن كنت أبدو كالأبله حين يحدثني الآخرون، أو إن كان أحدهم يدرك أنني أرد لمجرد الرد وأنني أساير قصصه لأصل لنقطة يمكن فيها قطع المشهد، كمخرج بَرِم ولكن مضطر لاستكمال ما بيديه.
أحياناً أُخفي فشلي في التمثيل خلف ابتسامة غبية، وأحياناً أخرى أحاول أن أقلد ردودهم لكي أبدو مثلهم. لم أعد في الحقيقة متحمساً للحديث عن أي شيء في هذه المدينة؛ مدينتي الجديدة. وسرعان ما أنسى لحظاتي وشخوصها فيها صباح كل يوم جديد، وكأن يومي المتكرر عبارة عن حلم قصير بأحداث جديدة لا تستحق الاستعادة والاستذكار.
ولا أنكر أنني صرت اليوم أفضل من البارحة في مهنة التمثيل، أو أن بعض المواقف الحرجة جعلتني أجتهد أكثر لأبدو أكثر إقناعاً. ففي الفترة الماضية تمكنت من إتقان تركيز النظر في وجه المتحدث بشكل يبدو طبيعياً، وإن كنت لا أبالي حقيقةً فيما يقول. كما لا أخفيكم القول بأنني أصبحت أُجيد صناعة ردّات الفعل عندما يحتاج الموقف.
كم يبدو التمثيل مجهداً يا صديقتي! خصوصاً وأنني لم أُجِده لثلاثين ثانية كما تعرفين. وكم أشتاق لتلقائيتي معك في ساعات لقاءاتنا الطويلة في مدينة الإسكندرية، حينما كنا نقضي أكثر من اثنتي عشرة ساعة تحت ضوء أصفر خافت في سقيفة T.B.S العلوية في كفر عبدو، نتحدث عن أفكارنا المجنونة وعن رغبتنا بأن تنتهي كل المدن عند مصافّ الإسكندرية، وأن تتحول مدينتنا لجزيرة يحوم حولها المتوسط من كل جانب، وأن تجتمع الأقدار كلها لتقرر بقائي معك في مدينة الإسكندرية.
حينما فكرت أن أصنع فيلماً سينمائياً عني وعنك، بحثت بين حسناوات مصرعن فتاة بفتانتك ورهافة وجهك؛ عن جمال عذري يشبه جمالك؛ عن حضور كحضورك وابتسامة كطفولية ابتسامتك. فلم أجد. فاخترتك لتؤدي دور البطلة. وعندما أردت ممثلاً ينقل كلماتي وتلقائيتي في المشاهد التي ستجمعني معك كبطل، لم أبحث، لأنني أشك بأن أحداً سيجيد كلماتي بتلقائيتها وعبثيتها كما أجيدها أنا معك.
*****
هل كان هذا الأمر يستحق كل هذه الدراما، عندما شهدت إحدى ليالي الإسكندرية الباردة – في شارع صفية زغلول تحديداً – خلافنا الوحيد؟ هل يمكن أن أسميه خلافاً؟
كنتِ حينها تطيرين كفراشة على رصيف المدينة، وكانت تلعب وراءك إحدى أغاني فرقة مسار إجباري، فرقة الآندر جراوند المفضلة لكلينا. في لحظة، بتِّ أكثر خفة، وكادت قدماك تلامسان الأرض، وشعرك الأسود الكاحل يفرش جناحيه كيمامة. كنتِ منسجمة تماماً مع كلمات الأغنية وزخارف شارع صفية زغلول الفلورنسية. أصبحتُ خلفك تماماً بينما كنت ترتفعين أمامي. وقتها جَزَعتُ وتملّكني شعور الغيرة، وبحركة لا إرادية نثرتُ شعرك بقطرات الماء حتى بللتُه. ولا أدري لماذا فعلت ذلك! هل كنت أحاول أن أُثقل شعرك بالماء حتى لا تطيري؟ هل كنت أحاول أن أبخّر لهيب هذه العلاقة التي تربطك مع المدينة، على حساب علاقتي معك؟ لا أدري. ولكن قطرات الماء وقتها أضفت هالة سحر أخذت تحوم حولك، لتجعلك تهبطين إلى الأرض وكأنك تقفزين من أعلى فندق سيسيل المرتفع. وحينما وقفتِ والتفتِّ إلي، كانت عيناك ممتلئة بالدموع وكأن طبقة بلورية تشكلت عليهما.
وبعتب شديد، سألتِني وقتها لماذا فعلت ذلك. «لماذا بللت شعري؟».
لم أكن أتوقع ردة الفعل تلك. كان الأمر مجرد دعابة، لكن لم يكن الوقت مناسباً لتبرير تصرفي، وتسخيف ردة فعلك. كنت على وشك أن أقول «هل تبكين من رشة ماء؟». كانت دموعك، التي تنهمر للمرة الأولى منذ عرفتك، قد أنستني كل ما جرى وأجبرتني على معانقتك كطفلة صغيرة. قبل ذلك لم نكن أبداً بهذا القرب. كان عناقَنا الأول.
أستطيع أن أقول إن هذه الحادثة كانت طارئة جداً على علاقتنا، ولا أذكر أننا قد تخاصمنا حتى ولو للحظات، رغم اجتماعنا لساعات طويلة في كافيهات الإسكندرية، وعند مقاعد محطات الترام، وفي حديقة اللنبي بكفر عبدو، حديقتنا الخاصة التي سرنا بها آلاف الساعات مع رواد دار المسنين المجاور.
وأظن أن هذه النقطة بالتحديد، أننا لم نختلف على شيء قط، ولم يترك أحدنا للآخر ما يشوه صورته يوماً ما عندما لزم ذلك، هي ما جعل الأمور تبدو أصعب بكثير مما تخيلناه.
فدائما ما تموت العلاقات بين العشاق بسبب مواقف معينة، يكون أحدها كفيلاً بخلق مجال من الكره، فيصبح قتل الآخر اضطرارياً. لكننا، أنا وأنت، لم نشهد موقفاً حقيقياً نستذكره، إلا تلك الحادثة في شارع صفية زغلول عندما بللتُ شعرك بقطرات الماء. ولا أدري لماذا بكيتِ وقتها؟ هل كنت تحاولين أن تصنعي موقفاً واحداً تلومينني عليه؟ هل كنا بحاجة أن نمثل اللوم والعتب، ولو قليلاً؟ أستطيع القول إن الحب بيننا لم يُقتل ولم يتأذَّ حتى، كما يجري عادةً مع الآخرين، بل مات انتحاراً وببطء، من الألم والأرق والهذيان.
*****
في الإسكندرية كنتُ شخصاً شفافاً، حيادياً، لامرئياً أغلب الوقت، بالكاد يلاحظ وجودي صديقي الذي يشاركني أجرة الشقة في منطقة سيدي بشر. لم أكن أُحدث ضجيجاً، وكنت أشغل كنبة الصالة القريبة من البلكونة المليئة بالخردة أغلب الوقت.
لكن عندما يحين موعد لقائنا، كنت أتحول من شخص شفاف إلى ما يشبه الظل؛ فألف كيانك من كل جانب، أحب ما تحبين وأكره ما تكرهين، أستخدم مفرداتك الجديدة، وأقلد ضحكتك، أبدل قائمة الأغاني التي أسمعها يومياً أثناء رياضتي الصباحية، وأضيف عليها تلك التي تُدَندِنين بكلماتها أثناء مسيري معك.
هل أبدو ضعيفاً؟ عديم الشخصية؟
لم أكن أشعر بذلك. كان يغريني أن أكون قالباً لك، وأن أذوب في مكامن شخصيتك، أن أكون لازمة يومية في حياتك، أن أكون شخصاً عنكبوتياً تُحيطك خيوطي من كل جانب. خيوط؟! لا أدري لماذا اخترت هذه المفردة. هل ألمّح إلى أن الفتيات اللواتي يدخلن في علاقة معي يتحولن لدمية مع مرور الوقت، أحركها كيفما أشاء، كلعبة في مسرح الظل؟
لا أحب العلاقات التي تحتمل بعض التكلف أو الغموض، ولم أكن طرفا في أي منها يوماً. لا أحتمل التمثيل حتى ولو كان بسيطاً. يجب أن تفقدي حذرك قبل أي شيء، وأن تقبلي بأن أكون مرآة لك، أن أكون ظلاً لكل تفاصيلك، وعليك أن تُدمني على كلماتي وعلى أفعالي التي تقولبت وأصبحت بهذا الشكل لأجلك.
بعد كل هذا، هل من المنطق أن نتصادم، أن نسيء الفهم، أن نَتوه في الأحاديث، أن تختلط مشاعرنا؟ يبدو مستحيلاً على امرأة عارية وظلّها الذي تعرّى من كل شيء لأجل توأمتها، وربما لهذا لم نكن لنختلف خلال سنتين من الزمن إلا مرة واحدة في حادثة رشة الماء.
ذات مرة، أخبرني أحدهم في مدينتي الجديدة بأن الأصوات التي تُصدرها الفتيات أثناء ممارسة الجنس، غالباً ماتكون مصطنعة، وخصوصا العاهرات اللواتي يفتعلن هذه الأصوات ويُتقنّ تمثيل الاستمتاع بالعملية الجنسية لإثارة الرجل الذي تتراءى فحولته أمام عينيه من خلال صيحاتهن.
فيما بعد، أدركت أن العاهرات أفضل الممثلات. وخشيت أن أخنع، أن أبحث عن التفضيل، أن تجبرني الظروف على منافسة العاهرات وأنا لا أجيد التمثيل لثلاثين ثانية!