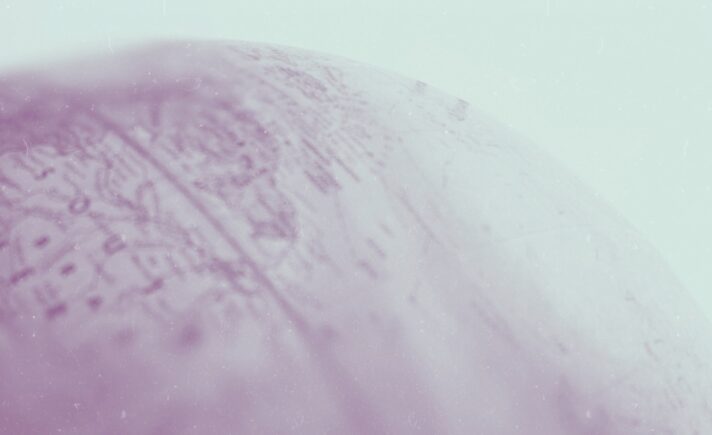في عزّ فورة التسعينيات من القرن الماضي، بدت البلدان التي بزغت عن تفكيك يوغسلافيا وكأنها تخرّب الحفل. ففي حين كانت أوروبا مستعدة للاحتفال بتوحدها، كان الناس يقتلون بعضهم بعضاً في البلقان. كانت تلك لحظة تغري المرء بتجاهل ذلك الجزء من العالم على اعتباره إقليماً دخيلاً، بل وليس جزءاً من النادي ببساطة. عندما فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه كي تنضم بلدان أوروبا الشرقية إليه، ولو بحماسة مبدئية ضئيلة، لم يكن عرض كهذا قد وُضع على طاولة دول ما بعد يوغسلافيا.
كانت نهاية الشيوعيّة في يوغسلافيا مختلفة أيضاً. لم تحصل انتفاضة شعبية هناك، ولم تقم احتجاجات جماهيرّية من أجل الديمقراطية. كانت المنافسة الناعمة للسلطوية والتعددية في الدولة تعني يومها أن الديمقراطية لم تكن المطلب الرئيس. وعندما حصلت التظاهرات بالفعل، قامت للمطالبة بالحكم الذاتي الوطني من قبل المواطنين. ولكن إلى أيّ حد كان الاستثناء اليوغسلافي، في الواقع، استثنائياً؟
في أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي، كان للعرض الفكاهي البوسني المعروف باسم «السورياليين» (Nadrealisti) وجهة نظر مختلفة، هم المعروفون بفكاهتهم المرّة وتوقعهم للمسار الذي يسير بلدهم عليه. يومها أدَّوا لوحة فكاهية يظهر فيها مراقب أوروبي يختلس النظر من فوق جدار ويراقب نهاية قرن من الحروب اليوغسلافية. يُدعى اليوغسلافي الأخير الناجي للانضمام إلى «مجتمعنا الودود الصغير»، ولكن خلال مأدبة احتفالية، يبدأ الأوروبيون تدريجياً بالدخول في خلافات. وفيما يتفاقم الجدال الناتج عن الخلاف، يهرب اليوغسلافي الأخير وقد حشا نفسه بالمأكولات الفاخرة المقدّمة على طاولة المأدبة. وفي المشهد الأخير، نرى مراقباً من يوغسلافيا ينظر من فوق جدار إلى أوروبا الموحدة متطلعاً إلى الحرب الدائرة هناك، وقبل أن يذهب لشرب كأس من البيرة، يُبعد السُّلَّم عن الجدار كإجراء وقائي «كي لا يأتي واحد من هؤلاء الحمقى إلى هنا».
بدا احتمال الحرب كما رآها السورياليون، والعديد غيرهم في يوغسلافيا، احتمالاً عبثياً في عام 1990 كما هو اليوم بالنسبة إلى الكثير من الأوروبيين. وفيما ما تزال الحرب صعبة التخيّل في أوروبا، يتشاطر تصدع أوروبا بعض التشابهات مع مصير يوغسلافيا. قارَنَ الاقتصادي السلوفيني يوشي مينسينغر الاتحاد الأوروبي مع يوغسلافيا، مجادلاً أن كلا التجمعين فشلا في التغلب على الاختلافات بين أعضائهما. ولكن تبقى الاختلافات بين القصتين الأوروبية واليوغسلافية لافتة. إذ يمكن لأي بلد مغادرة الاتحاد الأوروبي على الرغم مما أظهرته «بريكست» من صعوبة في حالة كهذه. ولكن لم يكن هنالك من أي طريقة قانونية واضحة للجمهوريات اليوغسلافية للخروج من الاتحاد. على الرغم من مواقفه الجدليّة في بعض النواحي، يشكل الاتحاد الأوروبي وحدة ديمقراطية توافقت ديمقراطياً على آليات شرعية لاتخاذ القرار؛ فيما فشلت يوغسلافيا على الدوام. في إيجاد تدبير من هذا القبيل.
ولكن، بعيداً عن هذه الاختلافات المؤسسية، واجه كلا المشروعين تحدياً واسعاً مشابهاً في التعامل مع التباعد والتقارب الاجتماعي والسياسي. فكلاهما تأسس من أجل الترويج للازدهار، ولجعل الحرب مستحيلة الحدوث بين الدول المكونة لهما، فيما هما يطوّران فكرة القيم المشتركة ويقطعان الوعود للمناطق الأكثر فقراً بإمكانية اللحاق بالبقية. فشل هذا المشروع في يوغسلافيا مع تزايد غنى الجمهوريات الأغنى وتراجع المناطق المتخلفة أكثر فأكثر. أما في الاتحاد الأوروبي، فما يزال التقارب يؤدي عمله بالنسبة إلى بلدان وسط أوروبا. اقتربت كل الدول، ما عدا سلوفينيا، من معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد كما حدده الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من عدم تمكن أي من هذه الدول من تحقيقه تماماً، تعتبر جمهورية التشيك الأقرب بين هذه الدول بمعدل يبلغ 89%. حصل تباعد كبير في جنوب أوروبا، حيث تراجعت بشدة كل من البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان بخاصة. ففي 2006 كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في اليونان مقارباً لمعدل الاتحاد الأوروبي (96%)؛ ولكن مع حلول 2017، بلغ ثلثي هذا المعدل فقط، ليصبح على نفس الدرجة التي تقع لاتفيا عليها. وهكذا اهتزت فكرة تقارب الشمال والجنوب.
ليست الأزمة الاقتصادية فقط ما تسبب بهذا، ولكن أيضاً الفجوة المتزايدة بين شمال غربي أوروبا وجنوب أوروبا، وهي الفجوة التي سهلت صعود الأحزاب الشعبوية اليسارية مثل حزب سيريزا اليوناني (Syriza) وتلك اليمينية مثل ليغا الإيطالي (Lega).
ولكن التقارب يعني شيئاً ما أكثر من التقارب الاقتصادي. خلال السنوات الأولى من التحوّل، توقع عديدون أن تتبع أوروبا الوسطى النماذج الغربية. وما من مكان ظهر فيه استيراد كل شيء من الغرب، بدءاً من المدراء وأساتذة الجامعات وصولاً إلى الشركات والإعلام والأحزاب السياسية، أكثر مما في ألمانيا الشرقية السابقة، حيث تم استيراد الدولة ذاتها أيضاً من الغرب مع استبقاء القليل جداً من البنى السابقة. في أماكن أخرى نجت الدولة من ذلك الوضع، ولكن بقيت القوانين والأحزاب والمؤسسات والاقتصاد منشأة على أساس نماذج خارجية.
أدى هذا إلى متناقضة السيادة. فقد ركزت العديد من الحركات الديمقراطية التي نشأت خلال الأعوام 1989-1991 على استعادة السيادة الوطنية من الاتحاد السوفييتي ومن يد النخب الحاكمة الصغيرة وغير المنتخبة. ولكن ما إن تم ذلك حتى بدا أنّ تحديات الانتقال العديدة تتطلب استيراداً للنماذج الغربية من دون تمييز. كما عنت الأوربة أن على القوانين والمؤسسات أن تحقق متطلبات الاتحاد الأوروبي من دون أخذ الوقت اللازم لمعرفة مدى مناسبة أو ملاءمة هذه القوانين والمؤسسات للبلد المعني. وهكذا كانت السيادة منقوصة، ولكن بقي السبيل الوحيد لاستعادة الاستقلال هو كون البلد عضواً في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم حينها رفع القيود المفروضة في شروط الانضمام. قد يبدو هذا محيراً بعض الشيء بالنسبة إلى شخص يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن من منظور مواطن في أوروبا الوسطى، فإنه لا يمكن حماية السيادة إلا من داخل الاتحاد الأوروبي. وهكذا فحتى الشعبويون والقوميون المشككون بالمشروع الأوروبي، من أمثال أوربان وكازنسكي، هم لا يسعون إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي. هنالك بالطبع أسباب اقتصادية لهذا أيضاً، ولكن المخاوف الكامنة من فقدان السيادة الوطنية هي الأشيع، وكذلك مخاطرة التعرّض لضغوط القوى الكبرى من خارج الاتحاد الأوروبي.
تكمن المتناقضة الأخرى في الاستيراد السياسي. شكّل استيراد المؤسسات والقوانين سبيلاً سهلاً لتأسيس بنى ديمقراطية، ولتأمين نماذج مجربة جيداً. ولكن هذا الاستيراد تجنّب التأني والتجريب، مما أنتج محاكاة للديمقراطية. لقد كان استيراد المؤسسات ناجحاً في البلدان التي لم تؤدّ فيها الممارسات غير الرسمية وغير النظامية لتخريب دور هذه المؤسسات وتقويض استقلاليتها، كما في بلدان جنوب شرقي أوروبا. ولكن حتى هناك، تواجدت جزر من الاستقلالية المؤسساتية من أجل فرض حكم القانون. على سبيل المثال والتخصيص، نجحت إلى حد ما في هذا المجال هيئة مكافحة الفساد الرومانية ونظيرتها الكرواتية.
حصلت المحاكاة الديمقراطية خصوصاً داخل الأحزاب السياسية. بعد 1991، برزت طفرة من الأحزاب السياسية عبر وسط وشرقي وجنوب شرقي أوروبا، وبدت إلى حد كبير وكأنها تشبه الأحزاب الغربية، وقد تكنّى بعضها بصفة الليبرالية والآخر بصفة الديمقراطية الاجتماعية، فيما كان البعض الآخر محافظاً. وجدت هذه الأحزاب الدعم في مؤسسات الأحزاب السياسية الألمانية، وانضمت إلى تحالفات أوروبية عابرة للحدود. وما إن انضمت بلدان تلك الأحزاب إلى الاتحاد الأوروبي حتى شكلت جزءاً من أجنحة كبيرة في البرلمان الأوروبي، وكنظرة أولى، أصبحت تلك الأحزاب أوروبية.
ولكن لم يكن ما سبق سوى تمويه لواقع أن هذه الأحزاب عملت بطريقة مختلفة تماماً عن نظرائها في الغرب. كما لم يكن هناك غالباً سوى القليل من التنويع في برامجها التي نصت على «الإصلاح» و«أوروبا»، وأهداف أخرى لا تقل غموضاً. كمُن الاختلاف الأساسي في التقسيمات الأيديولوجية التي انبثقت من إرث الماضي الشيوعي، وفي بعض الأحيان من القيم الاجتماعية المتفاوتة. بنيوياً، قادت النخبة تلك الأحزاب، فيما كانت للسياسة الجماهيرية نفحة من الحقبة الشيوعية. وإلى جانب ذلك، كانت العضوية في الأحزاب والنشاط السياسي المرتبط بالأحزاب في انحدار في الغرب أيضاً. وهكذا، كانت قلة من الأحزاب قادرة على التعبير عن آراء المواطنين وتجميعها. لم يكن هذا ظاهراً أو هاماً في زمن الأوربة، حين كانت معظم المؤسسات والقوانين والسياسات تأتي من الخارج على أية حال. ولكن هذه الأحزاب ونخبها لم تبدُ على قدر الجدارة عندما تعلق الأمر بحكم بلدانها بعد تحقيق عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي بعض الحالات، كانت أحزاب المنطقة تعمل كجهات توظيف وخاصة في جنوب شرقي أوروبا، حيث شكّل الانضمام إلى الحزب السبيل للحصول على عمل في الإدارة العامة. وما يزال هذا خيارَ التوظيف الأكثر تفضيلاً للكثير من المواطنين في الإقليم، حيث تشكّل عضويّة الأحزاب السياسية ما نسبته 10% من السكان.
وفي حالات أخرى، تشبه تلك الأحزاب عرضاً فردياً يؤديه رجل واحد، أو في حالات أكثر ندرة امرأة واحدة – شرط امتلاكه أو امتلاكها الكثير من الشعبية أو الموارد. لقد دمجت عائلات الأحزاب الأوروبية جميع هذه الأحزاب في صفوفها، ولم تطرد أحداً منها حتى الآن. ما يزال حزب فيديس (Fidesz) في هنغاريا يشكل جزءاً من حزب الشعب الأوروبي (European People’s Party) على الرغم من رفضه الديمقراطية الليبرالية، وإسقاطه الضوابط والموازين الديمقراطية، وتلاعبه بالإعلام، وشنّه حملات معاداة للمهاجرين وللسامية. وبالمثل، ما يزال حزب الاشتراكيين الأوروبي (PES) يضم في صفوفه الحزب الديمقراطي الاجتماعي (PSD) في رومانيا، الذي أسّس عبر السنين تحكماً ناهباً لموارد الدولة. كما ما تزال مجموعة اتحاد الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا (ALDE Group) تضم حزب آنو 2011 (ANO 2011) في جمهورية التشيك، والذي يقوده أندريه بابيش، ثاني أغنى رجل في البلاد، المتحكم بأكبر صحيفتين في التشيك والخاضع للتحقيق في تهم فساد من قبل وحدة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي (OLAF). لم تصبح هذه الأحزاب أكثر عرضة للمحاسبة أو أكثر ديمقراطية عبر عضويتها في عائلات الأحزاب الأوروبية. بل على العكس، عضويتها مكّنتها من حماية مراكزها. وبالطبع، ليست تلك المتلازمة خاصة بدول وسط وجنوب شرقي أوروبا، كما ترينا بوضوح قبضة بيرلسكوني المحكمة على يمين الوسط في إيطاليا خلال تسعينات القرن الماضي والعشرية الأولى من القرن الحالي. ثمة حالة أخرى تبرز في النقاش هنا فيما يخص السياسة الشخصية، وهي حالة السياسي الشعبوي اليميني خييرت فيلدرش، الذي يرأس الحزب الهولندي من أجل الحرية (Partij voor de Vrijheid) والذي يضم عضواً واحداً لا غير هو فيلدرش ذاته.
ولكن هذه جميعها انحرافات لا تعبّر عادةً عن ماهية الأحزاب السياسية.
تساءل الكاتب والأكاديمي البارز من يوغسلافيا السابقة إيغور شتيكس مؤخراً فيما إذا كانت أوروبا قد «بَلْقنَت» نفسها فيما هي تحاول أوربة البلقان. ولكن لا بد من تحدي فكرة أن بإمكان الأوربة نقل المؤسسات والقيم وطرق أداء السياسية الغربية إلى وسط وشرقي وجنوب شرقي القارة. وكما برز في النقاش حول المتناقضات التي تحيط بالسيادة الوطنية واستيراد النظم، فإن التحول في هذه البلدان لم يخلق نسخاً من النماذج الغربية بل مَسَخَ هذه النماذج ذاتها.
بالطبع، حين تفشل حالات النقل هذه، أو حين تصبح أبعد ما يمكن عن أن تكون عملية مستمرة وسلسة، تبدأ سيرورة أكثر تعقيداً من التفاوض والتأقلم وإعادة صياغة الأفكار والقوانين والقواعد. ولكن ماذا عن بلقنة أوروبا؟ علينا أن نكون حذرين عندما نؤطّر الأشياء بهذه الطريقة أو بالطريقة التي أطّر فيها «السورياليون» البوسنيون الأشياء منذ عقدين من الزمن، من حيث صورة المراقبين الذين يسترقون النظر من فوق الجدار والانتشار المُحْكَم لعدوى الأفكار. هنالك مخاطرة تنميط البلقان في جعله إقليماً أُسيء فهمه فأصبح يهدد بنقل عدواه إلى باقي أوروبا بكثير من الكراهية والتعصب. تنحو «بلقنة» كهذه، كما رآها الكاتب البارز روبرت كابلان في كتابه أشباح البلقان، إلى إسقاط جميع السمات السلبية في أوروبا على أقاليمها الشرقية والجنوبية الشرقية. ولكن ليس الأمر أن البلقان أو أوروبا الوسطى يهددان بنشر عدوى اللاليبرالية والتعصب إلى باقي أنحاء أوروبا، بل أن كلا المنطقتين اختبرتا بعض الأسباب البنيوية لتلك التوجهات في زمن سابق، وبتركيز أعلى مما عهدته باقي أوروبا.
تُعدّ أوروبا الوسطى إقليماً ما بعد شيوعي، والبلقان الغربية إقليماً ما بعد يوغسلافي، والأخير أيضاً إقليم ما بعد الحرب وما بعد الاشتراكية، ولكن لا توجد كلمات تصف بالضبط ما هما عليه اليوم، وكأن الحاضر يراوغنا باستمرار. فالسمة المحددة لتلك الأجزاء الوسطى والشرقية والجنوب شرقية من أوروبا هي أنها تقبع في مكان لا يمكن تسمية الحاضر فيه. المصطلح الوحيد الذي يمكن وصف حاضر غربي البلقان به هو «الأزمة»، مع بعض الاستثناءات الطفيفة. هنالك أزمة يوغسلافيا ما بعد تيتو، وأزمة الحروب، وأزمة السلطوية والانهيار الاقتصادي، وأخيراً الأزمة الجديدة المتعددة الأوجه التي تُنتجها الانهيارات المالية العالمية وأزمة الهجرة وأزمات الاتحاد الأوروبي. قد تكون فترة اللاأزمة القصيرة هي تلك التي تغطي الأعوام الأولى من الألفية بين نهاية الحروب ومستهل الأزمة الاقتصادية العالمية. وليس مفاجئاً أن تجعل حالة أزمة دائمة كهذه الكثير من الناس تواقين إلى الماضي، حين لم تكن الأزمة الحالية قد حطت رحالها بعد، أو كان يمكن طردها من المخيلة سواءً عبر الانسحاب إلى ماض وطني ذهبي بحاجة إلى استعادته أو إلى الحقبة الذهبية في تاريخ يوغسلافيا. وهكذا تصبح النوستالجيا سمة أساسية للحياة اليومية.
وعلى الرغم من أن بلدان وسط أوروبا تجنّبت الحرب والانهيار العنيف لدولها، إلا أن العقود الأخيرة تميزّت بالانتقال والتحوّل والتغيير، مما نتج عنه ما يمكن تسميته اصطلاحاً «الإرهاق التحولي المؤجل». يعكس هذا المصطلح خيبة الأمل الناتجة عما يبدو كأنه سيرورة أزلية. لقد كان التحرر من الوهم هو ما يسيّر السياسة اللاليبرالية، والتي قطعت وعداً بوضع حد للمرحلة الانتقالية الأبدية – كما هي الحال مع فيديس (Fidesz) في هنغاريا وحزب القانون والعدالة (PiS) في بولندا، كما أن هذا التحرر هو ما يسيّر الانسحاب العام من السياسة. تصوّر أنه عام 2016 شارك أقل من 40% من الرومانيين في الانتخابات الوطنية، وفقط 13.05% من السلوفاكيين صوتوا في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2014. يوجد خيار واحد أخير هو الهروب، كما فعل ملايين المواطنين الذين غادروا باتجاه ألمانيا والنمسا وإيرلندا. يعيش أكثر من 10% من سكان معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أقاليم خارج أوطانهم، مشكّلين ضعف معدل الهجرة في بلدان أوروبا الغربية.
وتبقى النوستالجيا قوة فاعلة على الرغم من أن أنظمة الحكم الاشتراكية السابقة لم تقدم الكثير مما يغري المرء بالحنين تجاهها، على العكس من يوغسلافيا الأكثر ليبرالية وانفتاحاً. في استطلاع جرى عام 2014، انقسم مواطنو رومانيا إلى فئتين: أولئك الذين يعتبرون الفترة الشيوعية جيدة، وأولئك الذين يعتبرونها سيئة للبلاد. اعتبرت غالبية المشاركين في الاستطلاع أن نيكولاي تشاوشيسكو لعب دوراً إيجابياً. هذا الحنين للماضي، كما جادلت سفيتلانا بويم في كتابها مستقبل النوستالجيا، يعكس أشياء قليلة حيال التاريخ وأشياء أكثر بكثير حيال الحاضر. انعدام المساواة والفقر الصارخة يشرحان جزئياً سبب قوة الإحساس بالنوستالجيا، ولكنه انعدام اليقين حيال التحول اللانهائي والأزمة ما يشكل القوة المسيرة للنوستالجيا وللتحرر من وهم الحاضر.
لقد خلقت المرحلة الانتقالية اللامحدودة إحساساً دائماً بالقلق، شكل عاملاً مدمراً بعمق للسياسة الديمقراطية الليبرالية. انتشر هذا القلق في جنوبي أوروبا، يغذّيه الابتعاد عن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاتحاد الأوروبي المذكور أعلاه. كما أن صعود الشعبوية في أوروبا الغربية منغرس بعمق في سياسة القلق، بما في ذلك في سياق استفتاء بريكسيت، ويف أحزاب يمينية كما حزب البديل لأجل ألمانيا (AfD) وحزب الحرية النمساوي (FPÖ). وفي الأثناء، فشلت النخبة ما بعد الاشتراكية في بناء أحزاب وبلدان تضع نهاية لمرحلة العبور القلق وتنشئ مجتمعاً على أساسات أصلب مما هي عليه السيرورة اللانهائية لترك شيء ما خلف المجتمع ومن دون وصول إلى الهدف المقصود أبداً. يجب أن ترى النخبة الأوروبية هذا كإشارة تحذير.
إن الأزمات وانعدام اليقين وتهديد التغيير اللانهائي ما هي إلا قوى مدمرة. ومن هذا المنظار، ليس الشرق والغرب منقسمَين، ولم ينشر الشرق أو الجنوب الشرقي العدوى في الغرب. ما أصبح مرئياً أكثر في السنوات المنصرمة هو فقدان النموذج الواحد لأوروبا. المجتمعات والحكومات بالأحرى تتعلم من بعضها الآخر بشكل مستمر عبر القارة كلها. ولكن يعني هذا أيضاً أن الشعبويين من كافة أرجاء أوروبا لا بد لهم من يروا النجاح الحالي الذي حققه نظام أوربان الشعبوي القائم على القومية الإثنية. وفي ذات الوقت، وبصيرورتها متعددة الاتجاهات، فإن أوروبا قد صارت أيضاً سوق أفكار أشد خطراً.
إن الانقسام بين الشرق والغرب هو مجرد صدع واحد من الصدوع العديدة في تركيبة أوروبا البنيوية المتنوعة. ولكن وجود خطوط التشظي العديدة والمتنوعة لا يلغي ضرورة بناء حالة تحالف وتضامن عابرة للحدود. لقد أصبحت المخاطر المرتبطة أكثر حدّة عندما أصبحت هذه الفوالق المتعددة تتعزز بشكل متبادل، فاصلةً المركز عن الأطراف، والفقير عن الغني، والشرق عن الغرب. ولكن بدلاً من التركيز على الاختلافات، سأجادل بأن التهديد الأكبر لأوروبا يكمن في انتشار السياسة المثقلة بالهلع. لا بد لمجتمعات دول الأزمة الدائمة من الكفاح. هذه هي الخلاصة الكبرى للثلاثين سنة الماضية.