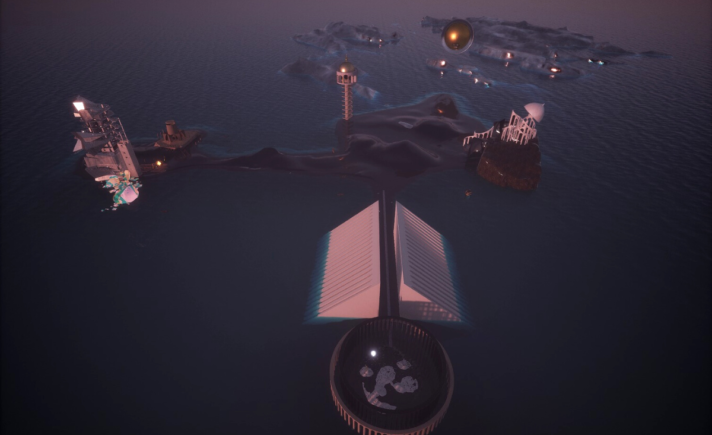بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل وقرية الرفيد في القنيطرة، أقام نازحون من قرى وبلدات ريفي درعا الشرقي والغربي مئات من الخيام، فراراً من القصف الروسي الذي اشتدّ مع إعلان النظام بتاريخ 19 حزيران 2018 نيته السيطرة على مناطق درعا والقنيطرة الخارجة عن سيطرته، و«تطهيرها من الإرهابين وإعادتها إلى حضن الوطن».
ومن بين تلك الخيام، خيمة رمادية تحمل شعارات للأمم المتحدة على سقفها وجوانبها، كنتُ أجلسُ فيها مع خمس نساء جمعتني بهنَّ الصداقة والنزوح، أم مهند وابنتاها إلهام وروعة، وابنة عمهما غيداء، ونسيبتها ابتسام. ولأن حرارة الصيف في فوضى النزوح ترفع حرارة الدماء في الرأس، كانت حكاياتنا عن أحلامنا ورغباتنا أقرب إلى الهذيان، أو أنها كانت محاولة لحصار الجنون الذي يحيط بنا من كل الجهات.
بانتظار المراجيح
شرائط وبالونات تعكس أضواء للبهجة، ومراجيح بألوان مختلفة تدور بفرح، باختصار مدينة للملاهي. هكذا تحكي إلهام للنساء المجتمعات في الخيمة عن حلمها: «قضاء يوم واحد فقط في مدينة للملاهي». كانت إلهام في العاشرة من عمرها عندما ارتدت في أول أيام عيد الفطر، ثوباً أزرق بكشاكش بيضاء وفضية، وحملت حقيبة صغيرة فيها قطع حلوى بنكهات مختلفة، وعيدية من والدها، تحصيها إلهام فتساوي 300 ليرة سورية، لكنها لن تصرفها لتركب المراجيح، أو لتشتري الشيبس والأكلات الطيبة، فوالدها سألها المكوث في المنزل، علّ القصف الذي كان يطال قريتها، الحراك، منذ الصباح يهدأ قليلاً أو يتوقف. تنتظر إلهام، تنتظر ثلاث سنوات، من صيف 2012 وحتى صيف 2015، حتى تسنّى لها أن تسير باتجاه ساحة يفترش الحصى والرمل أرضها، وتنتشر فيها مراجيح ينبعث مع تأرجحها صوت الصدأ. في وسط الساحة أرجوحة مطلية بلون يشبه جداً لون فستان إلهام الأزرق الذي طواه الانتظار، تضع فيها ابن اختها عمار ذي الخمس سنوات، وتخطط: «بعد عامين سأذهب إلى مدينة درعا لتقديم امتحان الشهادة الإعدادية، حينها سأخطف نفسي مع صديقاتي لنطفئ شهوتنا بركوب المراجيح، دون قصف وانتظار».
بعد مرور هذين العامين، في صيف 2017، ترتدي إلهام ثوب زفاف بدلاً من لباس المدرسة أو لباس العيد، ويسألها والدها «المغفرة». لأنه قائد فصيل مسلح، ويخاف عليها من الاعتقال إذا ما ذهبت لتقديم الشهادة الإعدادية، اختار أن يعقد قرانها على ابن جيرانهم خالد.
عتبٌ، بل أشد، في نظرات إلهام نحو والدتها، وجدال صامت كان يدور بينهما في الخيمة، تتراشقانه بنظراتهما.
– زوجك هو المسؤول عن جعلي حبلى قبل أن أتم السادسة عشرة.
– أراد حمايتك يا ابنتي.
– كان يجب عليك أن تمنعيه من حمل السلاح أساساً.
– سيكون ذلك خيانة للثورة يا… إلهام.
قبل أن يتحول الجدال الصامت إلى كلام مسموع، فتشعل كلمة غضب تخرج من إحداهن الخيمة وجليساتها، تطلق ابتسام «أوف» طويلة، وتلقي بذقنها في راحة كفها وتقول: «يال تعاسة جيلكم يا إلهام… غريبة أمنيتك… أما أنا فلدي الأغرب، أحلم بأن أضع ثيابي في خزانة للملابس!».
لعنة خزانة الملابس
في خزانة الملابس تحطّ كل رحال أهل الدار، وتقبع في دروجها ذكرياتهم وحتى أسرارهم. وقد استعانت ابتسام بأمهر النجارين لتفصيل خزانة للملابس، تتسع لعالمها وعالم زوجها وابنها. «متينة شامخة، كانت تنتصب» تصفها ابتسام، ثم ترثيها: «التهمت النار كل شيء، كل شيء، وعبثاً كانت الخزانة تقاومها». وتتابع: «أولاً اعتقلوا زوجي ثم رموني وابني خارجاً، واضرموا حقدهم في كل الدار». كان ذلك قد حصل في بدايات 2014 أثناء حملة مداهمات لعناصر أمن النظام، طالت كل الحي الشرقي في مدينة نوى.
تتكئُ ابتسام على حقيبة مغبرّة جرّاء النزوح: «خمسة أو ستة صناديق (كراتين) كانت خزانتي الجديدة، بعدما رجعت إلى منزلي في آذار 2015، لأكنس الغبار عن أرضه وعن قلبي بين جدرانه السوداء. ما هو المنزل؟ هو جدران وسقف وباب محكم أو غير محكم الإغلاق، إذن ما فائدة ديكورات الجبصين؟ في مطبخ والدتي كانت هناك ثلاث طناجر من الألمنيوم، متعددة الاستعمالات، للطهي، لتسخين الماء وقت الاستحمام، للسلق والقلي أحياناً. إذن لماذا كان طبيخ أمي أشهى وأطيب من طبيخي، وأنا التي أطهو بطناجر “التيفال”؟ يقولون إن طناجر “التيفال” تصبح سامة إذا خُدش طلائها، وأن “المايكرويف” يسبّب أمراضاً سرطانية. اعذُرنني، يبدو أنني أهذي، وكي أطمئن للتعامل مع الأشياء صرتُ أُجرّدها من صفاتها. فالوعاء مثلاً يعني ما يُجمع فيه الشيء ويُحفظ، فلا فرق إذا كان خشبياً أو معدنياً، مدوراً أو مستطيلاً، طالما كان يؤدي مهمة الجمع والحفظ».
تعدل ابتسام جلستها: «منذ شهرين ابتعتُ خزانة للملابس قالوا إن خشبها بخسٌ وتجاري، لا يهمّ. تركتها فارغة، وأوكلتُ مهمة جمع وحفظ ملابسي للصناديق “الكراتين”. قالت الجارات إنه قد أصابني الجنون. ليس جنوناً، بل لعنة! في داخلي شعور يجعلني أعتقد أنه في اللحظة التي سأقرر فيها توضيب أي قطعة في خزانتي الجديدة، ستحلّ عليها لعنة النار. ولكن يبدو أن اللعنة تأهبت منذ اليوم الأول الذي اشتريت فيه خزانتي الجديدة، والدليل أنني الآن معكنَّ نازحة في خيمة، وتؤدي حقيبتي هذه (تشير ابتسام إلى الحقيبة التي تتكئ عليها) مهمة حفظ وجمع ما تمكنت من حمله من ملابسي».
تحوقل أم مهند لاعنةً روح من أوصل الشعب، كل الشعب، إلى الذل والمهانة. تصمت ابتسام وتشرد قليلاً، ثم تشير إلى غيداء التي غطت مساحيق التجميل وجهها، وتسألها: «هاتي ما عندك يا عروستنا الحلوة»، فترد غيداء: «أقلّه يا خالة أنكِ خبرتي ثياباً وخزانة، وأن إلهام رقصت بثوب زفاف».
متزوجات… ولكن
في مخيمات النزوح يصبح تداول الأسرار والأحاديث الخاصة أكثر يسراً وسهولة، وأغلب الظن أن كثيراً من نساء المخيم كُنَّ يعلمنَ أن غيداء متزوجة، لكنها لا تزال عذراء، ولذلك لا يستهجنَّ تنقلها منتعلة حذاءً زهرياً بكعب عالٍ، متأنقة واضعة أحمر شفاه فاقع، لتجلس على حجر أو تحت ظل شجرة مع زوجها محمود، ويغرقان في الحب مع وقف تنفيذه!
تقول غيداء: «كان يفصلني عن ارتداء ثوب الزفاف والتمايل به بين صديقاتي أربعة أيام فقط. ولكن وفي الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق، ظهيرة يوم 25 حزيران 2018، وهو التاريخ الذي لن أنساه ما حييت، اكتظّت السماء بالصواريخ والطائرات. هذه المرة كانت مختلفة، علينا أن نغادر بلدتنا الحراك، كان هذا ما يقوله والدي لمحمود على الموبايل. نصف ساعة أو أقل وتصل حافلة أهل محمود “الفان”. فوق بعضنا، تحت بعضنا، تتدبر عائلتي وعائلة محمود أمر الجلوس في الفان. وننطلق إلى بلدة الجيزة، نمكثُ فيها أربعة أيام، ثم نغادرها إلى نوى، وبعد يومين نترك نوى، وها أنا أجلس معكنَّ هنا. وما ثيابي التي تمكنت من حزمها إلا جزءٌ بسيط من “جهازي”، الذي لم يُعلَّق في خزانة، أو يُطوى في مكان الجمع والحفظ كما تقولين يا خالة ابتسام. أما عن أمنيتي…» تحمرّ غيداء وتُطرق رأسها في الأرض وتقول بصوت خجول: «أنتنَّ تعرفنَ ما أتمناه». تضحك النساء، وتقول أم مهند: «إنّه طلب حق»، ثم تقول إلهام لغيداء: «ما رأيك أن نخلي الخيمة اليوم لك ولمحمود؟». «لا سيكون أمراً محرجاً» تجيب غيداء، فتردّ ابتسام: «لا محرجاً ولا (مبطخاً) يا غيداء، في النزوح كل الأمور شوربة».
«وماذا عني أنا؟» تسألهنَّ روعة بعصبية: «أريدُ يوماً للإخلاء، لي ولزوجي»، وتشيح بنظرها عن والدتها التي رمقتها باستغراب وحدّة. تنفعل روعة في حديثها: «هل تعلمنَ أنني متزوجة منذ ما يقارب ثماني سنوات، وأستطيع أن أعدّ على أصابعي المرات التي نمت فيها مع زوجي! الحمد لله أن واحدة منها جعلتني أحمل».
تزوجت روعة في الرابع من آذار 2011، وسكنت في غرفة مخصصة لها في بيت أهل زوجها في مدينة درعا البلد. التحق زوجها بقطعته العسكرية في حمص بعد خمس عشر يوماً من زواجهما، وعندما فتحت باب بيت أهل زوجها لاستقبال أهلها في العشرين من آذار 2011، شاهدت أهلها مذهولين وخلفهم عشرات الرجال، يمشون في الشارع ويهتفون «حرية، حرية».
تقول روعة: «كان التاريخ الممتد من أواخر آذار وحتى أواخر أيار 2011، تاريخاً لحصار أطبقه جيش النظام على حي درعا البلد القابع فوق صفيح من نار، ولرصاص الأمن الذي كان يحصد أرواح المتظاهرين، ولرأسي الذي كان يدور لأسقط أرضاً واكتشف أنني حبلى. حصل حملي في نيسان، في الأسبوع الذي قضاه زوجي معنا. حينها منعه والده من الخروج من المنزل والمشاركة في أي مظاهرة، ثم أمره بأن يعود إلى قطعته العسكرية، وبأن لا يغادرها إلى هنا حتى تستقر الأمور. لم تستقر الأمور، بل ساءت وتفرقنا، فذهب أهل زوجي إلى مدينة إزرع، ورجعت أنا إلى منزل أهلي في الحراك في أواخر 2011. بقي زوجي في حمص، أراسله ويراسلني على الواتس، ثم تنقطع أخباره عني فجأة لمدة خمسة أشهر كاملة».
تتنفس روعة عميقاً وتقول: «كدت أقنع نفسي بأنني سأصبح أرملة صغيرة مع طفل رضيع، إلى أن رأيت زوجي، أشعثاً، منهاراً، واقفاً أمام بيت أهلي. أقسمَ بأنه لن يعود ثانية إلى حمص، ولم يعد فعلاً، لكنه لم يرجع إليَّ أيضاً، فقد غاب بعدها مع فصائل الجيش الحر حتى أرسلته إصابته البليغة في ساقه في أواخر 2013 إلى الأردن، ليمكث هناك ستة أشهر. عندما رجع، عشتُ أنا وهو وابني، مع أبي وأمي وأختي إلهام وأخوي الصغيرين وأخي الأكبر مهند، كلّنا في دار واحدة. لم يختلف الوضع كثيراً عنه عندما كنت أقطن مع زوجي في بيت حماي، عدا أن زوجي كان يشعر بالخجل وبأنه عالة على والدي. وكي نتجاوز شعوره ذاك، وجد زوجي عملاً في 2016، وبمساعدة الأهل والأصدقاء الكبيرة جداً، بدأنا ببناء منزل صغير على قطعة أرض ابتعناها بالقرب من دار أهلي. أحلم بطلائه الأبيض، وبأني أتجول فيه برداء شفاف. ما أحلى الحلم، وما أقذر الواقع، الذي يوقظني لا ليناولني مفتاح الدار التي قاربت أن تجهز، بل على صاروخ يبعثرها ويسرق الحلم ويطردني إليكنّ، لأطلب منكنّ…»، تضحك روعة ضحكة طويلة: «لأطلب منكن… الإخلاء يا حبّابات».
نتشارك الضحك مع روعة، ليس فرحاً، ولكن «شر البلية ما يضحك» على حد قول أم مهند، التي تنفض عن عباءتها التراب والرمل والسواد، وتقول: «والله أحلامكن مشلخة مثل قلبي»، فتمازحها روعة: «أم مهند، لا تخافي سندرج اسمك في جدول الإخلاء».
«سدي بوزك… أني ما بدي لا إخلاء ولا شي، بدي أتحمم وبس، وأشيل هالسخام عن جسمي، من أسبوعين بلا حمام» ثم تتأهب للوقوف وتسألني: «تروحي نقعد تحت شي شجرة، والله طقت روحي من الشوب»، فأومئ برأسي بالموافقة. كنتُ أريدُ الهروب، ليس من الحرارة التي لا ترحم، بل من إلحاح ابتسام وغيداء كي أتحدث عن حلمي. وأنا ما كنتُ أحجمُ عن تلبية طلبهنّ، إلا لأنني أحسستُ بأن رغبتي في قيادة دراجة نارية «ماتور» على الطريق الحربي الذي يصل غرب درعا بشرقها، أصغر وأتفه من أن يكون حلماً أحكي عنه، وفي الوقت نفسه أكبر بكثير من أن يتحقق يوماً ما.
UNHCR
يقف طفلا أم مهند الصغيران بجانب الخيمة الرمادية، الممهورة بشعار الأمم المتحدة، يسأل أحدهما الآخر: «ماذا تعني هذه العبارة؟ (ويشير إلى UNHCR المكتوبة بالأزرق على الخيمة)؟» فيرد الآخر: «يا أحمق، مكتوب تحتها ما تعني بالعربي»، ويبدأ الطفلان بتهجئة العبارة (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين). تعلن المفوضية إياها أن عدد النازحين في جنوب سوريا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة، تجاوز 270 ألفاً، وتستنكر الكارثة الانسانية. ثم تغلق ملفاتها الإحصائية، وتغرق استنكاراتها في البحر المتوسط قبل أن تصل إلى أروقة الامم المتحدة في جنيف، غير أن الأمر الحسن أن أحلام النساء يمكن أن تصير مادة يتم النصّ عليها لاحقاً في منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
لا تعلم أي واحدة مننا مصير خيمة أحلامنا الرمادية، فغيداء وزوجها عادا إلى بلدتهما الحراك قبل الجميع عندما دخلت البلدة في التسويات والمصالحات مع النظام والروس، ثم تلتها إلهام التي آثرت الذهاب إلى دمشق مع زوجها، بعد أن تلقّى وعداً من أحد ضباط النظام «الواصلين» بترتيب أموره الأمنية والقانونية. ثم غادرت ابتسام المخيم مع طفلها إلى نوى للتوقيع على أوراق المصالحة، فهي لا زالت تأمل بعودة زوجها المعتقل في أحد الأيام.
بقيتُ أنا وأم مهند وروعة في المخيم، حتى غادرنا الخيمة التي تركناها وراءنا منتصبة في ليلة من ليالي أواخر تموز 2018، متجهين مع مئات من النازحين الذين كانوا في المخيم إلى قرية القحطانية في مدينة القنيطرة، حيث ستنطلق قوافل التهجير إلى الشمال.