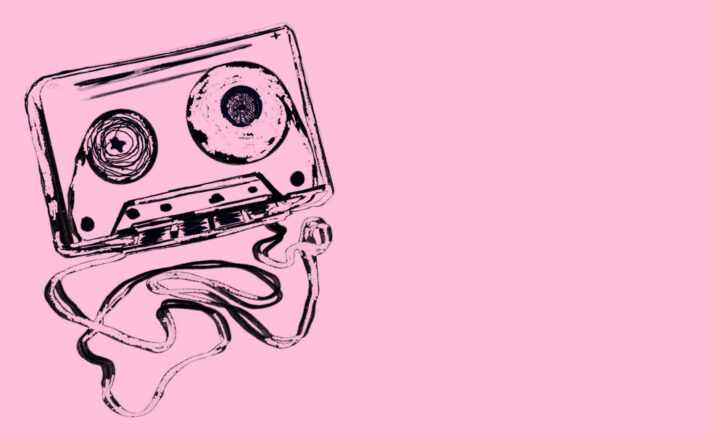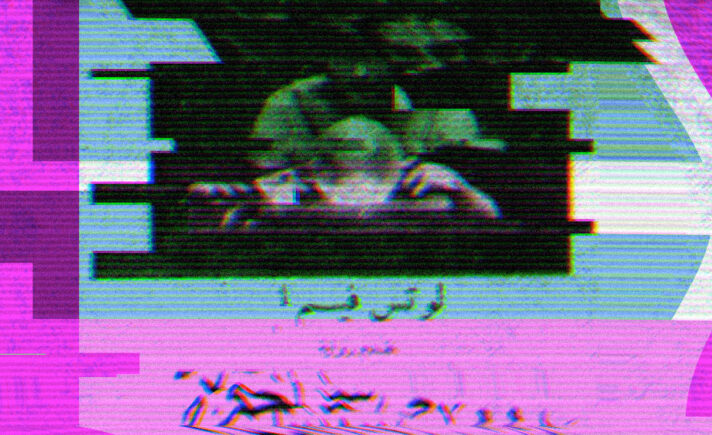كان نايل أكبر مني بسبع سنوات كاملة. وأعزُّ الولد ولدُ الولد، كما يقولون، وهو أول الأحفاد، وخصّت الجدة، بديعة، ابن خالتي هذا بكثير من القصص وكثير من الدموع أيضاً. هو ابنُ البِكرية، هيلانة، أكثر البنات الأربعة غُلباً، والتي لم تذهب المدرسة، ولم تتعلم لا القراءة ولا الكتابة، وعوّضت هذا بأن جلبت للعالم اثنا عشرَ ابناً، لا أعرف معظم أسمائهم، أكبرهم لم يذهب للمدرسة وأصغرهم حصل على شهادة الدكتوراه. ويعود سرّ هذا التفاوت، إلى إن هيلانة على جهلها الرسمي، كانت مثقفة جداً بفضل استماعها إلى الراديو، أربعة وعشرين ساعة في اليوم، حتى حين كانت تخلد للنوم، لم تكن تخفض صوت المذياع ولو درجة واحدة. ولم تكن تنصت سوى إلي البي بي سي، وأحياناً أقل، وفي الخريف خاصة، كانت يطربها الاستماع إلى مونت كارلو، وهي نفسها فشلت في أن تجد تفسيراً لتفضيلاتها الموسمية هذه. ولم تكن هيلانة مجرد مستمعة مخلصة، فلها آراء قوية بخصوص السياسة الدولية وكل شيء آخر، وتحتدُّ حين تعبّرُ عنها أمام الآخرين. فهي مثلاً، لا تزال ترى أن القبول بالصين في المجتمع الدولي كان خطأً فادحاً، وكانت تكرر في هذا الشأن جملاً رنانة جداً، وتقولها بالفصحى: «حكومة فرموزا هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصيني».
وتجرّأَ قريبٌ لنا، في مرة على القول أمامها إنه لم يعد اسمها فرموزا، وجنّ جنونها ساعتها. وانبرت في خطبة طويلة – لا علاقة لها بالأمر- عن تحدى حكومة بكين للشرعية الدولية. وكانت تصرخ فيمن حولها وهي ترفع سبابتها بالوعيد، وتقول: لا تايوان ولا ماكاو، فرموزا وحدها. وكان هذا واحداً من المشاهد التي كان يستمتع أهل القرية بمشاهدتها، بقدر تلذذهم نفسه حين تروى الجدة واحدة من قصصها. وكانتا هما الاثنتان دويتو ناجحاً إلى أقصى حد، بالرغم من الاختلاف الشاسع بينهما. فالجدة كانت ريفية وتتحدث كالريفيات من صعيد مصر، أما هيلانة فكانت تتحدث مثل رجل من يوركشاير، درس في أكسفورد، ويصوّتُ بإخلاص لحزب المحافظين أباً عن جد. ولم تُخفِ الخالة ميولها النيوليبرالية، فبالنسبة لها تاتشر هي أعظم سياسيّة أنجبتها البشرية. وكان تفسيرها لمقولتها تلك هو الأغرب على الإطلاق. فالست ميرجريت كما كانت تنطق اسمها بوقار شديد، اخترعت نوعاً من الآيس كريم، يمكن تصنيعه بماكينات صغيرة سهلة النقل والتركيب، وهكذا ساعدت أصحاب الدكاكين الصغيرة في أن يعتمدوا على أنفسهم، وينافسوا في السوق (والمدهش أنني اكتشفتُ لاحقاً أن تلك المعلومة شبه صحيحة). وهيلانة كانت امرأة أفعال لا أقوال، فهي اشترت واحدة من ماكينات الآيس كريم، التي ادعت أن تاتشر اخترعتها، ونصبتها أمام البيت، وكان تبيع منها لأولاد الجيران. وكان المشروع ناجحاً جداً، إلى أن بدأ أصحاب المحال في القرية واحداً وراء الآخر في شراء الماكينات، التي أصبح اسم شهرتها، الميرجريتة. بارَ مشروعُ هيلانة، لكن لم يمنعها هذا من أن تكون أكثر مؤيدي تاتشر في الصعيد الجواني، وربما مصر كلها، حين تعلّقَ الأمر بسياسة تمليك وحدات السكن الاجتماعي لمؤجريها، في بريطانيا، وإغلاق مناجم الفحم في شمال إنجلترا، وكذلك في حرب الفوكولاند. وذلك كله على خلاف الجدة التي كانت تمتلك وابوراً من صناعة الصين، وأخذت كذلك جانب الأرجنتين في الحرب، من باب الوفاء لأمريكا اللاتينية. فهي كانت تصرف لحماً برازيلياً مجمداً من الجمعية التعاونية مرة كل شهرين، و«العِشرة ما تهونش غير على ولاد الحرام». أما عن الإنجليز فهي لم تحبهم ولم تكرهم، وإن كانت لديها ضغينة خاصة تجاه مواشيهم، فهي كانت تقول إنهم في الحرب الكبرى كانوا يجمعون قوت الفلاحين لإطعام خيول الإنجليز، وماتت عالمٌ كثيرة من المجاعة.
وربما، بسبب تلك الاختلافات بين الجدة والخالة، فإن رواية كل واحدة منهما عن موت نايل، تركزت على جوانب بعينها منها، لأسباب إيديولوجيّة. فابنُ الخالة خرج ولم يعد، كما الجد، ولم يُعثَر على جثمانه أبداً. الجدة تقول إن الصحراء ابتلعته، أو إنه فقد عقله حين سمع صوت الانفجارات ورأى القتلى، فهامَ على وجهه وأكلته الوحوش. أما هيلانة، فتقول إنه فدى رفاق سلاحه، وإنه قفز أمامهم ليحميهم من دانةِ مدفعٍ كانت في طريقها إليهم، فتمزقت أشلاؤه ولم يجدوا شيئاً منها ليجمعوه. وهكذا ركزت الجدة على التراجيديا في موت الولد في حفر الباطن، أما الخالة، وككل أصحاب الدكاكين الصغيرة والمتوسطة، فكان ما يهمها هو حسّ الواجب، وموقف الشرعية الدولية من حرب تحرير الكويت، والأهم مبلغ التعويض التي تلقته من الجيش بعدها، والذي لم يكن قليلاً بحسابات تلك الأيام، ومُقارنةً بسعر الولد في السوق حينها.
وحقيقة الأمر، أن أياً من تلك التفاصيل لم تشغلني كثيراً، ومصير الولد الذي أخذوه من الدار للنار، في سن الثامنة عشر، لم يزعج أحداً. فالجميع كان لا زال مشغولاً بأخبار سعيدة عن إسقاط ديون مصر أو بعضها، وبسماع أغنية كويتية حزينة اسمها، «اللهم لا اعتراض»، وهي كانت أغنية جيدة فعلاً. لكن ما أثار اهتمامي في حكايات الجدة، عن نايل وملاحمه في الصحاري، هو تفصيلٌ صغير، كانت هي قد أسهبت في سرده مرات ومرات. فالولد كما تقول، كان معسكره بجانب معسكر الأمريكان، وهم أولاد عمومة للإنجليز كما كان تجزم الخالة، وتضحكنا. وفي معسكر الأمريكان كان هناك نساء شقراوات وجميلات وطيبات أيضاً، ويلبسن الزيّ المموه ويحملن السلاح. وفي الليل كانت الشقراوات يتسللنَ إلى خيام الجيران، ويبحثنَ عن نايل في الظلام، وحين يجدنه، كُنَّ يعطينه هدايا، بكَرَم، ويُجزلنَ عليه الأحضان والقبلات، وكان ذلك سبباً في غيرة رفاقه بالطبع وحسدهم. ولم يكن هناك سرٌّ كبيرٌ وراء هذا الانجذاب الغامض، فالشقراوات مع كل قبلة على خد الولد، كُنَّ يقلنَ له: «أنت مسيحي… خذ بسكوت» ثم يقمنَ بضمّه بمودة أخوية، ويُضفنَ إلى ذلك: «أنت مسيحي… خذ لبن»، «أنت مسيحي…خذ شكولاتة».
وكانت القصة تضحكني في كل مرة، ومعي كل من يسمع الجدة وهي تحاول أن تقلد صوت الأمريكان، فتنطق كلمة مسيحي، بضمّ الميم وقلبِ الحاء إلى هاء. وكانت ضحكاتنا تتملقها، فتبالغ في عوج لسانها، والتغنج والتلوي بعجزها وهي تكرر جمل الشقراوات. وبالرغم من أن أداء بديعة لم يكن متقناً بدرجة مقبولة، إلا أنني كنت طفلاً ساذجاً بما يكفي لأصدق أنه في اليوم الذي سيراني فيه الأمريكان أو أولاد عمومتهم من الإنجليز، فانهم سيأخذونني في الأحضان. وقضيتُ زمناً من طفولتي أحلم باليوم الذي سأصل فيه إلى أرض البسكوت والشكولاتة، أو تأتي فيه الشقراوات إلينا هنا.
إلا أن أفضل ما يميز حكايات الجدة أنها متناقضة، وينسخ فيها الجديدُ القديم، أو يتعايش معه، بلا أدنى أحساس بالندب أو داعٍ للاعتذار. وهذه سمات الإنتاج الغزير من الحكايات، وأصحاب السليقة الحاضرة، بأي حال. فحين عبر خالي طانيوس البحر إلي إيطاليا، انقلبت الجدة ضد الخواجات، بعض الشيء. فبحسب قصتها عنه، حين اقتربت المركب من الشاطئ، وألقى من فيها أنفسهم ليسبحوا إلى البرّ، كان طانيوس لا يحمل شيئاً معه سوى أيقونة ببرواز خشبي مُذهب لأم النور. كانت تحرسه في رحلته، ونجّته من الأخطار. لكن كان للأيقونة أغراض أخرى، فالخال وصل إلى مدينة ساحلية صغيرة لا يتقن من لغتها كلمة واحدة، ولا يعرف فيها أحداً، وكانت الأيقونة وسيلته الوحيدة للتواصل. فبعد أن حملته الأمواج إلى الأرض -ببركة العدرا- ووطئها بقدميه، انطلقَ هو في الجري، دون أن ينظر خلفه. وفي أقل من ربع ساعة وصل إلى وسط المدينة. وهناك قصد الخالُ أول شخص قابله في الميدان، وبيديه الاثنتين رفع الأيقونة في وجهه، مع ابتسامة كبيرة. وكان يشير بأصبعه إلى صورة العذراء ثم إلى نفسه. وبعد أن كرر الإشارة عدة مرات، وأضحى جلياً له أنها غير ذات معنى للشخص الآخر، رسم الصليب على صدره، وشمّرَ كمَّ قميصه المبتل وكشف عن الصليب الأخضر المدقوق على ذراعه، ورفعه أمام الرجل، ولكن دون ابتسامة هذه المرة. وزادت علامات العجب على وجه الخواجة، وأزاح طانيوس عن طريقه ببعض الخشونة وبعض الشفقة، ومضى إلى حاله.
إلا أن الخال لم ييأس، ولم يكن متاحاً له اليأس، فهو كان جوعاناً ومبتلاً وميتاً من التعب، فهرول بين شخص وآخر في الميدان، وكرَّرَ ما فعله سابقاً مرات كثيرة ومع أناس كثيرين. كان يجري في دوائر وهو يحمل الأيقونة فوق رأسه عالياً، وكأنه في مظاهرة. ولم يفهم أيٌّ من الناس ما الذي يفعله، وإن أعطته سيدة عجوز بعض الأمل، حين بدأت في رسم الصليب معه، وقبّلت الصورة. وأعطته بعدها عمله معدنية، لم يعرف قيمتها ولا كيف يمكنه أن يصرفها. وظل الحال على ما هو عليه، حتى دخل الليل، وافترش هو الأرض من التعب، ووضع الأيقونة أمامه، وألقي بعض المارة إليه بقليل من الفكّة، وعطف عليه طفلٌ صغيرٌ بنصف ساندويتشه بعد أن لاحظ نظراته الجائعة. وقبل منتصف الليل جاءت سيارة رسمية، وأخذته إلى كنيسة صغيرة، وابتهج هو لهذا أيما ابتهاج، وقدموا له هناك شوربة ساخنة، وملابس نظيفة، وسرير في غرفة مشتركة مع شخص آخر، وكان شاباً أفغانياً ودوداً. ولم ينم طانيوس لحظة واحدة ليلتها، وبكى بمرارة لم يبكِ بها في قبل، فهم وضعوه في حجرة واحدة مع مسلم، وعاملوه مثل المسلمين، ولم يحزنه شيء أكثر من هذا في حياته.
ولا تعرف بديعة أبعد من هذه عن طانيوس، ولكن للقصة تكملة بالتأكيد. فبعد سنوات كثيرة، جاء خالي إلى لندن لزيارتي. حضر ليرى بعينيه إن كان لي حقاً كرسيٌ أجلس عليه في العمل كما أدعي أم لا، وحين ثبت له صدقي، فتح قلبه وحكي لي حكايته. فلم يكن كل الإيطاليين غير مبالين بأيقونته، وحين حصل على وظيفته الأولى، في مصنع الصلب، عطف عليه بعض زملائه، ودعوه إلى نادي اسمه نادي الكتاب. وأفهموه أن الأيقونة التي يحملها معه إلى العمل كل يوم، ويحتضنها طوال راحة الغذاء، لن تنفعه هناك. فهذه بلد فيها أيقونات أكثر من اللازم، والناس قد ملّت منها ومن أصحابها، وأن الأجدر به، أن يحطمها في العلن، وهذا سيجلب له كثيراً من الأصدقاء. وهو بالطبع لم يكن ليفعل هذا، فالخال لم يقطع كل هذا الطريق ويخاطر كل هذه المخاطرة، كي يأتي إلى أوروبا لينكر إيمانه. فأي جنون هذا! اكتفى طانيوس بوضع أيقونته جانباً، وأحبه لذلك رفاقه الجدد. وعلموه القراءة والكتابة بلغتهم، وأعطوه كُتباً ليقرأها. وشرب معهم البيرة في أمسيات الجمعة، ورقص مع بناتهم في ليالي السبت. وحين وصل إلى هذه النقطة من حكايته، همس لي ببعض الخجل: «كانوا شيوعيين، والشيوعيين طيبين وبيحبوا الأجانب». هو لم يصبح شيوعياً، وهم لم يطلبوا منه ذلك أبداً. لكن حين حدث الإضراب الكبير في ميلانو، في وقت ما في أول الثمانينات، كان عليه أن يقف إلى جانب رفاقه. وأوكلت له مهمة تبدو بسيطة لكنها خطرة، فهو وقف على أحد مداخل المصنع، وفي يده قضيب معدني ثقيل، كي يمنع أي شخص من الدخول. ومرَّ اليوم الأول على خير، لكن في اليوم الثاني أحضر أصحاب المصنع عمالاً من خارج المدينة، ليحلوا مكان العمال المضربين. وحصلت عركة كبيرة على البوابات. وفار الدم في عروق الخال، وكان لا زال شاباً عفيّاً، وبطح بقضيبه رأس واحدٍ منهم، وشجّها، فسقط الرجل من طوله. وحين رأي طانيوس الدم على يديه وعلى ملابسه، ألقي بقضيبه، وجرى بأقصى ما يمكنه.
يقول إنه جرى ثلاثة أيام بلا توقف، وحين تملّكه التعب، وجلس ليلتقط أنفاسه، كان الإضراب قد انتهى، واختفى الشيوعيون من المدينة والبلد كلها. ووجد الخال بعدها وظيفة في مطعم تملكه طليقةُ رجل شهير، اسمه بيرلسكوني. وهو لديه صورةٌ مع الزوجين، قبل طلاقهما، يعتزّ بها جداً.