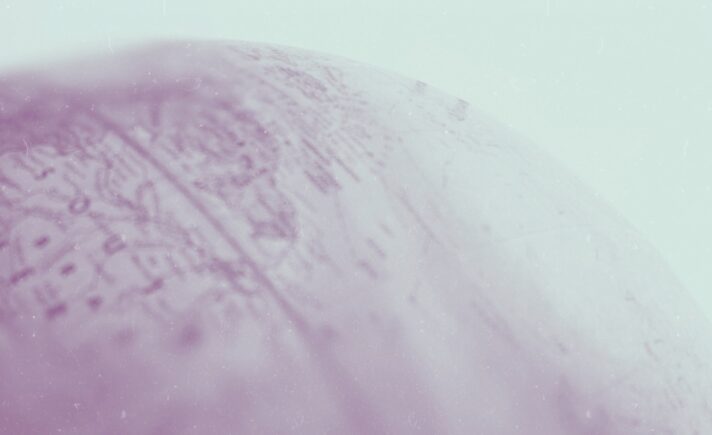عشية الحرب العالمية الأولى، كان يعيش على أراضي الإمبراطورية العثمانية حوالي مليوني أرمني. وفي ربيع 1915 اتخذت الدولة العثمانية عدداً من الإجراءات ضد رعاياها الأرمن، فلم يبقَ في نهاية الحرب سوى جزء صغير منهم. يمكننا حالياً أن نقول بشكل تقريبي إنه لا يوجد أرمنٌ في الداخل الأناضولي. وتوجِزُ هذه الأرقام الفجّة تاريخ الإبادة الجماعية المعقدة للأرمن. ستقدِّمُ هذه المقالة عرضاً للإبادة التي وقعت عام 1915، وتجادل بأنها لم تكن ظاهرة أحادية، وإنما كانت عمليةً متعددةَ الأوجه.
يمكن النظر إلى إبادة الأرمن العثمانيين على أنها نتيجةٌ معقدةٌ لثلاثة عوامل: الهزيمة العسكرية وخسارة الأقاليم في البلقان في 1912 -1913، والانقلاب الذي قامت به «تركيا الفتاة» في 23 كانون الثاني 1913، واندلاع الحرب العالمية الأولى.
الأسباب: الهزيمة، الانقلاب، الديكتاتورية والحرب.
بعد نشوء الدول القومية الحديثة في الأقاليم التي خسرتها الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، لم تعد الحقوق المدنية مضمونة للمسلمين الذين ظلّوا تحت حكم رعاياهم السابقين. لم يكن العنف واضطهاد المسلمين أمرين غريبين في اليونان وبلغاريا. كما ساءت أوضاع المسلمين في جنوب شرقي أوروبا بشكل جذري. وفي تشرين الأول 1912 أعلنت كلّ من صربيا والجبل الأسود واليونان وبلغاريا الحرب على الدولة العثمانية، لاستيائهم من حكمها ورغبة منهم بالتوسّع على الأرض. وقد خاضت الدولة العثمانية الضعيفة والمحبطة وغير المستعدة أربعة عشر معركة، وخسرتها جميعها ماعدا واحدة. واضطر الجيش العثماني، جرّاء تقدم البلغار في تشرين الثاني، للتقهقر نحو خنادق تشاتالكا التي تبعد ثلاثين كيلومتراً عن الأستانة. ثم نجح هناك في صدّ الغزو والحفاظ على عاصمة الإمبراطورية. بيد أن المعارك لم تتوقف، وسقطت مدينتان عثمانيتان مهمتان وهما: أدرنة عاصمة الإمبراطورية القديمة، التي حاصرها البلغار واستولوا عليها، وسالونيك المحمية العثمانية ومهد «تركيا الفتاة» التي هزمها الجيش اليوناني في 9 تشرين الثاني 1912. استمرّت حالة الحرب إلى أن تمّ التصديق على معاهدة لندن في 30 أيار 1913، التي عُنيت بالتعديلات الإقليمية وفق نتائج الحرب. بعد وقف الأعمال العدائية، صارت الإمبراطورية مبتورةً إلى الأبد.
وهكذا فإن الحرب أحدثت رضوضاً جسيمة في المجتمع العثماني. ولم يكن ضياع المدن العثمانية الأساسية والممتلكات والحياة الخاصة أموراً تحتملها النخبة العثمانية المغرورة والمرعوبة من عجز جيشها. وقد تركت صدمة الحرب ندبات عميقة في المجتمع والثقافة والهوية العثمانية. واعتباراً من 1913 لم يعد واقعياً أن يعتمد القوميون المتشددون على إحساسهم بهيمنة الهوية العثمانية، فبالنسبة لهم صارت الحرب تجسيداً لأسطورة «الخنجر في الظهر» الذي غرزه المسيحيون العثمانيون.
مارسَ هذا الارتياب تأثيره على سياسات رفيعة المستوى، وسادَ جوٌّ متوترٌ بين المجموعات السياسية المختلفة. كما نفّذت «تركيا الفتاة» المنضوية تحت جمعية الاتحاد والترقي عمليات تحريضية، وجّهت من خلالها الاتهامات وقذفت بالشتائم وهددت وتوعدت العثمانيين البلغار واليونانيين والأرمن، وشكَّكَت بولائهم للدولة. الهزيمة في حرب البلقان استقطبت المجتمع العثماني وفق التقسيمات الإثنية والدينية.
وجاءت نقطة التحول الحقيقية في سياسات تلك المرحلة مع الانقلاب الذي قامت به «تركيا الفتاة». وقد كانت القيادة العثمانية العليا في 22 كانون الثاني 1913 تجري مفاوضات أدت إلى استسلام غير مشروط لمدينة أدرنة المحاصرة من قبل البلغار، والتي كانت بأمس الحاجة للإغاثة. أثارت هذه المفاوضات حفيظة جمعية الاتحاد والترقي، فجعلت فصيلاً من المتشددين يقتحمون «الباب العالي» أثناء اجتماع مجلس الوزراء. وقد ضمّ هذا الفصيل كلّاً من طلعت باشا وأنور باشا، والطبيبين بهاء الدين شاكر إلى جانب محمد ناظم، وخطيب الحزب عمر ناجي، وعدداً من العسكريين غير النظاميين، من بينهم الفدائي سريع الغضب يعقوب جميل.
وعند ظهيرة يوم 23 كانون الثاني 1913، سقط مبنى المحكمة على يد ستين رجلاً مسلحاً. ركلوا الباب وفتحوا النار على أول من اعترض طريقهم وهم: سكرتير رئيس الوزراء أوهريلي نافز، وسكرتير وزير الحرب ك. توفيق بيك، ومفوض الشرطة جلال بيك. عند سماع إطلاق النار هرب الوزراء من المبنى. وفي محاولة منه لتسوية الوضع ظهر وزير الحربية ناظم باشا على الشرفة صائحاً بالمهاجمين: «ماذا هنالك؟»، وهنا صوَّبَ يعقوب جميل نحوه وأرداه أرضاً بطلقة في الجبين. في تلك الأثناء وصل أنور باشا إلى صالة الاجتماع المركزية، ووضع مسدسه على رأس رئيس الوزراء: إما الاستقالة أو الموت! اختار كمال باشا، البالغ من العمر ثمانين عاماً، أن يقدم استقالته للسلطان، وتسلّمت جمعية الاتحاد والترقي زمام السلطة. في الخارج كان المهاجمون يصرخون: «عاش الشعب! عاشت جمعية الاتحاد والترقي!»
من الصعب المبالغة بأهمية انقلاب جمعية الاتحاد والترقي، فهي لم تصل سدّة الحكم عن طريق الانتخابات، وقد مارست ديكتاتورية وحشية عبر انقلاب دموي: أسكتت البرلمان العثماني، ونصّبت أصدقاءها والموالين لها في مراكز السلطة، وأرهبت المعارضة وحطمتها. وُلِد نظام الحكم أثناء حرب ضارية، مما أدى إلى انحسار الحدود التقليدية لاستخدام القوة من قبل الدولة. وقد سهَّلَ الانقلاب تكثيف السلطة، ومهَّدَ الطريق أمام محاولات «تركيا الفتاة» لتحويل المجتمع العثماني المتعدد الإثنيات إلى دولة تركية مسلمة بحتة. كما أثارت الثورة مخاوف اندلاع ثورة مضادة، مما أدى إلى حالة طوارئ دائمة وتكثيف أكبر للسلطة. وخلال فترة حكمها حاولت «تركيا الفتاة» تفادي الأزمة السياسية المستمرة عبر استخدام العنف ضد فئات من المواطنين. وبما أن نظامها لم يتمتع بدعم شعبي واسع، أصبح العنف أداة حكم طبيعية.
في الشهور الأولى التي أعقبت الانقلاب، تمكنت جمعية الاتحاد والترقي من بسط ديكتاتوريتها على الإمبراطورية تدريجاً. أعادَ أنور باشا غزو أدرنة، ورفَّعَ نفسه إلى رتبة جنرال وأصبح وزيراً للحربية. وتسلّم طلعت باشا رعاية مجلس الوزراء الجديد، ونُصِّب وزيراً للداخلية بعد أن كان رئيساً للحزب. شيئاً فشيئاً ازداد تشنج الأجواء السياسية في الأستانة وبات العنف السياسي أمراً مألوفاً، حيث نُفِّذت الاغتيالات من قبل عصابات شبه عسكرية مقربة من طلعت باشا وأنور باشا على وجه الخصوص. ولقد شَهِد ناشر صحيفة مهمة، حسين شاهيت (1875- 1957)، على مقتل رجل أمام عيني أنور باشا ومن قِبل أحد رجالاته، لمجرد أنه عبّر عن اعتراضه
«بالنسبة لهم السياسة هي أكثر بكثير من مجرد لعبة. ولقد أمعنوا في التمسك بالسلطة منذ استلامهم إياها، وأظهروا استعدادهم لاستخدام كل الوسائل في سبيلها. لقد أصبح الاضطهاد والعنف من الأمور العادية. لا شيء مقدس في السعي نحو السلطة، لذا كان يتعين على هؤلاء المتهمين بالمعارضة أن يجهزوا أنفسهم لدفع الثمن بحياتهم»
Feroz Ahmad, The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics (Oxford: Oxford University Press, 1969), p. 163. .
أضحت السلطة في يد عسكريين غير نظاميين، تعودوا على حياة الخارجين عن القانون. وأضفت ظروفٌ أشبه بالحرب الأهلية صفةَ الشرعية عليهم، فانتقلت فوضى العنف إلى السياسة في الأناضول، وتمكنوا من غرس تجارب معاركهم البلقانية غير النظامية في الحكومة العثمانية.
وكخاتمة العوامل المحرّضة على الإبادة، احتلَّت الحرب العالمية الأولى مكانة هامة، إذ كانت الحرب بالنسبة للأرمن العثمانيين تطوراً كارثياً وغير متوقع في الوقت نفسه. في 2 آب 1914، أي بعد يوم واحد من إعلان ألمانيا الحرب على روسيا، تمّ توقيع اتفاقية تنصّ على التعبئة والتعاون الوثيق بين الدولة العثمانية وألمانيا. ومن دون إعلان رسمي للحرب، أمرَ أنور باشا في 29 تشرين الثاني 1914 الأسطول العثماني بقصف الساحل الروسي، بما فيه ميناء سيباستوبول. وهكذا حطّمت سفن حربية عثمانية صهاريج تخزين النفط، وأغرقت أربعة عشر برميلاً
لم تكن الحرب العالمية الأولى حدثاً أصاب الدولة العثمانية بالصدفة، إذ أن الكوادر النافذة في الجناح القومي التابع لجمعية الاتحاد والترقي، هي التي سعت عمداً إلى مجابهة مسلحة، وإن لم تكن موجهة نحو دولة بعينها. ووفقاً لدراسة حديثة، كان دخول جمعية الاتحاد والترقي الحرب جزءاً من استراتيجية لتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي على المدى البعيد، والتعافي القومي في آخر المطاف
لم يعزُ أنور باشا هزائمه لعدم كفاءته، وإنما لخيانة الأرمن. فصار هؤلاء كبش الفداء اعتباراً من كانون الثاني 1915، وصارت الدعاية التركية القومية تصفهم بالـ«خونة» وتنادي بمقاطعة تجارتهم وتنشر قصص الرعب حول جرائم مزعومة قام بها نشطاء أرمن. وهكذا أُغلِقت الجرائد الأرمنية، وتمّ القبض على شخصيات أرمنية بارزة. واعتباراً من اليوم الأول للحرب، اشتدَّت سطوة «تركيا الفتاة»، وازداد اضطهاد الأرمن مع تطور عنف الحرب وتعذّرِ الأمل. وهكذا أطلقت الهزيمة موجة اضطهاد عارمة، وبالأخص في الأقاليم الشرقية
الإبادة الأرمنية كعملية معقدة
هذه العوامل السياسية الثلاثة (خسائر حرب البلقان، انقلاب جمعية الاتحاد والترقي، واندلاع الحرب العالمية الأولى) أدَّت إلى استقطاب حاد لسياسات معادية للأرمن من قبل النخبة السياسية التابعة لـ«تركيا الفتاة». تمخَّضَت هذه السياسات عن سلسلة من المسارات المتداخلة، أنتجت بدورها عملية إبادة مقصودة ومتماسكة. هذه المسارات هي: إعدامات جماعية للنخبة، وعمليات تهجير وإدماج قسري، إلى جانب سياسة التجويع وتحطيم الإرث الثقافي.
التخلّص من النخبة
العماد الأول للإبادة هو قطع رأس المجتمع الأرمني، من خلال إعدامات جماعية للنخبة الاقتصادية والدينية والسياسية والفكرية. المجزرة التي وقعت يوم 24 نيسان 1915 أثناء لقاء لمّ شمل النخبة الأرمنية في الأستانة، صارت مع الوقت بوصلة لعمليات اعتقال النخبة الأرمنية في كل أرجاء الدولة. وكان كافة المعتقلين تقريباً رجالاً في منتصف العمر، أو شخصيات بارزة في عمر متقدم. وبعد اعتقالهم، وغالباً تعذيبهم، جرت في النهاية تصفيتهم. على سبيل المثال، في مدينتي بدليس وهاربوت تم اعتقال جميع الأرمن البارزين، وترحيلهم إلى الضواحي لقتلهم ورمي جثثهم في خنادق أُعِدت مسبقاً لذلك الغرض.
وفيما يلي مثال موثّق عن مجزرة جماعية للنخبة الأرمنية وقعت في مدينة ديار بكر الجنوب شرقية. في يوم الأحد 30 أيار1915 ساقت المليشيات 636 رجلاً مكبلاً من أعيان الأرمن، من بينهم الأسقف، إلى نهر دجلة. وعند الوصول إلى الضفة نقلوهم إلى عوّامات ضخمة بحجة ترحيلهم إلى الجنوب، وأوصلت المليشيات العوّامات إلى ممر ضيق بين الجبال وأرستها هناك. قُسِّم الأرمن بعد ذلك على مجموعات، كلّ واحدة من ستة رجال. ومن ثم سُلبت أموالهم وأُجبروا على نزع ملابسهم وتسليم أشيائهم الثمينة، تمهيداً لذبحهم من قبل رجال جَنَّدَهم حاكم الإقليم. استخدم الفاعلون الفؤوس والخناجر والبنادق، وتخلصوا من الجثث بإلقائها في النهر.
جَرَت إبادة النخبة الأرمنية بسرعة مذهلة، إذ تمّ القضاء على مجمل الطبقة العليا خلال بضعة أسابيع فقط
التجريد من الملكية
العماد الثاني للإبادة هو التجريد من الملكية. كانت الإبادة الأرمنية إحدى أكبر عمليات نقل رأس المال في العصر الحديث. إذ بموازاة أوامر التهجير، أصدرت «تركيا الفتاة» عدة قرارات بخصوص ممتلكات الأرمن اشترطت فيها تجريدهم من تجارتهم ومهنهم. وفي 10 حزيران 1915 شكلت الحكومة «لجنة الممتلكات المتروكة»، وكلَّفَتها بتنفيذ أوامر التجريد. كان هذا هجوماً كاسحاً على الاقتصاد الأرمني، الذي تمّت مصادرته رسمياً من قبل الدولة.
في 26 أيلول 1915 أصدر النظام قراراً إضافياً أحال مهمة تنفيذ المصادرات وتسجيلها إلى كل من وزارة الداخلية والعدل والمالية. عبر هذه القرارات، سَلَبَت «تركيا الفتاة» اقتصاداً ضخماً يضمّ المنازل والمزارع والمتاجر والمصانع والورشات والاستديوهات… إلخ. ومن خلال دراسة أوراق طلعت باشا الخاصة تبين بأن عدد المباني المصادرة وصل إلى 41.117 مبنى. حيث قامت «لجنة الممتلكات المتروكة» بتصفية كل ممتلكات الأرمن وبيعها للأتراك بأقل من سعر السوق. وقد نجم عن ذلك إفقار جماعي للضحايا الأرمن. وماعدا النتائج الموضوعية للحرمان المادي، كان حجم الخسارة الذاتية غير مسبوق. الحِرَفيون الذين تعلموا من أجدادهم حِرَفَ الصياغة أو النجارة أو الخياطة أو الحدادة، لم يفقدوا أسباب عيشهم فحسب وإنما هويتهم المهنيّة أيضاً. ويُعدُّ زلدجيان الأرمني وصانع آلات القرع المشهور، مثالاً على جيل من العوائل الحِرِفية المعروفة
التهجير
العماد الثالث للإبادة هو التهجير الشامل للسكان الأرمن المدنيين. في نيسان 1915 جرى ترحيل بعض الأرمن عن ديارهم، غير أن الحملة القومية لم تكن قد بدأت بعد. في 23 أيار 1915 أصدرَ طلعت باشا قراراً بتهجير شامل لجميع السكان الأرمن، وكان قراره الخطوة الأولى على طريق تهجير الأرمن إلى البادية السورية غير المضيافة، فأول أعمال التهجير كانت باتجاه الولايات الشمال شرقية منها. وقد حاول طلعت باشا التمويه على التهجير كإجراء رسمي، فصاغ «قانون الترحيل المؤقت». ومع أن أعمال التهجير كانت قد بدأت، إلا أن القانون تمّ تصديقه في 29 أيار. وقد مُنِح الجيش صلاحيات كبيرة لتنظيم التهجير، بيد أن الإدارة اليومية كانت بيد «مديرية إسكان العشائر والمهجّرين». أما طلعت باشا، فكان يشرف على العملية عبر مراسلات التلغراف ومساعدة الموظفين المحليين
شمل التهجير كل أرجاء المعمورة العثمانية، أي منطقة تعادل بحجمها حالياً تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل/فلسطين والعراق. وقد وقعت أشدُّ الأحداث ضراوة في ثماني ولايات شرقية، حيث يقطن عددٌ لا بأس به من الأرمن وهي: أرضروم، وان، طرابزون، سيواس، معمورة العزيز، أضنة، ديار بكر وحلب. ولم تزدهر الإبادة بالتساوي في كل هذه الولايات، لأنه كان هناك اختلاف في كثافتها وتطورها. حاول بعض الحكام المعتدلين عرقلة عملية الاضطهاد، من بينهم جلال بيك في قونيا وحسن مظهر بيك في أنقرة ورحمي بيك في أزمير. بينما كَثَّف بعضهم وتيرة الإبادة، من بينهم مصطفى عبد الحق رندا في بدليس وجمال عزمي بيك في طرابزون ومحمد رشيد في ديار بكر. في الولايات الأولى عومل الأرمن بطريقة أقلّ وحشية، فتمكنوا من الهروب أكثر من غيرهم. في الولايات الأخيرة كان القانون هو الفناء الشامل
وبالفعل حلَّ الوهن بقافلة أرضروم قبل أن تصل حدود الولاية، وبالقرب من مدينة كيما ذبح الدرك ما تبقى من المهجّرين وألقوهم في نهر الفرات. ولم يتجاوز عدد أرمن أرضروم، الذين وصلوا بالفعل إلى دير الزور، المئتين. هذا يعني أن نسبة الإبادة هي 99.3 بالمئة
الإدماج القسري
العماد الرابع لعملية إبادة الأرمن العثمانيين هو التنازل الإجباري عن هويتهم القومية، إذ أُجْبِر النساء والأطفال على التخلي عن المسيحية واللغة الأرمنية واعتناق الإسلام والتكلم بالتركية. كان هذا جزءاً من هجوم أكبر على الثقافة الأرمنية. وبالرغم من أن طلعت باشا رَحَّل الأرمن الذين تحولوا إلى الإسلام بعد فترة، إلا أن عدداً كبيراً من النساء والأطفال تم خطفهم وإجبارهم على تغيير دينهم. وقد جرى توزيع بعض الأطفال على دور الأيتام في بعض المدن، مثل قونيا وبيروت، حيث تلقوا تعليماً تركياً وإسلامياً بغرض تحويلهم إلى أتراك. كثيرون هم الذين نسوا عائلتهم وهويتهم الأرمنية فعلاً. ردود فعل الأرمن على سياسة التطبيع كانت متناقضة، وتتراوح بين إذعان خائف ومعارضة لا تتزعزع. هنري فارتانيان، أرمني من سيباس، قُتِل والده وأُجبر بعد ذلك على اعتناق الإسلام. طلب أحد معارفه الأتراك أن يتخلى عن المسيحية وينطق بالشهادتين: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله». وقد تمت طقوس إشهار الإسلام تحت إشراف إمام، حيث جرى ختن هنري الصغير وإعطائه اسم عبد الرحمن أوغلو إيساد
سياسة التجويع
من أشكال الإبادة أيضاً اصطناع مناطق يعمُّ فيها الجوع. ويجب الاعتراف بأن هذا الجانب من الإبادة لم تجرِ دراسته بشكل وافٍ. ففي شتاء 1915 تحولت المدينة الصحراوية، دير الزور، إلى معسكر اعتقال مكشوف من جراء وصول قوافل التهجير. لم يكن هناك مؤن كافية عند وصولهم البادية السورية، فاندلعت المجاعة في الشهور الأولى من عام 1916. نقص الغذاء كان إذن «جريمة بالامتناع»، [أي نتيجة تقصير السلطات المحلية في استباق المشكلة وتفادي نتائجها]. بيد أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن سلطات «تركيا الفتاة» المحلية قامت باتخاذ إجراءات واضحة ضد الأرمن المهجّرين، عبر خلق تراتبية إثنية لاستلام الطعام: لم يتم توزيع الخبز المتوفر في المدينة بالتساوي وحُرِم الأرمن منه، مما أدى إلى تفاقم المجاعة وموت عدد أكبر بكثير. أي أن نقص الغذاء صار أيضاً «جريمة مرتكبة»
تدمير الإرث الثقافي
أحد آخر أشكال الإبادة هو تحطيم الإرث الثقافي. فقد أرادت «تركيا الفتاة» محوَ الآثار الثقافية للوجود الأرمني على الأرض، عبر تدمير الكنائس والمباني ونقوشها الأرمنية. بالرغم من اختفاء الأرمن، إلا أنهم كانوا حاضرين بشكل من الأشكال. وإلى جانب الكنائس والكاتدرائيات الأقل عراقة، قامت «تركيا الفتاة» بتحطيم أديرة أرمنية ترجع إلى القرون الوسطى، مثل: ناركافانك، فاراكافانك، أركيلوتس فانك، سورب غربيت وسورب خاش. ولم يتبق اليوم سوى آثار قليلة لمراكز حياة الأرمن الثقافية والدينية، في حين كان هناك 2600 كنيسة و450 دير و200 مدرسة في عام 1914، مما يدلُّ على حجم الإمحاء. الفتك بالفن المعماري له هدفان: أولاً الإيحاء بأن الضحايا لم يكونوا موجودين أصلاً، وثانياً ألا يبقى شيء يعود الناجون إليه
المنفذون والضحايا
منفذو الإبادة الأرمنية كانوا عثمانيين أتراك وأكراد وقوقازيين (شركس وشيشان)، وقد كانوا متعلمين أو عمّال طبقة وسطى أو أميّين عاطلين عن العمل. أما الرأس المدبر لعمليات الإبادة فهو طلعت باشا رئيس جمعية الاتحاد والترقي ووزير الداخلية، الذي نظّم حملة دعاية رسمية موجهة للشعب والعالم الخارجي، إلى جانب حفاظه على أجندة سرية بأسلوب ونوايا مغايرة. وقد حاول طلعت باشا تبرير الإبادة عبر اتهام الأرمن العثمانيين بالخيانة والتعطيل والغدر، ففي عام 1916 كان في حوزته كتاب صدر بأربع لغات (الألمانية والتركية والفرنسية والإنكليزية) بعنوان: تطلعات وحركات ثورية أرمنية. يحتوي الكتاب على صور مزيّفة لأرمن «إرهابيين» في كل مدينة من الدولة العثمانية. كلّ الصور متشابهة: شرطيٌ عثماني وعسكريان غير نظاميين تابعين لـ «تركيا الفتاة»، يقفون خلف مجموعة من المعتقلين الأرمن الراكعين أمام صناديق فيها أسلحة ومتفجرات «مصادرة». إلى جانب الصور كُتِب التعليق نفسه: «اعتقال ثوار أرمن مع أسلحتهم». هذه الأكاذيب المدعومة من قبل شعبة الدعاية الحربية الألمانية كانت ذات تأثير كبير، وما زالت منتشرة على صعيد واسع حتى الآن وهناك من يصدقها.
دوافع طلعت باشا الحقيقية كانت مزيجاً من الهموم الإيديولوجية والبراغماتية والمصالح المادية والمعنوية. ففي حديث سرّي مع القنصل الألماني اعترفَ طلعت باشا بأنه يرغب باستثمار الحرب العالمية الأولى لـ «الانتقام الكامل» من الأعداء الداخليين، دون تدخل الدبلوماسيين الأجانب وازعاجاتهم. ولقد كان أكثر صراحة أثناء حديثه مع سفير الولايات المتحدة، هنري مورجنتو. ففي يوم من الأيام استدعى طلعت باشا السفير وقال له:
«طلبتُ منكَ أن تأتي اليوم لأشرح موقفنا من موضوع الأرمن. اعتراضاتنا على الأرمن مبنية على ثلاثة أسس. الأول هو أنهم عملوا على إثراء أنفسهم على حساب الأتراك. والثاني هو أنهم عازمون على بسط سيطرتهم علينا لترسيخ أسس دولة منفصلة. والثالث هو أنهم حرّضوا أعداءنا علانية. وقد ساعدوا الروس في القوقاز، وهزيمتنا سببها أفعالهم. لذا وصلنا إلى القرار النهائي بأن نجعلهم عاجزين قبل نهاية هذه الحرب»
Henry Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story (Princeton, N.J.: Gomidas Institute, 2000), pp. 224–5. .
لا يترك طلعت باشا في مراسلاته الداخلية السرّية أي ذرة من الشك بأن هدف الإبادة هو «تتريك» الأناضول، عبر التخلص من سكانها الأرمن. وإبّان عملية الإبادة، كان طلعت باشا على تواصل مع الإداريين المحليين، وأشرف بنفسه على الإبادة.
أهمّ المنفذين الداخليين للإبادة والمتفرجين عليها هم من الأتراك والأكراد، الذين ضلِعوا في دور التعاون والمقاومة على حد السواء. وقد نجم التعاون مع مشروع الإبادة، بالنسبة للأكراد على وجه الخصوص، عن عملية التحريض والإكراه والانتهازية عند بعضهم. ولم تلعب الإيديولوجية عملياً أي دور، لأنه من مصلحة الأكراد القوميين أن يقفوا مع الأرمن ضد عدوهم المشترك القومية التركية. لا بدَّ إذن أن الانتهازية لعبت دوراً في قبول التعاون. وقد قدمت جمعية الاتحاد والترقي رشاوى للمتفرجين ليدلوا بمعلومات عن الأرمن المختفين، أو ليخدموا كدليل في المدن الغريبة. بالكاد كان للكراهية الدينية بين الأكراد والأرمن أي دور على مستوى النخبة، إذ كان معروفاً عن الشيوخ الأكراد رفضهم للمجازر. ربما آمن هؤلاء الرجال المحافظين والورعين بدونية المسيحيين، ولكن ليس بضرورة إبادتهم. من ناحية أخرى، عيّنت الدولة أئمة وشيوخاً ليحرّضوا المسلمين العاديين على الأرمن من خلال خطاب شبه إسلامي، مفاده بأن الشخص الذي يقتل أرمنياً سيُكافأ بالجنة. وهكذا سَمَحَ كثيرٌ من الفلاحين الأميّين والمؤمنين البسطاء لأنفسهم بأن يُخدَعوا بخطابات الكراهية المستوحاة من الدين
أما بالنسبة للضحايا، فقد كان بإمكانهم الإفلات من الإبادة بأربعة طرق: الرشوة والتخفيّ والهرب والحظ. أولاً، كانت الرشوة إحدى الطرق لتأجيل التهجير أو التملص من الاستغلال أو شراء بقية العمر. كان فاهرام دادريان (1900- 1948) ابن أربعة عشر عاماً عندما هُجّر عن أقليم أنقرة. يصِف فاهرام في مذكراته كيف أنقذت الرشاوي عائلته مرة بعد مرة خلال رحلتها الطويلة إلى دير الزور، وعند الوصول إلى سوريا باتت عائلة دادريان مُعدمة
وتجلى الخيار الثاني في المخاطرة والتخفيّ بانتظار توقف الملاحقات. وقد نجا كثيرون من الإبادة ضمن ظروف صعبة جداً، حيث تمّ العثور على بعضهم إثر وشاية فقُتِلوا. كما كان التخفي يشكل خطراً على الأشخاص الذين يمدون يد المساعدة لهم، فالتعليمات الوطنية التي وزعتها الحكومة كان مفادها بأن «كل مسلم يحمي أرمنياً سيُعدم أمام منزله ويحرق ذلك المنزل»
ثالثاً، تمكن قرابة 130.000 أرمني من اللجوء إلى روسيا وبلاد فارس. من بينهم الرسام التعبيري أرشيل غوركي (1904-1948)، الذي هرب مع أمه إلى روسيا ومن ثم إلى الولايات المتحدة. هؤلاء الذين لم يهربوا، هُجِّروا و/أو قُتِلوا. بعد آذار 1915 لم يعد الهروب ممكناً.
ربما كانت أهمّ وسيلة للنجاة هي الحظ. عدد من المثقفين الأرمن البارزين نجوا من الإبادة الجماعية عن طريق الصدفة، ومن ضمنهم آرام أندونيان (1875-1952) وميشيل شامتانجان (1874-1926). وعلى سبيل المثال أيضاً، نجا يرفانت أوديان (1869-1926)، محرر الجريدة الليبرالية زاماناغ، لأن الشرطي التركي في دير الزور لم يفهم وثيقة تهجيره فأعاده إلى الأناضول
في نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت قد أفرِغَت حوالي ثلاثة آلاف منطقة مأهولة بالأرمن (قرى ومدن ومناطق) من ناسها وقتِل سكانها. وباستثناء إستانبول، يمكننا القول بأنه لا وجود اليوم للأرمن في تركيا. ثمة ستة كنائس، ولا توجد أي مدرسة أو دير. وقد كانت الإبادة سريعة بحيث تمّ قطع رأس المجتمع الأرمني وتهجيره بأكمله وتفسّخه وإبادته خلال سنة واحدة. ومما يضفي على هذه العملية صفة الإبادة الشمولية، هو أنها استهدفت هوية جماعية كفئة مجردة: عملياً كان جميع الأرمن ضحايا محتملين، الموالون منهم والمعارضون والسياسيون واللاسياسيون. وقد انحدر ضحايا الإبادة من منابت وخلفيات اجتماعية وإقليمية مختلفة: مثقفون حائزون على تعليم عالٍ ومهنيون ينتمون للطبقة الوسطى وعمال أميّون وفلاحون ومصلحون متحررون وقوميون علمانيون ورجال دين محافظون. وقد تراوحت ردّود فعل الضحايا بين المقاومة والهرب، وبين الانصياع والمقاومة الوجودية. وعلى الأرجح أن غالبية الفلاحين لم يدركوا سبب الإبادة، ولا حتى حجمها. ولم ينتشر وعي عميق بمأساوية الحدث بين الأرمن المثقفين والسياسيين إلا بعد انتهاء الحرب.
نتائج الكارثة
بالرغم من انقضاء حقبة الإبادة ووفاة جميع المعنيين عملياً، ما زال للإبادة الأرمنية دورٌ في السياسات الحالية بين أرمينيا وتركيا. إذ خلَّفَت الإبادة إرثاً مزعجاً في العلاقات الدولية بين الجماعتين. ولقد أخذ الأرمن، اعتباراً من 1960، يدعون إلى الاعتراف بالإبادة وتسليط الضوء عليها. أما الحكومات التركية المتعاقبة فقد ردّت على هذه النزعة بالإنكار والحطّ من شأن الإبادة. ويمكننا تقفي أثر سياسة الإنكار بالرجوع إلى المنشور الذي أصدره طلعت باشا عام 1916. أنصار هذه النظرية يزعمون بأن ثلاثة آلاف أرمنيّ «فقط» لقوا حتفهم، وبأن الأرمن ارتكبوا خيانة جماعية بحق الدولة، وبأن التهجير ليس سوى محاولة وقائية لإبعاد الأرمن عن مناطق الحرب، ولم يكن منهجياً ولا معادياً للأرمن ولا عملية إبادة متعمدة. بيد أن سياسة الإنكار كانت بمثابة الإهانة بالنسبة لأهل الضحايا، إلى حدٍّ دَفَعَ القوميين الأرمن للجوء إلى العنف في عام 1970. فقد قامت منظمتان إرهابيتان بإطلاق النار على عشرات الدبلوماسيين، مما زاد من حدّة الإنكار التركي.
بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، خرجت أرمينيا من حربها مع أذربيجان بدون علاقات دبلوماسية مع تركيا. وقد تعطلت المحاولات الأمريكية والسويسرية للوصول إلى نوع من التقارب جرّاء سوء الظن والكره المتبادل بين البلدين. وما زالت الحدود الأرمنية التركية مغلقة بإحكام، وهذا له تأثير سلبي كبير على اقتصاد المنطقة. وفضلاً عن ذلك فإن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يتوقف جزئياً على إعادة فتح الحدود، الأمر الذي يعتمد جزئياً على الاعتراف بالإبادة. الزمن لا يشفي، فبعد قرابة المئة عام ما زالت الإبادة الأرمنية مُشكلةً أساسيةً في العلاقات التركية الأرمنية.