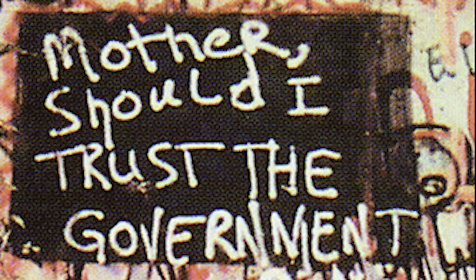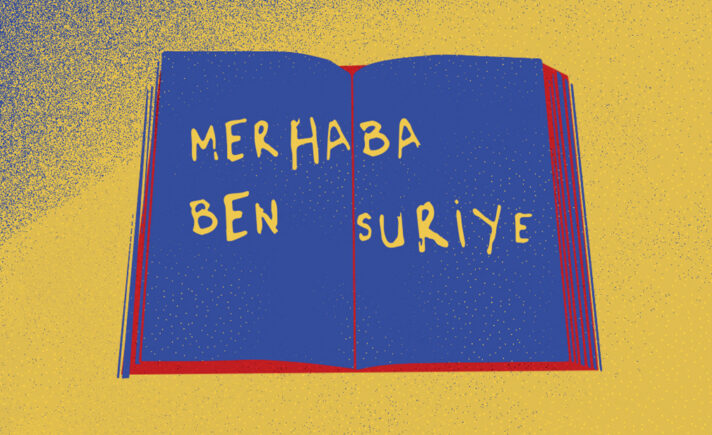أمي، هل توجَّبَ عليه أن يكون بهذا العلو؟
ينتهي «روجر وترز» من الغناء، فأرددُ أنا: الجدار؛ شبه مُنوَّمَةٍ مغناطيسياً، تحت تأثير رعب شديد، وبحدقتين متسعتين، اتساعَ ثمانية وعشرين عاماً؛ بِدءاً من أمي على فراش المخاض، إلى تلك اللحظة، حين توقفَت الموسيقا.
تكرار
بعد تجاوز الارتعاش الموسيقي الأول، أَنهَكَ التكرارُ سيالتي العصبية، التي تسارعت استجابةً لإغراء الأدرينالين، أو هرمون الخوف، لتجمع في طريقها إلى الدماغ روابط لا تنتهي بين الأغنية الأقرب إلى الوحي، وحقدي الثائر، المتراكم ما بين الولادة وعزلة خوفي الموروث.
أمي (Mother)
تُمثّلُ أغنية فرقة بينك فلويد (Pink Floyd) البريطانية «أمي»، جزءاً من أحجية وجودية تكتمل من خلال ألبوم «الجدار» (The Wall)، وقد لا تبدو مكتملة، إذ يتوقف ذلك على قدرة المستمع على التصالح مع ذاته، لا سيما إذا كان سوريَ الجنسية، يعيش مع الحرب أو هارباً منها، تماماً كبطل الفيلم المُقتَبَس عن الألبوم والذي يحمل ذات الاسم، أو الوصمة. فالشخصية المحورية، واسمه «بينك فلويد»، موسيقيٌ يعيش تبعات الحرب العالمية الثانية على ذاته المنضوية في سجن الإدراك المضبوط حدَّ التلاشي، الذي ساهمَت والدتُهُ، رمزُ القوة المتحكمة به، ببناء كل حجر من جدرانه.
«هل يجب عليَّ أن أبني الجدار؟»
يرسمُ الحوارُ المُغَنّى بين الابن وأمه ببساطة، قد يرى بعضٌ منّا أنها تكمن في العلاقة الأزلية بين الابن وأمه من منطلق بيولوجي على الأقل، هويةَ العالم المحيط، وكأن باستطاعة الفرد أن يساهم في خلق هذا العالم، لا أن يتعامل معه على أنه موجود حتى قبل أن ينبعث من جسد أمه هو نفسه، أي أنه ليس أمراً واقعاً أو حقيقةً مفروضة؛ فيما تُمعِنُ الأم في الأغنية بإغراق الابن في وهم الاستطاعة هذه، لا بل وتصرُّ على تهيئةِ استجابته، وعلى مستوى أعمق من التفاعل، تهيئة وعيه الاجتماعي والسياسي والعاطفي على حدٍّ سواء، لتطلق فيه ذعراً يدفعه راغباً وبقوة للبقاء بين جدران الرحم الأول.
لِمَا الأم؟!
ظننتُ للوهلة الأولى أن من كتب الأغنية اختارَ الأمَّ لتكون صاحبة القرار في حياة «بينك فلويد» بطل الفيلم والأغنية، فقط لأن الحرب العالمية الثانية كانت قد أودت بحياة والده، لأستجرَّ وبسذاجة أكبرَ مفاهيم مجتمعي الذي رُبّيتُ فيه، وابتعاداً عن التعميم أُصِرُّ على ياء الملكية في مجتمعي، فهي صورتي الخاصة عن المجتمع وإن اشترك معي فيها كثيرون آخرون، ظناً مني أنه من الطبيعي جداً أن تكون الأم هي المسؤولة عن تشكيل منظوري للعالم بما فيه، خاصة وأن التربية أو الإعداد من وظائف الأم بشكل أساسي، دون التعويل على دور الأب الملتزم بالفضاء خارج المنزل، تحت مسمى ربِّ الأسرة وحاصدِ الرزق.
لا تورِدُ الأغنيةُ ذكراً مباشراً للمنزل، فالبيت جزافاً هو هيئة العالم المصغرة أو على الأقل البداية إليه، ولكن لا يمكن أن أفكر بالأم كمفهوم دون التطرق إلى الـ «Domestic Sphere»، الفضاء العائلي، الفضاء المنزلي، المرتبط بدفء الأمومة، قلقها على أطفالها، خوفها من كل ما يرتمي خارج حدود المنزل.
ماما ستُبقيكَ هنا تماماً، هنا تحت جناحها
ماما لن تسمح لك بالتحليق، ولكن قد تسمح لك بالغناء
ماما ستُبقي الصغير وثيراً ودافئاً
بالتأكيد، ماما ستساعدكَ على بناء الجدار
المنزل/ بداية الجدار
لارتباطِ الفضاءِ المنزلي في مخيلتي بالأم، ارتباطاً معاشاً ومقتبساً ممن حولي، وجهٌ أكثرُ صرامةً ومبنيٌّ على الحرمان؛ الفضاءُ المنزلي ووثارتهُ يقومان على حرمان الطفل، البالغ والعضو الفاعل في المجتمع مستقبلاً، من قدرته على التجريب الذاتي، والاعتماد، وبمعنى آخر الاستهلاك، المُكَرِّر لتجربة الأم المُكَرَّرة المنقولة إليها من أمها في المقام الأول.
ماما، دائماً، ستعمل على اكتشاف مكانك
ماما ستُبقي الصغير معافىً ونظيفاً
يبدأ الحرمان، في ذاكرتي، وأعتقدُ أنها حيزٌ مشتركٌ مع كثير من الأطفال في بيئتـ[ي]، من هَوَسِ الأم بنظافة طفلها وشكله الخارجي المرتب كغرفةِ جلوسٍ معدّةٍ دائماً لاستقبال الضيوف، والذين غالباً ما سيأتون لتقييم مستوى النظافة وغياب البكتيريا المؤذية، وليس بهدف الزيارة والاستمتاع بتفاعل بشري اجتماعي محض.
يشكّلُ الاتساخُ نقيضَ المثالية، ولو أن هذا الاتساخَ الناجمَ عن اللعب هو فرصةُ الطفل الأولى في اختبار نفسه خارج المنزل، اكتشاف الشارع، بما فيه من علاقات، مكونات، طبقات ومخاوف؛ فرصة الطفل في تكوين جزء من وعيه.
لا يقتصر دور الأم على ممارسة الحرمان من الاتساخ، ولا سيما أن نمو الطفل المترافق بنمو وعيه سيزيدان من قدرته على المقاومة، فتعمدُ، تقودها في ذلك كلٌّ من الأمومة المفرطة ورغبتها بالحماية، إلى قصر الوعي، إلى تفخيخه بالخوف والهَوَس.
صغيري، صغيري، إياك والبكاء
ماما ستعمل على تحقيق كل كوابيسك
ماما ستزرع كل مخاوفها فيك
العلاقة مع خارج الجدار
لا تعود الأغنية إلى جذور الخوف الأمومي لدى الطفل وحسب، ولكنها تستعرضُ نتائج تطبيقه كنمط حياة؛ فالطفل المتسائل في الأغنية، ليس إلا رجلاً بالغاً، شلّهُ الهلعُ فباتَ غير قادرٍ على اتخاذ أي قرار بشكل فردي دون الرجوع إلى والدته، ليبدأ هو فعلاً بالتعاون معها على بناء الجدار.
ينطلق الخوف من الداخل إلى الخارج، فالرجل البالغ خائفٌ من كل ما يقبع خلف الجدار، يتردد حتى في اختيار حبيبته بنفسه، فقد تكون الحبيبة بحد ذاتها خطراً يحدق بوجوده، أما الأسوأ فإنها قد تؤلم والدته إن لم تتناسب مع معاييرها عن الحماية؛ في المقابل تَعِدُ الأم بإغلاق الجدار أكثر فأكثر، فهي ستعمل على مراقبة أداء ابنها، واختياراته، وهي شبه موقنةٍ أن ذائقته لن تفي بالغرض، لن تساعد في إبقائه حبيساً، كما أنها لن تمنع الخطر الخارجي من العبور إلى الداخل.
أمي، هل تعتقدين أنها ستكفيني؟
أمي، هل تعتقدين أنها خطرة؟
أمي، هل ستمزقُ طفلكِ إلى أشلاء؟
أمي، هل ستكسر قلبي؟
…
ماما، ستتفحص كل حبيباتك لأجلك
ماما، لن تسمح لأي شخص سيئ بالعبور
الأب الغائب
إن كان الأب غائباً في الأغنية لأنه مقتول، فما الذي يمنع غيره من الآباء من المشاركة في فعل التربية، تربية الوعي أو قمعه ربما. بعيداً عن سذاجتي أعلاه، وعن العلاقة الحميمة المفترضة، مطلقاً، بين الأبناء وأمهاتهم، أخذ بحثي عن الأب منحاً أكثر انحرافاً، فالرحم يحتويه فيزيولوجياً هو الآخر.
أدهشتني، على الدوام، فكرة تفرد المرأة بالرحم، قدرة خالصة لها تماماً لا يشاركها الذكر في هِباتها ولا آلامها، غير أن الانجرار وراء التفرّدِ هذا حمّلها، في نظري، مسؤولية كل المواريث، سلبية كانت أم إيجابية؛ لكن كتاب العلوم يبدو منصفاً أكثر، فالرجل يحمل نصف المسؤولية تماماً، الرحم نسيج من خلايا، وكل خلية بشرية هي عبارة عن 23 زوجاً من الكرموزومات، ما أفضّلُ أن أسميه تبسيطاً «نواقل للجينات»، التي تأتي مناصفة من الأب والأم، وهما بدورهما وريثان لأب وأم.
في الرحم مزدوجِ الجنس
الخوف المنتقل إلى الطفل لا يقتصر على هَوَسٍ بالنظافة أو عدم القدرة على المحبة اللامشروطة، اللامقيدة بمعايير أمانٍ وحماية، ففي الرحم يتلقى الطفل ذاكرة والديه وتجاربهما الأخرى على تَعدُّدِها، يَرِثُها كما لو أنها غير قابلة للتعديل أو التغيّر، أو حتى الاستفسار عنها، كلون عينين أو بشرة.
أمي، هل يجب أن أترشح للرئاسة؟
أمي، هل عليَّ أن أثق بالسلطة؟
أمي، هل سيضعونني على خط النار؟
أمي، هل هي مضيعة للوقت وحسب؟
ذاكرة سياسية، تحميها الجداران التي تمتلك آذاناً تسمع أبسط تجاوزاتنا في الاستفسار عن ماهية كل ما هو خارج المنزل، مثلاً: «بابا، ما الذي تعنيه كلمة خالد؟» لتليها صفعة معنوية، تخللتها ذكريات والدتي عن مكان اسمه حماة، وكأنه لا ينتمي إلينا، وعن أكراد لا هوية لهم، فقد أُرسِلوا إلى العدم منذ زمن بعيد، ذكريات لم تقدَّم على سبيل التفسير أو التوعية، وإنما تذكيراً بالجدار، الذي تتربص من خلفه قوىً بإمكانها قذفنا بعيداً إلى اللاوجود نحن أيضاً؛ علينا بالصمت، وعدم التشكيك، فإرثنا كأطفال يشتمل على السجّان خارج الجدار، ومبعوثيه المخلصين في الداخل.
في نظري، ستبقى طفلاً دائماً
الخوف يؤتي ثماره
أمي، هل تظنين أنهم سيلقون بالقنبلة؟
ماما، هل تظنين أنهم سيحبون هذه الأغنية؟
ماما، هل تظنين أنهم سيلسبونني رجولتي؟
فَشِلَ الجدارُ، مع أولى محاولاتنا لاستخدام حواسنا المسمطة عام 2011، في حمايتنا، فالقنابلُ أُلقيت، والأغاني الثورية اقتصر بثّها على مسامعنا، نحن من أردنا كسر الجدار والإلقاء بحجارته على المتربصين بنا. حاولوا إخصائنا بالمجمل، كي لا نتكاثر، نحن من دفعنا ثمن إعادة تشغيل وعينا الذي كبر فجأة وانتشر حاقداً على من أرادوا لنا أن نعلق في مرحلة واحدة، أطفالاً إلى الأبد.
صَمَدَت بقايا للجدار في أنحاء سوريا، تحت أثر حكايات الجدات والأجداد وخرافات الوحش المختبئ أسفل السرير، لا بل في السرير ذاته.