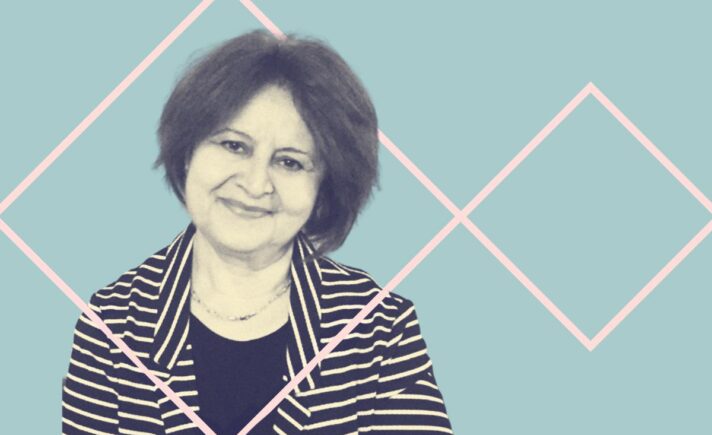لم يسبق لكِ أن زرتِ سوريا، ومع ذلك تعملين مع الثوار السوريين في هولندا. تتولين أيضاً منصب عضو إدارة في إحدى الجمعيات لدعم الثورة من هولندا. ربما أنتِ من القلائل الذين يشتغلون بشكل مباشر مع السوريين وليس خلف ظهرهم أو بعيداً عنهم. كيف بدأ اهتمامك بالثورة؟ ولم اخترتِ هذا النوع من التعاون؟
يصعب القول إنه كان خياراً. بدأ اهتمامي عندما رأيت الصور التي رآها الجميع، صور المظاهرات السلمية التي وصلت تلفزيوناتنا. كانت لا تطفح بالغضب المكتوم فقط، وإنما بكثيرٍ من الحيوية والأمل والفرح والتضامن أيضاً. وبعدها مباشرة جاءت صور تفريق المظاهرات وقمعها، وكيف بدأ النظام يفجر الأحياء السكنية لأهداف «وقائية» وبحجة تواجد «الإرهابيين» فيها. باختصار: صور العنف هذه لم تحزنني فقط، بل حرمتني من النوم أحياناً.
ولقد رأيتُ كيف تسمّر الناس هنا أمام التلفزيونات ليتابعوا الربيع العربي في تونس ومن ثمّ في ساحة التحرير في مصر. ولم يكونوا أقل اهتماماً بالثورة الليبية. وكم استغربتُ عندما عمّ الصمت مع بدء الحراك والقمع في سوريا. كلّ الصور وصلتنا ورأينا كيف كشف النظام أخيراً عن وجهه الحقيقي، ولكن الصمت من حولي كان رهيباً، لذلك قلت لنفسي بأن أمامي خيارين: إما أن أحتجّ عبر الفيس بوك، أو أن أسأل أين أجد المهتمين بما يحدث في سوريا.
وهكذا تمكنتُ في 2012 من التواصل مع لجنة لدعم الثورة السورية من هولندا، وحضرتُ لقاءً نظموه بالتعاون مع ساحة الياسمين. تعرفتُ على بعض السوريين ودُعيتُ لمعاودة الحضور والمشاركة بالنقاش حول كيفية الوصول إلى الجمهور الهولندي. كوّنتُ صداقات عزيزة وصارت الأحداث في سوريا قريبة مني، لأنها تمسُّ أصدقائي. وهنا بدأ طريقي مع السوريين ولم يعد أمامي خيار العودة، أو بالأحرى لم يكن هذا مطروحاً، لأني لا أريد العودة.
يرى السوريون أن العالم خذل ثورتهم ضد الظلم، ويلومون الغرب على سلبيته. في المظاهرات التي شاركتِ في بعضها، والتي كانت المشاركة الهولندية فيها ضعيفة، نرى الثوار السوريون يهتفون بشعارات تندد بصمت العالم، كأن يحملوا لافتة: «صمتكم يقتلنا!». غالباً ما تُفزع الترجمة الحرفية لهذه الشعارات المارّين بالمظاهرة. كيف ترين هذا الصمت؟ ولماذا لم تحرك المأساة السورية ساكناً في هولندا؟
هذا سؤال شائك، فأنا لا أستطيع النظر في عقول وقلوب كل الهولنديين. لا أزعمُ أن الجميع غير مبال، ولكن الأمر يتعلق بالصورة الذهنية عن الشرق الأوسط. منذ بضعة عقود ونحن نرى الشرق الأوسط كمجموعة من بؤر العنف الإسلامي المحتمل. أظن أن هذه الصورة الذهنية هي التي جعلت الهولنديين يقولون: صحيح أن الأسد ديكتاتور، ولكن ربما هناك سببٌ مقنع لبقائه في منصبه، مَن غيره سيمنع تحول الصراع إلى حرب قبلية بين جماعات إسلامية متطرفة؟ هذا الكلام يلائم الصورة عن الشرق الأوسط، مما يجعل الناس يتقاعسون عن التقاط حقيقة ما يجري. أضف أن الأسد لا يشبه في ظهوره الإعلامي ذلك الديكتاتور المتعطش للسلطة، كما كان القذافي مثلاً، أو صدام حسين، المعروفَين بأسلوب حياتهما المَرَضي وبثرائهما المخيف. ظاهرياً تبدو سوريا مختلفة عن الديكتاتوريات الأخرى. ولا تنسي أن بشار تغامز مع الغرب بعد استلامه السلطة: سنقوم بالإصلاحات التدريجية، ولدينا خطط بيئية… إلخ!
لو عدتُ بذاكرتي إلى الهولنديين الذين تكلمت معهم في تلك الفترة، أسمعهم يقولون: صحيح، الأمر فظيع، ولكن ما أدرانا مَن الذي تحدى الآخر. هم يتبنون منطق حافظ الأسد نفسه، بأن علينا حكم البلد بيد من حديد، لأن البلد مليء بالبؤر الطائفية المهيأة للانفجار في أي لحظة. بالنسبة لي، بشار أذكى من الشيطان في لعبته الإعلامية مع العالم، هو أذكى من يوزيف غوبلز، وزير الدعاية السياسية في عهد هتلر. بشار يعرف بالضبط أين مكمن المخاوف والأحكام المسبقة عند الغربيين. منذ البداية أطلق كلمة «الإرهابيين» على المتظاهرين السلميين، وهو يعلم أنها كلمة تجعل الغربيين يقلقون ويفكرون بحماية أنفسهم أولاً. يصبح كلّ همهم ألا يمتد الإرهاب نحوهم! الجميع رأى البراميل، وكيف تم تفجير الناس الواقفين عند المخبز الوحيد. ولكن يبدو أن الإنسان قادر على تناسي هذا العنف سريعاً.
كيف يوفق الهولندي هذا الموقف مع قيم بلده الديموقراطية؟
أنا أيضاً لا أفهم. هذه أسئلة السوريين، ولكنها أسئلتي أيضاً. أتمنى أحياناً أن يكون لدي جوابٌ عليها. في الرابع من أيار، عيد تحرير هولندا من النازية، سترين كيف ستتكرر قصص الحرب العالمية الثانية، وكيف أن الألمان قالوا إنهم كانوا لا يعلمون. أفكر حينها بأننا جميعاً نعلم ما يحصل في سوريا. اكتبي «الأسد» في ويكيبيديا وستقرئين الحكاية الصحيحة. المصادر موجودة. حزني الأكبر أن الاهتمام بسوريا بدأ مع ظهور داعش، وطبعاً مع التركيز على أنها مصدر الشر الأكبر. لا أقول إنهم ليسوا أشراراً، ولكن لماذا لا ننظر إلى تاريخ نشوء داعش؟ عندما أقول هذا للهولنديين، يوافقونني بدايةً ويصمتون.
«لا نريد للمأساة أن تتكرر!»، عندما يردد الهولنديون هذه الكلمات يقصدون بأن عليهم فعل كل شيء لمنع تكرار ما عانى منه العالم أثناء الحرب العالمية الثانية. ولقد كتب القلم الهولندي، ولم ينضب بعد، الكثير من المذكرات الجميلة والروايات الرائعة عن هذه الحرب. الشيء الذي يثير استغرابي هو أنه بالرغم من الذاكرة الهولندية القوية، لم يتم حتى الآن الربط بشكل مقنع ما بين مأساتهم التاريخية وبين مآسي الشعب السوري. أما السوري الذي خبر الحرب جيداً فيحلو له أن يربط بين الإبادة التي وقعت على اليهود والإبادة التي تقع حالياً على السوريين والثوار. أعرف أن هذا الكلام بمثابة الكفر بالنسبة للهولندي المتشبع بالذنب لخذلانه اليهوديَ والسماح بإرساله إلى المحرقة، ولكن كيف السبيل لإيقاظه من سباته وإخباره بإفلاس شعاره العزيز، وأن المأساة تتكرر؟
لم يفلس شعارنا أثناء الحرب في سوريا فقط، فلقد حصل هذا أيضاً أيام كونغو ورواندا وحرب البلقان. مشاعر الذنب تجاه اليهود سطحية ومجانية. اسمحي لي أن أكفر مثلكِ وأقول بأن هذه المشاعر تشبه ما ينتابنا أثناء دورات كأس العالم لكرة القدم، عندما نلبس ثياباً برتقالية اللون ونلوح بالأعلام في الشوارع. نحن شعب عاطفي، ولكن هذا لا يعني أننا نفكر جدياً بالأشياء. نبكي في الرابع من أيار أو حين نزور بيت أنّا فرانك. ولكن لا تنسي أني تربيت في ثمانينات القرن الماضي على فكرة أن كلّ هولندي بطل مقاومة. الألمان هم الخطأ ونحن الفالحون. هذه الفكرة بدأت تتغير في الآونة الأخيرة، وبتنا نعرف أن ثمة بشر سُحِبوا من بيننا دون أن نعترض. نصمت عن ماضينا، فلا نعترف أن بيننا من يعادي السامية. اليهود القلة الذين تمكنوا من العودة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، اكتشفوا أن عليهم البدء من الصفر وأن جيرانهم صادروا ممتلكاتهم الثمينة من لوحات وفضيات وجواهر. عادوا ورأوا الهولنديين منشغلين بإعادة إعمار بلدهم، وبمعالجة رضوضهم النفسية التي سببتها الحرب وشتاء الجوع. لم يكن هناك أدنى اهتمام بتجارب اليهود في معسكرات أوزفيتش أو تروبلينكا. نحن اليوم مهتمون بالحرب ونناقش سنوياً فيما إذا كان علينا استذكار كل الحروب، أم الحرب العالمية الثانية فقط. هذه الجدالات مفيدة، ولكن ثمة سبباً لمقارنة تلك الحرب بالجحيم الأكبر الذي لا يتكرر في التاريخ. مصانع القتل كانت فظيعة للغاية، ولكن وسم هذه التجربة بأنها أسوأ ما مرّ بالإنسان، يؤدي بنا إلى تهوين الفظاعات الأخرى في العالم.
والناس يعرفون أنه من غير الممكن رفض الحرب من دون التورط بالمقاومة. خذي زيارة بوتين لهولندا على سبيل المثال، الناس يعرفون أن هذه الزيارة لن تتكرر ثانية، لذا ترينهم يتظاهرون ضدها بحجة سوء معاملة روسيا للمثليين. لا أقصد التقليل من قيمة هذا النوع من المقاومة، ولكني أستسهل التظاهر لمرة واحدة ضد العنصرية أو من أجل السلام أو حقوق المرأة. التظاهر ضد الحروب مشروع طويل ولا يغمرنا بتلك الأحاسيس الجميلة. كما نعرف أن مظاهراتنا لن تجبر الأسد على التفكير بحكمة: «معكم حق، عليّ أن أتنحى». الأشخاص الذين يقاومون الحرب يدركون في داخلهم أن لا طريق للرجعة، وأخشى أن يلعب اليأس دوراً في عدم جذب الناس الذين لا يتوقعون نهاية حميدة لهذه الحرب.
أحاول أحياناً إقناع الهولنديين بالمشاركة، فيتأثرون فعلاً أو يعترفون بأنهم لم يكونوا على علم بأن الأمر سيء إلى هذه الدرجة. أدعوهم ويقبلون دعوتي، ولكن طريقة تظاهر لجنة دعم الثورة تختلف عن الطريقة الهولندية. وينطبق الشيء نفسه على تعبئة شاحنات الإغاثة، فطريقتنا ليست ناجعة في أغلب الأحيان. كما أن الهولنديين لا يفهمون أننا نرقص أثناء تظاهرنا. نحاول الهتاف باللغة الهولندية، ولكن الناس يقفون وينظرون من بعيد، كما لو كانوا علماء أنتربولوجيين مهتمين وغريبين في الوقت ذاته. طريقة السوريين بالتعبير عن مشاعرهم أثناء التظاهر غريبة، وتُرهب الهولنديين المتعودين على أن كبح المشاعر فضيلة. أما السوري فيترك لقلبه كامل الحرية ويعانق رفاقه ويرقص معهم.
أطلق الإعلام الهولندي مصطلح «أزمة اللاجئين» ليعبّرَ عن الأزمة التي سببها اللاجئون، وليس عن أزمة اللاجئ نفسه. في منشورك، عندما ينخز الصمت، تقدمين رؤية مختلفة لهذه الأزمة وتعتبرينها النعمة المقنعة التي حلّت على هولندا. ماذا تقصدين بالضبط؟
أقصد أن قدوم اللاجئين إلى أوروبا جعل بعض السياسيين يستسهل لوم اللاجئين على كل شيء، وعلى أنهم يضغطون على سوق السكن ويحصلون على المعاشات الاجتماعية وينجبون أطفالاً أكثر من الهولنديين. وهكذا صار لدينا كبش فداء، وأصبح السياسيون قادرين على تحصيل المكاسب السريعة لأنفسهم من خلال المطالبة بإغلاق الحدود. هناك هولنديون كثيرون لا يركبون هذه الموجة ويرحبون باللاجئين، ولكن طاولات الحوار التلفزيونية لا تجدهم ممتعين، لأنهم يتكلمون بدقة ويعملون بصمت.
نجح السياسيون بوضع مسألة اللاجئين على رأس قائمة أولوياتهم. وللأسف لم يكن اهتمامهم هذا من باب إيجاد حلول لفقر اللاجئين في البلدان الأخرى، فهذه ليست أسئلة شعبية. السؤال المطروح هو إلى متى سنترك حدودنا مفتوحة. تضخيم هذا السؤال يلهينا عن مشاكلنا الأخرى. إذا أراد المجتمع أن يتضامن من أجل حلّ مشكلة البيئة مثلاً، فلن يكفي أن نسمح لعدد من السيارات الكهربائية أن تستكشف شوارعنا، بل علينا أن نتغير جذرياً، وهذا يتطلب منا تضحيات على المدى البعيد. نرى الشيء نفسه بالنسبة للظروف السيئة في مجال الصناعة البيولوجية. لدينا حظائر ضخمة للخنازير، بنايات بأكملها. كلما حصل شيء، نطالب بإغلاق هذه الحظائر. نفعل الشيء نفسه بخصوص مداجن الدجاج. نحن نخاف من انتشار الأوبئة بين الحيوانات وتسرب المواد السامة إلى الغذاء. نحتج بين الحين والآخر، ولكن معظمنا يفضّل أن يأكل قطعة لحم رخيصة الثمن عند العشاء. وعندكِ أيضاً مشكلة استهلاك اللحوم التي تستنفذ مشاعرنا المجانية، من دون أن تؤدي إلى سياسة حكيمة على مستوى أوروبي. كل هذا يتطلب من الناس أن يغيروا حياتهم اليومية، أما طرد اللاجئين أو عدم السماح لهم بالدخول، فهذا أمر لا يؤلم الهولندي. ومن السهل للسياسيين أن يحققوا مكاسب سريعة من خلال النداء بأن البلد بلدنا وأن عليكم أن تحلوا مشاكلكم بعيداً عنّا.
دعيني ألعب دور محامية الشيطان. ألا ترين أن النزق الذي أصاب بعض الهولنديين مفهوم كردة فعل طبيعية على التغيرات الديموغرافية الكبيرة التي حدثت في السنوات الثلاثين الأخيرة؟ أحياء كاملة، لا بل مدن، صارت مأهولة بالمهاجرين من كل أنحاء العالم. ماذا تقولين للهولندي الذي يعتقد عن قناعة أن مشاكله جاءت من وراء رأس المهاجر واللاجئ الذي يضغط بعوزه على الخدمات الهولندية؟
أتفهم جيداً قلق الهولندي الذي يعيش في حيٍّ يتغير سريعاً. دكاكين جديدة تحل مكان القديمة، لغات غريبة، طرق تعامل مختلفة. أقول مختلفة وليست أقل تحضراً. كيف تلقي التحية؟ كيف تتكلم مع الآخر؟ أتفهم أن يهدد هذا الوضع بعض الناس، وبالأخص كبار السن الذين لم يخرجوا طيلة حياتهم من أحيائهم. ومع مرور الوقت يغادر المزيد من الهولنديين الأصليين هذه الأحياء، ليأتي مكانهم مهاجرون جدد. هذه التغيرات تجعل الناس يشعرون بالغربة في المكان الذي عرفوه طيلة حياتهم. الحل بسيط: على البلديات أن تغير سياستها وتساعد على خلط السكان، بحيث لا تنشأ أحياء بأغلبية هولندية أو مغربية أو تركية، ولا تشعر أي مجموعة بأنها الأقلية.
وهناك أيضاً الهولنديون الذين ينتظرون لمدة سنوات دورهم في الحصول على سكن اجتماعي، والذين يتذمرون لأن اللاجئين يحصلون على الأولوية. ينسون مثلاً أن بيوتاً كثيرة في أمستردام تباع مقابل أسعار باهظة، وأن المشترين يربحون بتأجيرها للسياح، بينما يسكنون هم في مكان آخر.
كل هذا مفهوم إلى حد ما، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن ثمة هولنديين لا يسكنون في الأحياء المكتظة بالمهاجرين، وليسوا بحاجة إلى السكن الاجتماعي، ومع ذلك يستغلون هذه العواطف لينادوا بإغلاق الحدود. اللاجئ برأيهم هو سبب كل المشاكل. يقال مثلاً إننا نحتاج إلى الاستثمار بالمال في قطاع الصحة، ولكن لا أحد يقول إن قطاع الصحة قائم بشكل كبير على استيراد اليد العاملة. والأمر لا يختلف كثيراً في قطاع العناية بالمسنين وخدمات التنظيفات والبناء.
من السهل تحميل اللاجئين عبء كل شيء، لأنهم لا يتقنون اللغة جيداً ومعظمهم لا يعمل في مناصب بارزة، ولذلك هم غير قادرين على الرد في المناظرات العامة أو تفنيد هذه الاتهامات. أضف أن المجال العام غير مفتوح لهم أساساً.
تستخدم الأحزاب قضية اللاجئين بطريقة أحادية الجانب وكاريكاتورية إلى حد كبير. حزب الحرية اليميني لا يفوّتُ فرصةَ أن يخيف الناس من المسلمين. أما الحزب الليبرالي فيركز، من دون ذكر المسلمين، على مسألة الأمن. السياسة مليئة بأقوال من نوع: «قيمنا ومعاييرنا المسيحية والليبرالية في خطر»، وهناك من يقول إن «ثقافتنا العالية» مهددة من الداخل، أي من قبل ناس مثلي يحبون العيش في مجتمع متنوع.
الخوف يحفز الاقتصاد. الخائفون يستهلكون أكثر، ويتبعون نزواتهم في الشراء. وفي الوقت ذاته نرى كيف تحصل الحكومة على المزيد من الصلاحيات لكسر خصوصيات الناس، وكيف تُصرف الملايين على الأمن والوقاية ومكافحة الإرهاب. بينما يتركون أكبر إرهابي على وجه الأرض، بشار الأسد، يفعل ما يشاء.
نعود إلى سؤالنا، ماذا تقولين لهذا الهولندي المتذمر بسبب أو من دون سبب؟
هذا صعب، لأني أحب التواصل مع الثقافات المختلفة منذ كنت طفلة صغيرة. عندما كنا نسكن في دن بوس، كان هناك شارع مليء بالرجال المغاربة والنساء المحجبات. كنتُ سعيدة بهذا التواصل إلى حد السذاجة. كنت أقول لنفسي: «ما أحلى أن يأتي العالم إلى عندك، لا داعٍ لأن تسافر لتتواصل مع كل الثقافات، السورينامية والهندية مثلاً». كنتُ أحب رائحة المطابخ المختلفة. الهولنديون كانوا في ثمانينيات القرن الماضي أكثر فضولاً نحو الآخر، وكانوا يتأثرون بما يحمله المهاجر في جعبته من تجارب ومتاعب.
هل تقولين: انظروا إلى العالم بعيون ديسان الصغيرة؟
نعم، ربما كنت متفائلة جداً. ولكني أجد كل تواصل مع الآخر إثراءً للنفس.
تنتقدين في كتابتك الجميع تقريباً، حتى أولئك الذين تطوعوا وقدموا من وقتهم وجهدهم من أجل مساعدة اللاجئين الجدد. أين ترين الخلل في هذه المحاولات الطيبة؟
إلى جانب النقد الذي يتلقاه اللاجئون، هناك كثيرٌ من المهتمين الذين يقدمون من وقتهم وجهدهم. يساعدون اللاجئين ويرشدونهم في بلدهم الجديد، ويتعرفون على قصصهم وثقافتهم وطعامهم. ولكن يحصل أحياناً أن تهبط المساعدة من فوق. أحاولُ أن أنتبه كي لا أقع في هذا الخطأ السهل. يفكر الهولندي غالباً: «نحن نسكن في بلد حرّ، أهلاً بكم بيننا، تعالوا نعلمكم كيف تصبحون مثلنا!». هذا التعاطف يفضح الإحساس بعدم التساوي مع الآخر. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا الشخص مهتم فعلاً بالسوري، أم أنه يريد أن يواجه نفسه في المرآة ليقول: «كم كانت مساعدتي مهمة لهؤلاء المساكين»؟ يصعب أحياناً التواصل مع القادم الجديد من غير تقليص هويته إلى سوري أو لاجئ. هناك فائض من النوايا الحسنة، ولكن ينقص أحياناً أن يسأل الهولندي الطيب: ماذا تحتاج مني؟
يُسمح للقادم الجديد أن يروي قصته المحزنة، قصة هروبه والطريق الصعبة والانتظار الطويل في معسكرات اللاجئين، ولكن من دون التوقف عند الأبعاد السياسية لهذا العذاب. يتم التقليص من شأن العيش في بلد ديكتاتوري لمدة سنوات طويلة. سمعتُ مرة شاباً سورياً يقول في جملة اعتراضية إنه رأى من شباكه خمسين صديقاً مقتولاً على الأرض. لابد من أن هذا المنظر سيبقى محفوراً في عيون هذا الشاب طيلة حياته. لا يكفي إحالته إلى الطبيب النفسي. أريد أن أساعد السوريين في كفاحهم ضد الظلم.
كما يُطالَب السوري بأن يبدأ صفحة جديدة، فكلنا عندنا مشاكل ومن واجبنا أن نبحث عن حلّ. قليلٌ من المساعدة الطيبة والمثابرة يكفيان للبدء من جديد. عندنا مَثَلٌ شعبي يقول: «كل أزمة هي فرصة جديدة». هذا بحد ذاته صحيح، ولكن كيف تطلب من اللاجئ أن يقلب الصفحة السوداء، وأنت تعرف أن الحرب في بلده لم تنته. لا أزعم أن السوريين غير قادرين على البدء من جديد، وأن يتعلموا اللغة الهولندية ويجدوا عملاً وسكناً. ولكن الشعور بالذنب نحو الأهل في سوريا سيلاحقهم طويلاً. من غير الممكن محو هذه الحرب من الذاكرة كأنها لم تكن. إنه قصر النظر عندما نرى حيوات هؤلاء الناس كما لو أنها فيلم هوليوود: في البداية كوارث ومتاعب وفي النهاية تشرق الشمس وتطربنا موسيقى الكمان. في النهاية يعيش كل سوري في بيت مستقل أمامه سيارة تنتظره صباحاً. لحسن الحظ أن الدين عندنا ليس مسيطراً، ولكن هذا لا يعني أننا لا نملك ما يشبه الحلم الأمريكي. أقصد أننا نؤمن، من دون إله، بأن الحياة صعبة ولكنها ستنتهي على خير. هكذا هي نهاية كل الأفلام عن الحرب العالمية الثانية.
كل سوري يدخل هولندا يتعلم سريعاً معنى كلمة «انتخراتسي» أي الاندماج، والجميع تقريباً منشغل بطريقة ما وبنجاح متفاوت بتعلم اللغة الهولندية. ولكنك في كتيبك، رسالة إلى الباحث عن السعادة، تنصحين المهاجرين أن يندمجوا، ولكن باعتدال. كما لو أن المبالغة بالاندماج مضرة بالصحة. أليس الاندماج، كما تروج له الحكومة الهولندية، هو الحل الجوكر لكل مشاكل المهاجرين؟
إذا كان الاندماج يعني حقك بأن تفخر قليلاً بذكرياتك عن بلدك وثقافتك، ولكن أن تحاول قدر الإمكان أن تتركها وتتهلدن (نسبة لهولندا)، فإن هذا سيسبب المرض على المدى البعيد. لأننا لا نعترف بحنين الإنسان ونطالبه بأن يقطع الصلات التي تشكل هويته: «اترك كل شيء وراءك، واغطس كاملاً في هذا المجتمع!». نعرف من زمان أن هكذا مطلب يسبب المرض عند الإنسان، انظري إلى المثليين الذين يخفون ميولهم الجنسية أو الملحدين الذين لا يحق لهم الإجهار بعدم إيمانهم. برأيي لا يكفي أن تستمع لفيروز في بيتك، بل يجب أن يكون عندك الحق أن تكون، بكامل حنينك، وبكل الأشياء التي شكلتك وتحبها، وأن تعرض نفسك للآخرين من دون خجل.
لا يقول الهولندي حرفياً «إننا متفوقون عليكم»، ولكن رائحة هذه الكلمات تفوح أحياناً. ولأن الناس هنا يرون المجتمع الهولندي متفوقاً، يعتبرون الأمر بديهياً أن تتأقلم وتصبح مثلنا. ولكنك ستمرض حتماً إن منعت نفسك عن الإحساس ببعض الأمور والتعبير عنها.
كتبتِ من بين ما كتبتِ عن نموذج القمع المتنور، ماذا تقصدين بذلك؟
نموذج القمع المتنور هو أن تقول برفع الظلم عن بعض الجماعات المضطهدة، كالنساء، الزنوج والأقليات القومية. تعترف عقلياً أن جميع الناس متساوون ولهم الحق أن يعبروا عن رأيهم ويسعوا لتحقيق أحلامهم. أن تقول كل هذا بلسانك، ومع ذلك تتعالى على هذا الآخر. نرى هذا على طاولات الحوار التلفزيونية مثلاً. بعد أن ينتهي تنظيم كل شيء، يخطر على بال الإدارة أن عليها أن تدعو امرأة للمشاركة بالحوار. تأتي المرأة ويكون السبب الوحيد لوجودها هو كونها امرأة، رأيها السياسي أو الديني ليس ذا أهمية كبيرة.
غالباً ما يتكلم «القامع المتنور» بإعجاب كبير عن المرأة: يا لها من امرأة معجزة، بروفيسورة وأم جيدة في الوقت نفسه! يطرون على المرأة، كأنها قدمت عرضاً بهلوانياً مستحيلاً. نحن النساء عندنا حساسية عالية لهذه الأمور، ولم نتعود عليها بعد.
يحصل الشيء نفسه تجاه المهاجرين، وأعتقد أن الهولنديين لا يعون سلوكهم بشكل كافٍ. فإذا كتب مهاجر مغربي رواية بالهولندية، فلا بد أن يُسأل في كل لقاء يجرى معه عن خلفيته الفقيرة. ويبالغ الجميع بإعجابه بهذا المهاجر الذي قدم شيئاً غير متوقع، مع أن كل ما يريده هذا الكاتب هو أن يتم تقييم روايته بشكل صحيح. أما بالنسبة للسوريين، فمن الطبيعي جداً أن يُدعَوا ليعرضوا تفاصيل قصصهم الشخصية ومأساتهم، ولكن ليس لأنهم خبراء أو لأنهم يعرفون. الخبراء هم الغربيون فقط.
باسم الصحافة الحيايدية أعطى الإعلام الهولندي منبراً للموالين للنظام السوري، بحجة أنه لا يمكنه فهم الأزمة وتحليلها إن لم يستمع إلى جميع الأطراف؟ حتى صار الإعلام الحيادي إلى حدٍّ ما ذريعة للمطمطة والتشويش على الحقيقة. ما رأيكِ بهذا؟ وهل لمستِ تقصيراً من قبل مساندي الثورة للوصول إلى الإعلام الهولندي مقارنة مع الموالي للنظام؟
ليس صحيحاً تماماً أن الإعلام خصص منبراً للموالين. هناك صحفيون كثيرون يعملون على كشف جرائم الأسد. ولكن يحصل أن يُدعى شخصٌ إلى برنامج تلفزيوني لكي يشرح أن بشار ليس بتلك الوحشية، وأن الحياة أيام زمان كانت أفضل وأن جميع معارضي الأسد يريدون بسط سلطة الدولة الإسلامية. حتى عندما نعرف أن الأسد قام لتوه بمذبحة كيميائية جديدة، يأتينا من يقول: «دعونا نكون حذرين وننتظر الأدلة. من يدري، ربما هذه استراتيجية المعارضين كي يسوّدوا سمعة الأسد ويجعلونا نكرهه». والغريب هو ألا يتم الرد على هذا الكلام بالأسئلة الناقدة، لأننا «يجب ألا نسرع بأحكامنا» وأن نحترم شروط الصحافة الحيادية الموضوعية. هم محقون إلى حد ما، ولكن اختيار الإعلام لهذا النوع من الضيوف نابع عن كسل وتقاعس ولامبالاة.
والشيء الذي لفت انتباهي هو دور الأب اليسوعي فرانس فاندر لوخت الهولندي الأصل، والذي قُتل في حمص عام 2014. قبل الحرب كان فرانس يعمل مع السكان المحليين، مع الفقراء والعاجزين منهم، ينظّم نزهات استكشافية طويلة للشباب المسلم والمسيحي، ويحاول بهذه الطريقة خلق مجالٍ للتعارف والحوار. ولكن كلامه مع الإعلام الغربي، وبالأخص الهولندي والبلجيكي، كان لطيفاً تجاه الأسد، الأب والابن على حد السواء. يعترف بالقمع من ناحية، ويكرر كلام السلطة عن البؤر الطائفية من ناحية أخرى. فرانس قدم دعاية مجانية للنظام. ومازال الهولنديون، الذين زاروا مشروع الأب فرانس، يرددون كلامه ويقولون لي: «نحن كنا هناك، أما أنتِ فلا. نحن نعرف أكثر منكِ. والأب فرانس يعرف أكثر منا جميعاً لأنه عاش هناك». يرددون كلامه، حتى ولو عرفوا أن أباً يسوعياً آخر اختار أن يقارع النظام، أقصد الأب باولو.
الخوف من الإسلام والأسلمة أكبر من الخوف من الديكتاتور المحصور ضمن حدود بلده، ونحن نبحث منذ البداية عن عذر لعدم التدخل. نقول إننا لا نريد أن نكرر مأساة أفغانستان والعراق. لذلك خذلنا الثورة السورية من البداية، وراقبنا عن بعد كيف انقلبت الأمور إلى فوضى، وسميناها حرباً أهلية قبل أن تكون كذلك. وها نحن الآن نستنتج أن لا حلّ من دون الأسد. كلّ هذا يجعلنا نحسن الإصغاء لمن يقول إن الأسد ليس بتلك الوحشية، أليس كذلك؟
لا أظن أن الثوار مقصرون بالتواصل مع الإعلام. من الصعب جداً لمواطن غير معروف أن يطالب بإجراء حوار معه، أو أن يفرض مادة صحفية على جريدة. الإعلام يحب فقط أن يستقبل القصص الشخصية للاجئين، قصص لمّ الشمل والعمل والنهاية السعيدة طبعاً.
سنحت لك الفرصة أن تراقبي عمل السوريين الثوار في هولندا، ما رأيك بأدائهم؟ وما هي المشاكل التي تواجههم؟
تعرفت فقط على السوريين الذين يعملون مع لجنة دعم الثورة في هولندا، وهم يملكون طاقة كبيرة. كلما تردّت الأوضاع أكثر، مذبحة كيماوية مثلاً أو حصار مدينة، يقولون علينا أن نتظاهر. وفي الصيف الماضي قام بعض الشباب بإضراب عن الطعام للاحتجاج على هجوم الجيش اللبناني على مخيمات اللاجئين في لبنان. هذا عمل رائع، حتى لو لم تجذب هذه المظاهرات الإعلام الهولندي. يكفي أن يقول المتظاهرون لأهلهم عبر الصور والفيديوهات: «انظروا، نحن لم ننساكم، نحاول أن نفعل شيئاً. نحاول أن نصل للناس في بلدنا الجديد». أنا معجبة جداً بعمل السوريين من هذه الناحية، وأيضاً بعمل الإغاثة الذي يقومون به. يحاولون قدر الإمكان تقديم المساعدة. لا يريدون التخلي عن الثورة. ألاحظ هذا في كل شيء.
الوجه الآخر للعملة أن طريقة عملهم ليست فعالة. لا يفكرون بالتخطيط لمظاهرة قبل ثلاثة أشهر، لا يعتمدون وقتاً كافياً للفت انتباه الإعلام والسياسيين. كل شيء ارتجالي، معظم النشاطات سريعة. أعتقد أن السبب هو الإحساس بالذنب والعجز أمام هذه المأساة. يساعدون أنفسهم بالتكاتف والقيام بأي شيء. هذه ردة فعل طبيعية على هذا الوضع غير الطبيعي. يمكنك أن تعلن عجزك وشللك، وأن تقول: «لا أريد أن أكون جزءاً من هذه المأساة، لا أستطيع!»، يمكنك أن تذهب وتستلقي طوال الوقت على الكنبة وتخدّر نفسك بالموسيقى أو بالمخدرات والكحول، هناك من يفعل هذا فعلاً. أحبُّ هؤلاء المستسلمين، كما أحبُّ المكافحين. ويبدو لي أحياناً أن السوري غير قادر على أن يختار حلاً وسطياً بين هاتين النهايتين.
بعضهم يفكر بالمدى البعيد، ولا يأتون بنشاطات احتجاجية فقط. هؤلاء معرضون لتهمة أنهم يلاحقون مصلحتهم الشخصية، أو أنهم لا يدركون الواقع، أو أنهم ليسوا مع الثورة، أو أن طريقتهم خاطئة. الاهتمام بالنشاطات الثقافية موجود، ولكن كم مرة جاءنا من يقول: «أيام الحرب لا نذهب للمتاحف» أو «أيام الحرب لا ندعو للطعام، كيف أفعل هذا وأهلي في الرقة يموتون من الجوع؟»، بهذه الطريقة نقفل كل الطرق على أنفسنا ونبقى عاجزين.
كما أني لاحظت أن السوريين يحسدون بعضهم بعضاً. وضعي أسهل من غيري، لأني هولندية. ولكن افترضي أن يأتي سوري ليكتب المنشور نفسه الذي كتبته أنا، هذا ليس صعباً. عندها ستنقلب نصف اللجنة على رأسه، وتبدأ الثرثرات ويوضع هذا الشخص خلال وقت قياسي في خانة الأسد. مع أن عملاً كهذا يكلفه كثيراً من الجهد والمثابرة، ولا يدر عليه المال. هذا السلوك ليس تواضعاً من السوري. إنه حسد بكل بساطة، أو طموح كبير عند بعضهم. يرون أن الآخر نجح بشيء لم ينجحوا هم به، وهذا ليس عدلاً، فلا بدّ إذن أن تكون طرقه ملتوية أو دوافعه فاسدة. بالنسبة لي الأمر له علاقة بالديكتاتورية التي عاشوها لمدة أربعين عاماً. عندما يتعلم السوري أن المناصب المهمة توزع فقط حسب المنبت، فلماذا أستغربُ شكَّهُ أن يكون هذا قانوناً يتكرر في كل مكان. هم يعرفون تماماً سهولة الارتشاء بالمال، بالأكاذيب أو بكتابة التقارير. منذ صغرهم وهم يرون كيف أصبح التملق باب الصعود إلى فوق. كل هذه المسائل لم يتم طرحها بشكل جيد للنقاش، لا في الجرائد ولا حتى في البيوت. عندما نأخذ هذا بعين الاعتبار، لن نستغرب من أين جاء الحسد.
سؤال أخير. إلى متى؟ إلى متى ستتابعين معنا المشوار السوري الذي يبدو طويلاً وشائكاً للغاية؟
أتمنى أن يُكتب لي الاستمرار حتى نهايتي. أعرفُ، عن تجربة، أن الصداقات الصادقة لا تموت، حتى بعد الانفصال. الحب ليس فكرة أو منتج اخترعه الإنسان. إنه سرٌّ جميل علينا أن نعتني به، هو كالماء والهواء ليس ملك أحد.
أحياناً يقول لي صديق: «سنعود بعد سقوط الأسد، هل تأتين معنا؟». نعم، سآتي معكم. وأعرف من زمان أني لن ألقى البلد الجميل الذي كان. كلنا نعرف، ولا نعترف، بأن الجحيم ينتظرنا. هل أنا قادرة على هذا؟ لا أدري. ولكني وعدتُ نفسي ألا أتهرب إن كان هذا ما يخبئه لي المستقبل.
لم أكبر وأترعرع تحت وطأة ديكتاتور. لم أتعلق بأرض سوريا وما عندي ذكريات عنها. لا أعرف ما يعني أن تتراكم الجثث وأن أشارك بدفنها، لا أعرف ما هو التعذيب ولم أعان من الخطف. لم أسمع الصرخات، ولم أرَ الناس يموتون من التعب. لا أدري إن كان عندي الحق أن أربط نفسي بالسوريين. ولكني أتمنى أن يكون الكلام والكتابة عن كل هذه المآسي أسهل بالنسبة لي من غيري، لأني لم أمرَّ بها. هدفي من منشور عندما ينخز الصمت أن أقول للهولنديين المهتمين: «لم أكن أعرف، وربما أنتم أيضاً لا تعرفون، كم هو مؤلم هذا الصمت». وسأعيد وأكرر إلى أن يصبح العالم أقل صمتاً.