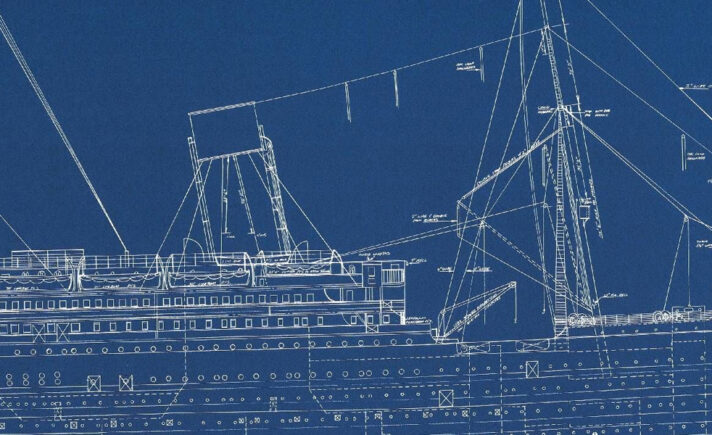حَدَّقَت العين الزجاجية بها فبادلتها التحديق. لم يُثِر شهيتها ما تبقى من طبق السمك الذي حضّرته البارحة، فقد بدا الكائن المسكين الذي أُلقي على الصحن الزجاجي كيفما كان، وفُصِلَ جسده المنهوش عن رأسه، وكأنه تعرّض لعملية تعذيب طويلة خلّفته هكذا: جيفة عارية لم يبقَ من مادتها إلا الألقُ العنيد في عينها.
كانت صفحة السماء في الخارج بعمقِ وانتقاعِ زُرقتها وكأنها طُليت للتو في المصنع.
وصلَت روزا للتو من مكتب الأحوال المدنية في وسط المدنية، حيث أخبرها الموظف المسؤول بأنها، ككل من تبقى من اليهود في البلاد، قد جُرِّدَت من هويتها المدنية، وأن عليها أن تقوم بتسليم وثيقتها ليتم استبدالها بالبطاقة الصفراء. كانت البلاد قد مرَّت منذ وقت قصير بانقلاب عسكري خلَّفَ سكانها مرتعدين من الداخل كالفئران، يفتعلون النشاط اليوميّ والعادي ككذبة لو رددوها مطولاً لصدقوها.
وَقَفَت روزا قرب طاولة المطبخ الصغيرة وطبق السمك الساكن أمامها، ولم تنظر إليه ولم ترفع يدها، وبدت كالنائمة بأعين مفتوحة. ولولا أن النافذة كانت على امتداد بصرها لما رأت السماء. هكذا. بطاقة صفراء إذن. كالنجمة الصفراء. هكذا، هكذا، تدوس علينا هذه البلاد. وكأننا حشرات. وكلّما داست بقوة أكبر، ازدادت اللطخة التي خلّفناها احمراراً.
تذكرت المشهد. كانت بناية الأحوال المدنية مكعباً حجرياً متهالكاً وقف على قارعة الطريق. تذكرت لهجة الموظف المتعالية. تذكرت قوله: يا يهودية. لم يكن كل ذلك غريباً عليها، لكنه كان كالصفعة، شيئاً لم يمتلك الجسد القدرة على الاعتياد عليه.
عندما كانت في السابعة عشر من عمرها، كان لدى روزا صديقتان عزيزتان تسكنان في حيّها نفسه. كان اسم الأولى تمار، واسم الثانية مايا. كانت تمار قصيرة وهزيلة، ولعينيها ضراوة قطط الشوارع، ولبشرتها لون وملمس القمح. أما مايا فكانت على عكسها، طويلة وشقراء وممتلئة الهيئة. وكانت ثلاثتهن تغامرن أحياناً بالخروج من الحيّ اليهودي إلى الأحراش القريبة منه. كان ذلك قبل عام 1941.
كانت حدود العالم أكبر وقتها، وبدا في خوف الأمهات من ابتعاد الأبناء عن الحيّ شيءٌ من المبالغة. كان الخروج من الحيّ إلى رحاب المدينة الفِساح عملية منظمة، يُشرف عليها ويقوم بها الرجال. أما النساء والفتيات والأطفال، فكانوا لا يخرجون إلا برفقة الرجال لحمايتهم من براثن الممكن (مما جعلهم، هم وصبيتهم، ينظرون إلى نساء وفتيات الحيّ بمحبة أبوية وشيء من الكراهية الدفينة، لكونهن في نهاية المطاف غنائم مُحتملة، يجب حمايتها بأي شكل). لم تكن الحال على تلك الشاكلة منذ الأزل، ولم يشتدَّ بلاء يهود البلاد حقاً إلا بعدما أخذ حزب الدفاع الوطني يقرن العقيدة بالحركة الصهيونية في منتصف الثلاثينات.
مع ذلك، كانت حدود العالم أكبر وقتها، وكانت البنات يسترقن سويعات قيلولة أهاليهن، فيهربن إلى الأحراش القريبة ليلتقين خفية بصبية الحيّ بعض الأحيان. وفي حين كانت روزا أكثر الثلاثة فضولاً وجُرأة، لم تُعر تمار الصبية كثيراً من الاهتمام، فقد كانت عادة أكثر انشغالاً بقراءة الكتب أو كتابة الخواطر. أما مايا فشابت تصرفاتها حول الصبية مرارةٌ سبقت عمرها، وكأنها في السابعة عشر من عمرها قد خبرت لوعات الحب وخيباته وتجاوزتها. وكانت كلما سُئلت عن الأمر تصنّعت المعرفة في أمور الحياة وقالت بسخرية شيئاً من قبيل:
– أنا لا ألعب مع الصبية. أنا أريد الزواج من ضابط سيسافر بي إلى الخارج.
ورغبةً منهن بتحرّي العالم الخارجي الذي لم يعرفنه إلا لماماً، كلما ذهبن أو رجعن مشياً من الحارة إلى المدرسة والعكس بالعكس، قامت الفتيات بالهرب خارج الحيّ مرتين، وكان الأمرُ سهلاً، فقد كانت الأحراش تؤول لو خُضتها يمنة حتى النهاية إلى الجزء الشرقيّ من المدينة. لم يُدركن وقتها خطورة فعلتهن تلك إلا عندما وصلن إلى المدينة الغريبة عنهن، والتي كانت، بعماراتها وقببها وأبراجها المتناثرة هنا وهناك، أكثر اتساعاً وتألقاً من مخيّلتهن. وبدت الحشود التي غزت كل زاوية على امتداد البصر كحشرات الغاب بتماثلها وتماهيها مع المحيط. لكن الفتيات لاحظن بعد مرور بعض الوقت نظرات المارة قربهن من الرجال، والتي امتزج فيها الاحتقار بالشهوة. ولفترة طويلة حسبت روزا وتمار أن تلك النظرات كانت حكراً على سكان ذلك الجزء من المدينة، إلى أن أدركتا – كلّ على حدة، وبطرق مختلفة – أنها مشتركة لدى كل الرجال الغرباء. أما مايا، فما فوجئت البتة.
وعندما مررن قرب محمصة جلس أمامها ثلّة من الرجال في متوسط العمر، قال أحدهم بغضب لم يُخفِه:
– يهوديّات. ماذا يفعلن هنا؟
وقال آخر دون أن يحدد المُخاطَب به:
– فليأمرهن أحد بالمغادرة!
كانت تلك من سمات الحقبة، وكانت راديوهات عموم الشعب – خلا اليهود منهم – تُذيع محطة برلين العربية، التي قام غوبلز وروزنبرغ بافتتاحها لمواجهة الدعاية الفرنسية والبريطانية، ووظفوا يونس صالح للحديث منها، ليستهل خطبه العنيفة والمسهبة بعبارته الشهيرة: حيّ العرب من برلين… كانت تلك فترة عصيبة على اليهود، فترة ملاحقات قاسية ومضايقات واعتقالات بتهم تباينت تبايُنَ ساعات النهار: إما الخيانة أو العمالة أو فرية الدم.
عندما عادت الفتيات إلى منازلهن في نهاية النهار أول مرة، اعترتهن الرغبة بالبكاء في الأحراش، لكنهن لم ينبسن ببنت شفة، فما أتاهن من المارة لم يكن غريباً عنهن، وإنما كان شيئاً مما حاول كل أهالي الحيّ الحديث عنه مع أبنائهم وبناتهم، ولم يستطيعوا البوح به إلا بعبارات متشظية وتوريات ملتوية، فقد كان بالألم الذي يسبّبه كالشمس، كُلّيَ الوجود، ولا يمكن النظر إليه مباشرة.
وفي إحدى اللحظات توقفت تمار عن المشي وجلست القرفصاء قرب أرومة لها لون العلف، وكان العالم حول الفتيات داكن الخُضرة، وبدت تمار كمن تنتظر نمو جناحين عند أعلى ظهرها.
سألتها مايا، وكانت رقيقة على غير عادتها:
– ما بك؟ أأنتِ بخير؟
وأومأت تمار. ثم نهضت وأكملت المسير.
ما أحزن روزا كلما تذكرت تلك الأيام هو إدراكها المتأخر أنها لم تعرف أي واحدة من صديقاتها حق المعرفة، وأن تمار ومايا ما كانتا أكثر من عابرتي سبيل في حياتها. ولم يكن ذلك بسبب إهمالها أو قلة انتباهها هي، رغم أن عقلها كانت لديه القابلية التي يُشكَر عليها لشطب الكثير من ذكرياتها بشكل اعتباطي، وإنما لأن سكان الحيّ كانوا دائمي التغيّر، رغم أن الحيّ بحد ذاته لطالما بدا وكأنه لم يبرح مكانه منذ أن ملأت جوف آدم تربة المكفيلة. وكان سبب التغيّر الدائم لسكان الحيّ كل ما حل بهم من اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية وتضييقات ممنهجة لم تترك واحداً منهم بحاله أو تسمح له بالمكوث أكثر من سنة في أي مكان. وقد جعل ذلك سكان الحيّ، وكل اليهود خارجه أيضاً، انطوائيين يرتابون من كل من لا ينتمي إلى السلالة أو القبيلة نفسها، وودودين يرحبون بدفء بكل من نُقل قسراً أو أتى طوعاً إلى الحيّ. كان الحيّ كالكون يبدو وكأنه يتقلص حيناً ويتسع حيناً آخر، وكانت أفراح ومناسبات وعزائم أبنائه في هذا الحقبة المظلمة لا تعدو كونها آليات موروثة للبقاء اليومي. وبعد أقل من عام على خروج الفتيات ثاني مرة، هُجِّرَت عائلتا تمار ومايا. ولم يختلف الأمر كثيراً بعدما نُقلت هي وزوجها إلى حارة أخرى بعد الانقلاب، وعملت لفترة قصيرة كمعلمة مدرسة إلى أن طُردت بسبب الخوف من أثر عقيدتها على عقول الطلاب. عاشت روزا في عزلة داخلية إجبارية أقصتها عن العالم الذي شغلت حيزاً مباشراً فيه. كذلك عاش كل أبناء قبيلتها الذين بقوا على قيد الحياة في هذه البلاد حتى تلك اللحظة.
عندما قررت الفتيات أن يتسللن خارج الحيّ المرة التالية، قامت تمار بسرقة بعض المال من خزنة والدها ودعت مايا وروزا إلى سينما رويال في وسط البلد. كانت السينما وقتها المزار العلماني الجديد لكل السادة والأثرياء. ولم تتورع مايا وروزا عن قبول دعوتها، ولم تسألاها من أين أتت بالمال، فقد عرفتا أن والدها كان تاجر بهارات ميسور الحال إذا ما قورن بباقي سكان الحي.
وفي قاعة السينما الغاصّة، كانت ثلاثتهن الفتيات الوحيدات اللاتي أتينَ دون أن يرافقهن رجل. وعندما جلسن، سرت في القاعة همسات مستغربة وصلتهن بعضها فقابلنها بالضحك بصوت عال. وعندما بدأ الفيلم بدت الصور المتحركة وراء دخان المدخنين وكأنها انبعاثات إكتوبلازمية كادت أن تخرج من الشاشة وتنخرط بالحضور، وكان الشعور ساحراً، وسرت في أبدان الفتيات قشعريرة عندما أخذت ليلى مراد تغني أمام الشط ووجهها الخزفيّ يكاد يخلو من التعابير: الشمس عند الأصيل، راخية شعور الذهب، تسبي العيون، إلى آخره. وهمست تمار لروزا بالعبرية وعلى وجهها ابتسامة عريضة:
– هذه مِنّا!
وكانت تلك أول مرة رأت روزا فيها ابتسامة تمار.
وعندما رجعت الفتيات إلى المنزل عصر ذلك اليوم، استقبلت أم روزا ابنتها بصفعة قوية على خدها، ثم جرّتها من شعرها إلى غرفة نومها ووبختها بعنف، ثم قالت:
– حمداً لله أن الخبر لم يصل إلى والدك.
كم كان كل ذلك غريباً عن روزا التي وقفت في مطبخها الآن. غريباً ومألوفاً أيضاً. كأن كل التاريخ تنويعات على بضع لحظات.
رأت روزا تمار ومايا آخر مرة في محطة القطار، حيث ودّعتهما ولوّحت لعائلتيهما وراء الزجاج، وعندما ابتعدت عن القاطرات واتجهت إلى البوابة الخارجية حيث كان والدها العجوز ينتظرها، نادى عليها جندي شاب وحاول التقرّب منها، وسألها: أتودين رؤية سهامي؟ وكانت لديها فكرة غائمة عن معنى ذلك، فأبت وهرعت باتجاه البوابة.
بين الجذوع الفضية التي لطالما سرحت صوبها هي وصديقاتها، التقت روزا لأول مرة بسليم. كان سليم يكبرها بعامين، وكان على عكس الصبية الآخرين واثقاً من نفسه ومضحكاً حقاً. وكان يرغب بتجميع المال والسفر بعيداً في أسرع وقت ممكن. وعندما قبّلته أول مرة، قاطع قبلاتها بقهقهات خرقاء، وقال:
– أوهوهو! لشفتيك طعمة لذيذة!
وبدل أن تبتعد عنه لتخفي احمرار وجهها وتبكي كما كانت لتفعل، قامت بدفن رأسها في كتفه، واجتاحت صدره موجة حنان مباغتة، فضمّها إلى صدره وقبّلها بدوره، وشعرت هي بأنها تفتّحت من الداخل كتينة.
لكنها لم تعرف إلّا بعد حين أن خفة روحه لم تكن إلا غطاءً عنيداً أسبله على مخاوفه ومكامن قلقه. ولا غرو، فقد كان ابن والديه الوحيد، وكان والده يريد منه أن يُكمل تعليمه على أتمّ وجه، كي يسلّمه في المستقبل عيادته ليديرها عنه. وقال بتعجب:
– تخيّلي! يريد مني أن أبقى هنا. لأعتني بعيادته!
ثم أطرق رأسه.
– لكنني لا أرغب بالبقاء هنا. أريد الخروج. هذه ليست بلادي. أنا غريب هنا.
لم تكن روزا كثيرة الكلام، لكنها كانت ذلقة اللسان، وكانت لديها القدرة على مفاجئته. وقالت:
– أشعرُ هنا بأن السماء مصفوفة بالجدران.
كانا يجلسان وسط بضعة عيون لها لون الصلصال، يعلو حوافها شبه الطُحلب الرقيق، وكانت الأعشاب داكنةً وكأن الظُلمة تلبسها إيذاناً بمجيء الليل في وضح النهار.
– لا أستطيع تمالك نفسي كلما سمعتُ والدي يتحدث عن لطف مرضاه وذويهم من المسلمين والمسيحيين، ليثنيني عن اعتزام السفر. مرة أجبته بحكاية، فأتاني بحزامه. أتودين سماع الحكاية؟
أومأت روزا.
– كان صائد يصيد العصافير ذات يوم، فذبح إحداها وسالت دموعه، فقال عصفورٌ لصاحبه: لا بأس عليك من الرجل، أما تراه يبكي؟ فقال الآخر: لا تنظر إلى دموعه بل إلى ما تصنع يداه. نهاية الحكاية.
ضَحِكت، وأعجبه ذلك فابتسم. وذات مرة كان جالساً صوبها وقال:
– أُحبُّ رفقتك.
ثم بعد قليلٍ من الصمت، أردف:
– لا أود مفارقتك.
فنظرت إليه، ولم يدرِ إن كانت على وشك أن تضحك أم لا، ثم قالت:
– تزوجني إذن!
فنظر إليها، ووخَز العرقُ الباردُ جبينه، وقال:
– من دواعي سروري!
ولم يكن يكذب، وأصبحت ذكرى تلك اللحظة مصدر بهجة رقيقة لهما فيما بعد، ولم يصبر كثيراً على القرار، فأسرّ لوالديه برغبته بالزواج حال إتمامه عامه الدراسيّ الأخير. ولم يمانع أهل روزا لمعرفتهم بحال أهل سليم. وكان العرس حفلاً متواضعاً، دافئاً، خفيض الصوت. وكان الطعام لذيذاً، وكانت التراتيل جميلة.
ورضخ سليم بشكل طبيعي لرغبة والده بالعمل في العيادة، وصار يعمل لديه مقابل ما تيسر من المال ليعيل نفسه وزوجته.
بعد عدة سنين، توفيت أم روزا، وخلّفت ابنتها وحيدة، بلا أهل عدا زوجها. وعندما عاد سليم في إحدى الليالي الطويلة إلى المنزل وجدها مضطجعة على أريكة غرفة الجلوس، تحدق في الفراغ، ووجهها ذوابة وردية ممتقعة من البكاء، فاقترب منها بهدوء، ثم جلس القرفصاء صوب متكئها، وسألها:
– ما الذي يمكنني أن أفعله؟
فبدت ضائعة، تبحث في الفراغ المحيط برأسه عن إجابة، وكانت بالغة الجمال. وسرت رجفة في ذقنها، وكأنها كانت على وشك أن تبكي مرة أخرى، ثم قالت:
– لا أعرف، سليم. أريد أن أنجب طفلة.
قبل أن توافي أم روزا المنية، تضرّعت إلى ابنتها وزوج ابنتها مراراً كي لا يهجراها. وكانت الأم وابنتها وزوج ابنتها قد نُقلوا قسراً إلى إحدى الشوارع الخلفية في أطراف المدينة في نهاية الأربعينات. كانت البناية السكنية التي نُقلوا إليها، والتي تألفت من عدة طوابق كادت تنهار الواحدة منها على الأخرى، مكتظة وسيئة التهوية. وبدت هي ومثيلاتها وكأنها جنادل منبوذة في قلب الفلاة.
أما أهل سليم، فقد تمكنوا من الفرار من البلاد بعدما أحال ثلة من الرعاع القوميين عيادة والده حطاماً قبل ذلك.
لم تتضرع أم روزا بشكل مباشر، وإنما واربت وداهنت حتى الرمق الأخير، ولم تشعر روزا بالشفقة عليها فحسب، وإنما شهدت اجتياح الضغينة البطيء والأكيد كالسرطان في ثنايا سريرتها أيضاً. ولم يمهل خطوَ الاجتياح إلا موتُ الوالدة.
عمل سليم في تلك الأثناء في إحدى المخابز، ثم نادلاً في إحدى المقاهي الشعبية، وكان صاحب المقهى ممن لم يمانعوا توظيف اليهود، ولكنهم استغلوا قلة حيلتهم فقاموا بتشغيلهم عدة ساعات إضافية في اليوم.
قلّما اشتكى سليم من كل ذلك لروزا. كان صاحبه الوحيد في الحارة هو الحلّاق حيمور، الذي ملأت وجهه المربوع آثار الجدري، وكانت بشرته سميكة ودهنية كالخرتيت، وكانت أسنانه تضاهي بصُفرتها بياض قلبه. كان حيمور كلما استمع إلى شكاوى سليم، رَشَفَ الشاي وقال عند الختام، أي والله، وسرح في الأفق المُبيضّ تحت وهج الشمس. وكان لذلك أثرٌ مطمئن على سليم.
لم يشتكِ سليم لروزا لأنه اعتبر نفسه محظوظاً بالمقارنة بها، فقد كان رجلاً قلّما تعرضت حركته لأي عوائق فعلية. أما هي فكانت هدفاً سهلاً للمشاة والموظفين وأصحاب العمل. ولم يكن في اليد حيلة.
حالما اتضح قربُ أجل والدة روزا بسبب المرض العضال الذي ألمّ بها، قالت روزا لسليم:
– هناك شيءٌ أود أن أخبرك إياه.
كان سليم مستلقياً بالقرب منها على السرير. وشعَر بقفزة القلب التي تصحب اللحظات المشحونة بالتوقعات.
– تفضّلي.
– اسمعني. سيبدو ما سأقوله مريعاً.
ضَحِك بتوتر.
– لم يبقَ الكثير على حياة أمي.
– هذا ما فهمته أنا أيضاً من الطبيب.
– لنجهز أمورنا كي نغادر البلاد حال وفاتها.
كانت عيناها تلمعان، واكتست نبرتها حدة غير مألوفة. أما سليم، فلم يرغب بسبر غور أفكارها، فاكتفى بالقول:
– حسناً.
عانقته بقوة، ولم يبارحها شعورٌ بأنها قد اقترفت جُرماً غامضاً بحق أمها عندما قالت ما قالته للتو، كما تأكدت من أكل الضغينة لدخيلتها. أما هو، فود لو كان باستطاعته أن يبوح لها ببعض الأشياء، كالمرارة التي لطالما اعتملت في فؤاده منذ أن هرب والداه واضطُر هو أن يبقى هنا مع زوجته ووالدتها. لكنه اكتفى بتقبيل خدها فحسب.
وعندما رجعت روزا وزوجها إلى المنزل بعد تشييع جثمان والدتها، اتجهت على الفور إلى المطبخ وأخرجت من البراد بضع بيضات – رغبةً منها، على ما يبدو، بتحضير طبق بيض – ووضعتها بقوة على المجلى الرخاميّ، فانكسرت إحداها. وأثار هياج حركاتها قلق سليم، لكنه عَدَلَ عن التدخل. ثم رآها تكسر البيضات بقوة على حافة الصحن، حتى أن صفارها سال على الرخام. وعندما مشى باتجاهها، أحسّت به فاستدارت بعنفٍ ورمت الصحن بقوة على الأرض فانكسر، وقالت:
– ها قد ماتت والدتي الآن. أبإمكاننا أن نرتاح؟
ولم يقترب منها، وإنما اتجه إلى الحمام ليستحم.
افترشت روزا، وهي تحدّق بمربع السماء من المطبخ، عرين اللحظة، منتهى العالم، وكادت أن تنكسر. لم يكن سليم في البيت، ولم تستطع هي المكوث في مكانها، فقررت الذهاب إلى البقالة لتشتري بعض السكر.
كان موعدهما مع المهرّب قريباً، لكنها شعرت مع ذلك ببُعده، ووخَزت حلقها الغصّة. كانا سيستقلان سيارة أجرة إلى السليمانية، حيث سيلتقيان بالمهرّب الذي سيعبر بهما الحدود. وكان المهرّب شاباً عُصابياً ضعيفَ الأطراف كعصفور، ودائم التدخين كمحرّك بخار.
عندما خرجَت إلى الفلاة المتسخة الآيلة إلى الشارع رأت في الفضاء فوقها غرباناً عصماء وأكياساً سوداء. ولاحقتها، حالما وصلت إلى الشارع، نظراتُ العابرين وأصحاب المحلّات. كان الإسفلت حاراً يموّج الهواء الذي يلامسه، وكان الشارع خالياً تماماً من السيارات. استقبلها داخل البقالة شيخٌ كث اللحية. وعندما خرجت وبيدها كيس السكر، فوجئت بمرور صفّ من السيارات العسكرية، ورأت سحنة الشباب السقيمة داخل بعضها، ثم غضت بصرها بسرعة كي لا ينتبه أحد إلى وجودها.
ومَشت. كان هدير السيارات عالياً يهز الأرض. وبعد بضع خطواتٍ تعثرت، فوقع الكيس من يدها وتناثر بعض السكر على الأرض. وفكّرت بما يجب أن تفعله، ولم يخطر على بالها شيء فجمدت، علّ أحداً لا يلحظ وجودها.
لكنها سمعت في اللحظة نفسها صوت إحدى السيارات تتوقف لصقها، فرفعت كتفيها وحدّقت بالأرض كمن يخاف أن يُصفَع. وخرج سائق السيارة وبصحبته عسكريان يحملان الرشاشات. وصاح السائق:
– ما هذا الذي أوقعتهِ على الأرض في طريقي؟
حاولَت روزا دون أن تتجرأ على النظر إليه أن تقنعه أن ما في الكيس لم يكن إلا بعض السكر، لكنه أبى، وطلب منها أن تبرز بطاقة هويتها، وعندما فعلت قال:
– ها. تعالي معنا إذاً.
انحفرت في مقلتيها بضعة أشياء لحظتها، كالنمشات في بزّة السائق، وفوهات الأسلحة المغبرّة وهي تتململ باتجاهها، وأطراف بعض المارة المتجمهرين. واستمر المشهد الخانق بضعة دقائق، إلى أن تجاوز الجمهرة الشيخ صاحب البقالة وكأنه موسى يشق البحر، وحدّث السائق والجنديين قليلاً، ثم طلب منهم العودة إلى الشاحنة ومتابعة المسير بأمان الله. ثم نظر إليها وقال برقة:
– لقد أنقذك وقوفك في مكانك يا يهودية.
ليلاً، عندما نامت، رأت روزا حلماً.
كانت تقف على سطح بنايتها في المساء، وكانت تنظر إلى الأسفل. وعلى امتداد الأرض الخواء، رأت كثيراً من الناس يركضون سعارى هرباً من شيءٍ خفيٍّ ما. ورغم أنها لم تميّز أحداً منهم، لكنها حدست بأنهم يهود. وسمعت من مكانها صوت صرخات حادة وانكسار الكثير من الزجاج.
وعندما التفتت لتطرح السؤال رأت ورائها سماءً بلون الشفق وسهولاً ممتدة تُشع خضرتها وكأنما من الداخل. فمشت باتجاهها ووجدت كل من عرفتهم يوماً: كل أهلها وأصدقائها وجيرانها، وآخرين لم تتذكرهم أيضاً، لكنها كانت متأكدة من أنهم قد مرّوا عليها ولو مرة ذات حين. كما وجدت سليم وابنتها التي كانت بلا اسمٍ وقتها، وعانقتهما. وكانت لابنتها عيناها وعينا والدتها. وكانت لها عينا سليم وعينا والديه أيضاً. كما كانت لها عينا تمار ومايا، وعينا كل الحضور والغائبين، وعينا كل بني إسرائيل.