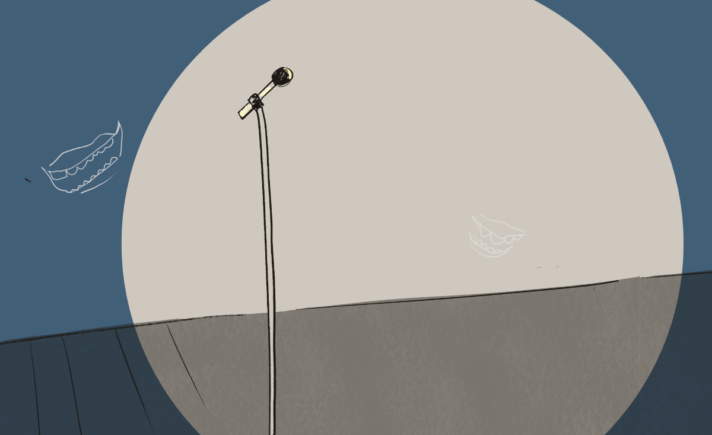تقوم المعادلة السياسية المُثبَّتة دولياً في سوريا منذ بداية الثورة حتى اليوم على محورين: الأول هو منع إسقاط الأسد بالقوة الشعبية الداخلية مهما كان نوعها؛ سلمية كانت أم عسكرية، والثاني هو منع إسقاطه خارجياً وعبر التدخُّل بالقوة العسكرية مهما تجاوز نظامه خطوطاً حمراء، ومهما ارتكب من مجازر ومحارق وبراميل. لا بل إن التدخل العسكري الحقيقي الذي حصل، كان هو التدخل لمنع إسقاطه.
اندرجت تلك المعادلة في سياق الربيع العربي بشكلها الأولي بعد إسقاط القذافي بالقوة، ودخول روسيا على خط الثورات لتثأر من استغفال الغرب لها وعدم إعطائها حصتها في ليبيا، كما لإدراكها أن نجاح الثورات عبر الإسقاط السلمي الداخلي أو التدخل الخارجي قد يتمدد إلى محيطها، وربما ديارها الواقعة تحت لعبة «الديكتوقراطية» التي مثَّلَها تناوب بوتين ومدفيدف على السلطة منذ مايو/أيار عام 2000، حيث أن مسار بوتين منذ استلامه الأول للسلطة حتى اليوم هو السيطرة على جميع مفاصل الدولة حرفياً، ووضع أزلامه وتابعيه على رأس مؤسسات الجيش والأمن والإعلام، والتحكم بمافيا الاقتصاد، إضافة لتصفية رؤوس المعارضة بالقتل أو السجن أو المنفى كما حصل مع المعارض الشهير بوريس نيمتسوف، أو الملياردير الروسي المعارض ميخائيل خودوركوفسكي وآخرين. والمرعب في الأمر -كما يصفه أحد المعارضين الروس- هو أنه لم يبقى أي بديل سياسي حقيقي عن بوتين لحكم روسيا، وهذا بالضبط ما تقوم عليه السياسة البوتينية، مثلما قامت عليه سياسة الأسدين في سوريا، أي منع السياسة بوصفها صراعاً سلمياً لتداول السلطة.
من المعروف أن ترك ليبيا السريع لتتعفن في فوضاها تم تحميله على ظهر تدخل فاشل سابق هو الاحتلال الأمريكي للعراق، فاجتمعت في المشهد الدولي ثلاث صور مخيفة، جميعها جاءت في مصلحة الأسد والروس وجميع الأنظمة المضادة للثورات: صورة التدخل الأمريكي في العراق في الخلفية، وصورة الوضع الليبي الكارثي في المقدمة، تقف بينهما صورة مصر بعد فوز الإخوان المسلمين في قيادتها، و«طحشتهم» باتجاه تديين الدولة وأخونتها. ومن تركيب هذه الصور بدأ انحدار الربيع العربي في المشهد الدولي (المدني والسياسي) نحو أمرين: الخوف من الأسلمة وتكرار «الثورة الإسلامية في إيران» في حال انتصرت الثورات، والخوف من الإسقاط بالقوة بما يكرر الفشل الأمريكي في العراق ثم الدولي في ليبيا، لتؤول الأمور نحو بداية المتلازمة الروسية حول سيادة الدول التي سادت أيام الحرب الباردة، وسقوط مبدأ التدخل الإنساني الذي ساد بعدها، وصعود صوت اليسار المناوئ للتدخل و«الامبريالية» في الشرق والغرب، ثم تَتوَّجَ كل هذا بانقلاب السيسي وبداية الانحياز الدولي نحو الرؤية الروسية لنتائج الثورات.
صعود روسيا في الصراع الدولي كان بمثابة المنجاة لعدد كبير جداً من الدول، مختلفة في المصالح ومتباينة في الرؤى، لكنها سعيدة بالنتائج. فأمريكا الأوبامية جاء من يريحها من عبء التدخل وحتى الضغط باتجاهه، كما جاء من ترمي عليه الحمل الأخلاقي في دعم الأسد الذي ترغب هي بدعمه وتغطيته، ولذلك كان الفيتو الروسي أشبه بالهدية الرائعة والمجانية لأمريكا. أما السعودية وإيران فقد كانا يهللان معاً، مرة لإيقاف الربيع العربي الذي كان في طور التوسع والعدوى والتهديد الديموقراطي، ومرة لاستغلال الثورات في تحقيق أعلى مستوى من التدخل والحرب بالوكالة، فجاء الدعم السعودي والإماراتي لانقلاب السيسي لاحقاً للدعم الإيراني الهائل لبشار الأسد، ومختلفاً عنه كماً وكيفاً وفي كل شيء، ما عدا الهدف الأخير في حماية الديكتاتوريات بوصفها نوعاً من الحماية الاستباقية للذات.
كان عام 2013 هو عام الانقلاب الأكبر ضد الثورات، والبداية المرعية دولياً للثورات المضادة، فبعد الامتصاص العربي والدولي لموجة الثورات التي وصلت أقصى مداها في العام 2012، حصلت في العام 2013 ثلاث ضربات قاصمة للثورات، كانت كفيلة بإعدام أي أفق ديموقراطي للمنطقة على المدى القريب والمتوسط بأقل تقدير، وهي:
1- استغلالُ الاحتجاجات الشعبية الهائلة ضد الإخوان المسلمين في مصر، وانقلابُ العسكر المصري بقيادة السيسي على الرئيس الشرعي المنتخب ديموقراطياً، بدعم سعودي إماراتي وتنسيق أمريكي.
2- تجاوز الأسد للخط الأحمر الأمريكي وإمحائه باستخدام الأسلحة الكيماوية، لتبدأ بعده الصفقة الكيماوية التي سمحت ببداية التنسيق الروسي الأمريكي الإسرائيلي، والتي أعطت روسيا مجمل مخرجات الحل في سوريا، وأعطت الأسد ضوءً أخضر لإبادة السوريين وإبادة الثورة دون محاسبة، ليبدأ نهاية العام نفسه ظهورُ داعش الذي أعلن عن نفسه عام 2014، وتحويل أنظار العالم من القضاء على تنظيم الأسد إلى القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، تلك التي لاقت ترويجاً إعلامياً هائلاً بِعَدِّها بديلاً عن الأسد. وبالفعل منذ عام 2013 بدأ تصاعد عنف الإسلام السلفي الجهادي يتناسب طرداً مع تصاعد الدعاية الإعلامية الدولية الكبرى له؛ وإن كان من موقع الخصم والعدو، بينما يتناسب عكساً مع ضعف الثورة بجميع مكوناتها المدنية والعسكرية والسياسية داخل سوريا وخارجها.
3- بداية المفاوضات السرية الأمريكية/ الإيرانية في عُمان، التي ترافقت مع وصول روحاني لسُدَّة الرئاسة في إيران، والتي كان جوهرها يقوم على تخلي إيران المشروط عن برنامجها النووي مقابل الاعتراف الأوبامي بالتمدد الإقليمي لإيران وضمان عدم إزاحة الأسد ورفع العقوبات الاقتصادية الغربية التدريجي عن إيران.
تلك الثلاثية التي حصلت عام 2013 ثبَّتت مجموعة من النتائج، كان من الصعب؛ إن لم يكن من المستحيل، تغييرها. فبالمعنى الإسرائيلي والغربي عموماً، تم التخلي عن خطرين كبيرين هما السلاح الكيماوي السوري والنووي الإيراني، وهو ما يصب في أمن إسرائيل ويفتح شهية الدول الغربية للاستثمار الاقتصادي في الأسواق الإيرانية الواعدة، ومن جهة أمريكا، الأوبامية وقتها، كان ذلك يعني من ضمن ما يعنيه، ليس التفرغ للصين وإكمال وعود أوباما بالانسحاب من المنطقة فحسب، بل ترك التوترات السنية/ الشيعية التي بدأت بالوضوح والسطوع أكثر من أي وقت مضى، لتستنزف كلاً من إيران والسعودية معاً، إضافة للدول الواقعة في محور الصراع، وتجعل من كلا البلدين الغنيين بالنفط والموارد، أكثر مرونة في تقديم التنازلات؛ لأمريكا أساساً ولكن للغرب وروسيا والصين أيضاً، وأكثر حاجة للتغطية الدولية على حروبهما بالأصالة أو بالوكالة في المنطقة برمتهما، ولذلك كانت تصريحات أوباما تركز على احتمال بقاء الحروب في المنطقة لثلاثين عاماً قادمة.
بالمعنى الغربي أيضاً، كانت التجربة المصرية القصيرة مع الإخوان المسلمين كافية لزيادة حُمّى الإسلاموفوبيا وزيادة المخاوف من مخرجات الثورات، فكانت الموافقة الضمنية ثم الصريحة على انقلاب السيسي بمثابة نقطة حاسمة لتفضيل العسكر على الإسلاميين، حيث بدأت فكرة الاستثناء العربي من موجات الديموقراطية في العالم، وهي الفكرة التي كانت سائدة قبل عام 2011 في مجمل مراكز البحث الغربية، بالعودة للحياة والنقاش بعد أن غيَّبها انبثاق الربيع العربي المفاجئ ووعوده الأولى بتجاوز ثنائية العسكر والإسلاميين نحو ديموقراطية حقيقية.
المكسب الروسي بعد عام 2013 كان مضاعفاً، فإذا كانت روسيا البوتينية قد تلقت العديد من الخسائر والصفعات الاقتصادية عبر العقوبات الغربية إثرَ غزوتها في أوكرانيا في الشهر الثاني لعام 2014 واحتلالها لشبه جزيرة القرم، فإن ذلك لم يمنع الانتصار الجوهري لحقيقة استراتيجية كانت روسيا قد خسرتها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، وهي عودة مبدأ احترام سيادة الدول القائم على لعبة التوازن الأمني والتلازم النووي بين روسيا وأمريكا الذي كان سائداً أيام الحرب الباردة، وبداية نهاية مبادئ حقوق الإنسان وإمكانية التدخل الإنساني الذي ساد بعدها، وهذا بالمجمل يعني العودة لسلطة الدولة مقابل سلطة المجتمعات المدنية/السياسية، والعودة لأولوية الأمن على الحريات، وأفضلية السيادة على السياسة، وتقدم أسوار الدول القومية على انفتاح المجتمعات المعولم، وأخيراً سيادة التنظير الجيوسياسي القائم على رؤية البُنى الكلية؛ «مؤسسات الدولة» أجهزة المخابرات، حجم الجيوش ومعداتها.. إلخ، على التحليل الاجتماعي السياسي الذي يهتم بحركة الشعوب ويستند إليها بدل النخب الحاكمة، ويستند إلى قوى المجتمعات الحيوية بدل البنى المغلقة، وديناميكية التغيير من تحت بدل ستاتيكية التحكم في التغيير من فوق.
منذ عام 2013 أيضاً بدأت مفاعيل المكسب الروسي، وتحته الإيراني ثم الأسدي، تنتقل بخطوات متدرجة ومتصاعدة نحو مختلف دول العالم، فصعود الإرهاب غير المنظم للتنظيمات صعَّد معه الإرهاب المنظم للدول عبر سنّ قوانين مكافحة الإرهاب التي هي بمثابة البديل عن إعلان حالة الطوارئ، أو الشريكة لها في أحيان أخرى، كما أن عدوى الثورات الديموقراطية التي بدأت بالانتقال إلى وول ستريت ولندن بعد عام 2011، انقلبت إلى عدوى الحاجة للقوة والتسلط والحزم التي مثَّلها بوتين وغيّبها التردد الأوباموي، وليس بعيداً عن نتائج ذلك ما حصل في السنوات الماضية من صعود اليمين الأوروبي والأمريكي، ليصل إلى فوز دونالد ترامب ووصول اليمين الأوروبي إلى نتائج غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. كما أنه ليس بعيداً عن ذلك أيضاً، انقلاب الخط التركي الصاعد سابقاً نحو المزيد من الديموقراطية والمدنية والتصالح مع الأكراد و«الصفر مشاكل»، إلى الانحدار الصاروخي نحو التسلط الأقرب للنمط البوتيني والخراب الكلي للعلاقة مع الأكراد والاقتراب من «الصفر ديموقراطية» الحاصل اليوم.
نتائج الفيتو الروسي الذي حمى شرعية الأسد في الأمم المتحدة حصدته روسيا عبر التدخل العسكري «الشرعي» في سوريا في أيلول 2015، طالما أنه بطلب من حكومة «شرعية» تحت سقف الأمم المتحدة، وبذلك أصبحت سوريا والشعب السوري عبرةً لمن يعتبر من شعوب المنطقة، والعالم أيضاً، فالرسالة الواضحة والمعممة للشعوب والأنظمة الحاكمة معاً، هي أنه ليس على الطغاة ومجرمي الحرب سوى التنسيق مع قوة عظمى في مجلس الأمن إن أرادوا ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعوبهم، وأنه ليس لدى الشعوب من مخرج سوى القبول بطغاتها أو التعرض للقتل والنزوح والهجرة الجماعية، فمنذ الآن ليس أسهل على الحكومات من اتهام كل اعتراض أو معارضة بالإرهاب، وليس أسهل على الطغاة من الانتقال من الإبادة السياسية لخصومهم إلى الإبادة الجسدية لمعارضيهم أو زجهم في السجون، حيث قوانين مكافحة الإرهاب بالمرصاد والحماية الدولية للطغاة جاهزة. ليس على كل طاغية صغير سوى بيع سيادته وثروات بلاده إلى قوة عظمى، ليصبح شريكاً دولياً ضد أعدائه في الداخل. وبالفعل بدأنا نرى منذ عام 2015 حجَّ الطغاة والراغبين بالطغيان نحو موسكو، من مصر إلى تركيا ومن إيران إلى الجزائر مروراً بدول الخليج فرادى وجماعات، ولم يعدّل هذا الحج باتجاه موسكو سوى وصول ترامب للحكم في أميركا، لتصل وقاحة طلب «الجزية» مقابل الحماية حدوداً لم تصلها منذ زمن الامبراطوريات القديمة، ويصبح ترامب وبوتين وجهَيّ، بل وِجهَتَيّ النظام الدولي الجديد، النظام القَبَلَي وما بعد الحداثي في آن.
التحول العالمي لمعادلة منع إسقاط الأسد داخلياً أو خارجياً لم يعنِ إلا شيئاً واحداً بالنسبة لمنطقتنا، هو العودة للنمط القديم الذي ساد علاقة الدول الكبرى بالانقلابات العسكرية التي تلت مرحلة الاستقلال وتعميمه، بحيث تتكفل الأنظمة العسكرية/ العلمانية بقمع شعوبها، بينما تتكفل الدول الكبرى بحمايتها وإضفاء الشرعية الخارجية عليها مقابل عمالتها الكاملة وسرقة ثرواتها التي هي ثروات الشعوب. والمعروف أن ذلك النمط جَعَلَ من دول المنطقة تُختَصر بأنظمتها عبر عضوية ومساواة السلطة بالدولة دون باقٍ، وجَعَلَ من شرعية تلك الأنظمة داخلياً ليست أكثر من شرعية القوة المحضة، وسياستها ليست أكثر من الحرب على الشعب والإبادة السياسية؛ والعسكرية إن اقتضى الأمر، للخصوم والمعارضة.
ولكن سؤال اليوم الذي يطرحه إعادة تأهيل الأنظمة العسكرية من جديد هو: هل ينجح ذلك النمط القديم من الاتكاء على الأنظمة لقمع الشعوب ومنع الديموقراطية بعد ثورة الاتصالات والمعلومات والعولمة، وثورات الربيع العربي، مثلما نجح سابقاً؟ حتى الآن يظهر على أنه ناجح في مصر، وتحثّ تركيا الخطى نزولاً نحو الطريقة المصرية، بينما يتم إنجاحه بالقوة في سوريا عبر إبقاء الأسد حاكماً فوق الركام والمجازر، ولكن هذا الطريق نحو استعادة النمط القديم، لن يكون معبداً بالسهولة التي مرَّ فيها سابقاً، بل هو طريق حروب أهلية مستمرة ومديدة، فبعيداً عن غياب العدو الخارجي المُوحِد والمُوحَد الذي كان عماداً لصناعة الديكتاتوريات المركزية في السابق، والانقسام الأفقي والعامودي للمجتمعات الأهلية، هناك حقيقة واضحة باتت أكبر من إخفائها القسري الذي يحصل اليوم عبر ما يسمى الحرب على الإرهاب، وهي أن شعوب المنطقة التي كان من السهل إغفالها وإغلاق أفواهها والتحكم بمصائرها عبر الأيديولوجيات الكبرى والعدو المشترك وبروباغندات الإعلام المركزي الموحد والخطابات القومية أو الإسلامية الرنانة وشعاراتها الجوفاء… إلخ، هي شعوب لم تعد قابلة للتحكم والسيطرة كما كانت قبل عام 2011، فالوعي الجمعي للسوريين مثلاً، تمّت خلخلته بالكامل. إسرائيل؛ العدو التاريخي، لم تعد أسوأ أو أخطر من إيران، ونظام الأسد لم يعد نظاماً وطنياً أو ممانعاً حتى في عين موالاته، وحزب الله لم يعد حزب مقاومة كما كان يراه الحسّ العام عام 2006، والإسلاميون لم يعودوا ممثلين لطريق الخلافة الأخضر حتى في عين المسلمين الصراطيين.
لقد بات الانكشاف أكبر من أن تغطيه دعوة أو بروباغندا أو «أخوة» أو إيديولوجيا أو عقيدة أياً كان نوعها، وتجربة السوريين المريرة، والتي أُريد منها أن تكون درساً للجميع، ربما أصبحت درساً مؤقتاً بالفعل، لكنها لن تعيد الشعب السوري، ولا شعوب المنطقة، كما كان وكانت. لن تعيده صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة، فبعيداً عن أن «القيادة الحكيمة» باتت خاضعة شرعياً لاحتلالين على الأرض، فإن القسر الذي يحتاجه تركيب شعب سوري واحد، يجمع الأكراد مع العلويين مع السنة مع الدروز وغيرهم، تحت بسطار عسكري مركزي واحد وبالقوة، سيتجاوز القسر الذي تعرّض له السوريون حتى اليوم لكي يحقق نتائجه، وهذا بالمجمل لن يخدم مطالب الأمن والاستقرار التي باتت تحتاجها وتسعى نحوها روسيا وأمريكا وأوروبا، لكي تتناهش امتيازات ما بعد الحرب، وتقلل من خطر الإرهاب والهجرة والنزوح. ولذلك فإن الاعتماد على ديكتاتور عسكري على طريقة زمن ما بعد الاستقلال؛ وإضافة إلى أن تناقضاته الذاتية أكبر من حمله، لن ينجح مهما دعمه بوتين أو رغب فيه ترامب أو عززه ماكرون، كما أن نجاحه الظاهر في النموذج المصري تحت حكم السيسي، يَعِدُ بالأزمات والانفجارات الأهلية والدول الفاشلة، أكثر مما يَعِدُ بأي استقرار ممكن.