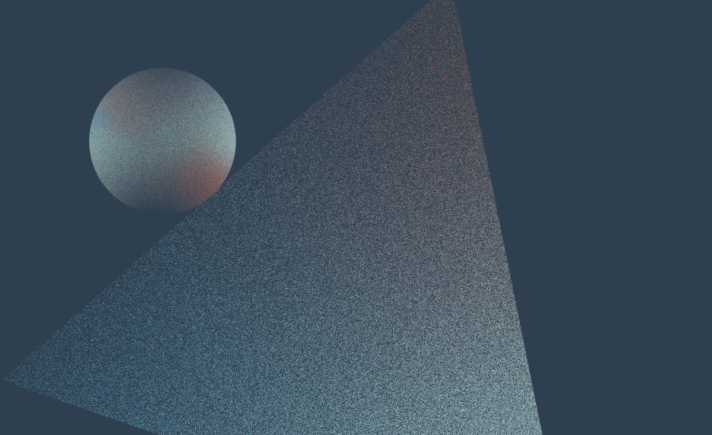طرح ياسين الحاج صالح مادة غنية فكرياً في الجمهورية، تضمنت معالجة واضحة لمعظم مفاصل الصراع السوري الأساسية، وتفكُّراً جريئاً وجدّياً في الحل السوري على أسس عادلة. لكنني سأتوقف نقدياً في هذه الورقة، عند مسألتين أساسيتين ومترابطتين في طرح ياسين، وهما فكرة الأكثرية السياسية السورية العابرة للطوائف، وفكرة العلاقة بالمجتمع الدولي، إلا أنني لن أتناول تلك الأفكار من باب «الحل العادل لصراعنا» حيث لا حل عادلاً لصراعنا، «فمن تعنيهم العدالة يفتقرون إلى القوة، ومن يملكون القوة لا تعنيهم العدالة»، كما يعود ليؤكد ياسين في نهاية المقال نفسه.
يبدأ ياسين بالوضوح التالي: «الحل العادل في سورية يقوم على بناء أكثرية سياسية جديدة في البلد، تتعرف فيها أكثرية متسعة من السوريين على تمثيلها السياسي، فتقطع مع الحكم الأقلي (الأوليغاركي)، وتؤسس لسورية جديدة بنظام سياسي استيعابي.وهو ما يقتضي التخلص من الحكم الأسدي، ومن داعش وأي مجموعات سلفية جهادية، والمساواة السياسية والثقافية للكرد دون سيطرة قومية، والتأسيس لسورية ديموقراطية قائمة على المواطنة». وهذا تصورٌ عادلٌ فعلاً، لكنه بالمقارنة مع ثلاثة معطيات إشكالية راهنة، يبدو بعيد المنال على المدى القريب، وربما المتوسط. أولى تلك المعطيات هو الشعب السوري المُستنزَف والمشتت والمنقسم، والمُحتَل فعلياً باحتلالات مركبة، داخلية وخارجية. والمعطى الثاني هو النظام الأسدي المتشبِّث بالسلطة حدَّ الإجرام، والذي لا تنفع معه أي حلول سياسية ممكنة مهما كانت، والذي لن يترك السلطة إلا «بتكسير الرأس» كما أثبتت سنوات الثورة الطوال. والمعطى الثالث والأخير هو المجتمع الدولي الذي لا تعنيه من قريب أو بعيد أي عدالة ممكنة، والذي يمرُّ؛ لسوء حظنا، بمرحلة «انتقالية» من الفوضى واللاقطبية وفقدان المركز، والمتجه أكثر وأكثر نحو بعض توصيفات هنتنغتون حول الصراعات الحضارية على أسس ثقافية، وأفول الغرب بمعناه العالمي وتوجهه نحو التقوقع وحماية الذات، وكل ذلك في عصر العولمة الذي يتجه موضوعياً نحو التوحُّد أكثر من أي وقت مضى، لكنه يتجه ذاتياً و«إرادوياً»؛ عبر أهم قادته وسياسييه وسياساته، نحو التشظي والتشقق وصيانة الحروب، ثم التوحُّد في الخراب.
هل يمكن بناء أكثرية سياسية واجتماعية عابرة للطوائف؟
الجواب الأولي؛ والمؤقت غالباً، هو لا. لماذا؟ لأن ذلك يحتاج إلى تفعيل السياسة بدل الحرب، وأن تكون السياسة حداً على الحرب، وليست تمثيلاً لشروطها وفرضاً لنتائجها على الأرض، مثلما يحتاج إلى محيط إقليمي أقل عدائية وأكثر استيعاباً ودعماً (إسرائيل وإيران نموذجاً)، ومجتمع دولي أكثر ثباتاً وتوازناً، وهذا غير متوافر. مثلما يحتاج بناء الأكثرية الاجتماعية العابرة للطوائف إلى حدٍّ أدنى من الاستقرار والأمان وإمكانية العودة، ومشاركة السكان في اختيار ممثليهم دون ضغط السلاح وتهديد الوجود والمخاطرة بالحياة ذاتها.
ما يرجح بناءه كمرحلة أولى بعد أسدية؛ في حال بدأت، هو تعدد أقلوي، أكثرية سياسية مركبة إثنياً وطائفياً ومناطقياً وجهوياً وربما جندرياً، «أكثرية أقلويات» توافقية لكن متنازعة ومتنافسة، وذلك لا يتبع لعدم توحد السنة كطائفة كما أثبتت سنوات الثورة، وكما بيَّن ياسين في مقاله، بل لتوزع مراكز السلطة والثروة والنفوذ والمصالح في مناطق سوريا، والانقسامات الحالية والقديمة المتعددة الوجوه. لكن هذا لا يشكل خطراً بحد ذاته على وحدة سوريا كأرض، بل إن خطره كامن في تثبيته، والرعاية الدولية لاستمراره وتكريسه، وهو ما يحول دون إعادة أي نوع من الاندماج الوطني وتشكيل الشعب السوري من المواطنين المتساوين، ويحوِّل المنازعات السياسية والخصومات المصلحية إلى حرب أهلية باردة أو مشتعلة، تثبِّت زعماء الطوائف والإثنيات والمناطق في زعامتهم، وتبني بينهم تحالفات قوامها تثبيت الوضع القائم؛ مثلما هو حاصل في لبنان، بحيث لا يتضرر إلا الأهالي والفقراء والمجتمع المدني، ولا ينجو إلا الممتازون والزعماء وأزلامهم الاقتصاديون والعسكريون.
إذا نظرنا إلى الواقع السوري مثلما شكَّلته الحرب، سنجد أننا بتنا نمتلك في الداخل ما هو شبيه بواقع المجتمع الدولي وإن بطريقة أخرى ومختلفة، فهناك العادلون ليسوا أقوياء، والأقوياء ليسوا عادلين، وهنا الطائفيون هم الأقوياء وغير الطائفيين لا يملكون القوة. لننظر إلى البغدادي، والجولاني، وصالح مسلَّم، وقادة جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الغوطة، ومشايخ العقل وميليشيا الدفاع الوطني في السويداء، بالإضافة لقادة تنظيم الدولة الأسدية في مناطقها طبعاً. من مجمل هؤلاء، وهم الأقوى على الأرض، لا يمكن تشكيل أكثرية وطنية عابرة للطوائف بالتأكيد، أو على الأقل سيكونون حجر عثرة كبير أمام أي أكثرية محتملة من النوع الذي تحدث عنه مقال ياسين.
لكن هنا سنناقش الموضوع من وجهة أخرى، فمن الصحيح أن الغرب، أو بالأحرى كل الدول المتدخلة في الصراع السوري، ترانا بشكل طائفي، وذلك عبر نظرة تطييفية، تتضمن، لكن تتجاوز بكثير، المعنى الديني نحو المعنى السياسي، وترانا منقسمين في كل شيء ولسنا أهلاً للثقة، وبالتالي يجب حمايتنا من أنفسنا عبرهم. لكن تلك النظرة ليست خاطئة تماماً على الرغم من كونها ليست صحيحة أيضاً، هي بالأحرى خاطئة قليلاً تصبح صحيحة كثيراً من خلال الفعل والدفع، وهو دفع طائفي تقوم به الجهات الخارجية دائماً وفي كل وقت، ومنذ البداية، وهو عملٌ يومي لنظام الأسد منذ اليوم الأول للثورة، وعملٌ أيضاً للميليشيات الشيعية وحزب الله اللبناني، ثم أصبح عملاً معكوساً في الاتجاه، موازٍ في النتيجة، للعديد من الفصائل الإسلامية السلفية والسلفية الجهادية المقاتلة، وعلى رأسها داعش والنصرة، دون أن ننسى عمل النخبة الطائفية المثقفة والسياسية أيضاً، من أدونيس وصولاً للؤي حسين وغيرهم كثر من كل الطوائف والملل والنحل، وهذا العمل الطائفي المدفوع من كل الجهات السابقة يطيِّف المجتمع فعلاً، ويدفعه أكثر نحو الطائفية والتقوقع والتحصُّن بالطائفة.
المغزى من هذا الكلام ليس التأكيد على جوهرانية الطائفية، بل بالعكس، التأكيد على بعدها السياسي القابل للتحول والتبدل، والقابل للمواجهة أيضاً، ليست المواجهة بالتعالي ولا بالنكران ولا بالـ «عبر طائفية»، بل مواجهة الطائفية من خلال الطوائف والمناطق والإثنيات ذاتها ومن قبل أهلها، وهذا ما منعه نظام الأسدين سابقاً عبر رعاية السرديات الطائفية والانقسام الطائفي بطريقة مُبطنة، وتثبيت الوعي الذاتي للطوائف والتمثيل الطائفي في حنايا الدولة، وما يمنعه حالياً استمرار الحرب وصوت الرصاص الذي لا يعلو صوتٌ فوق صوته، وهذا ما أثبتت «مظاهرات الهدنة» في آذار الماضي ضد جبهة النصرة أنها جاهزة لمواجهته عندما يخرس الرصاص ويحلُّ قليلٌ من السلام.
وفي هذا السياق أجد من الضروري التأكيد على عكس ما هو شائع، وهو المادة الأولية المعاصرة الموجودة لدى الأجيال الجديدة والمفتَقدَة لدى الأجيال الأقدم، حيث أن الروح الفردية وعدم الرغبة في التنظيم والعزوف عن التحزب والالتزام الإيديولوجي عند الشباب والأجيال الجديدة، هو ظاهرة مهمة لا بد من رؤيتها والاستفادة منها والوثوق بها ووضع الآمال حتى عليها، فنحن نشهد حالة شبابية عامة عابرة للطوائف منذ بداية الربيع العربي، تشي بنهاية عصر القائد الملهم، والرجل المقدس، والحكيم المؤله، وهذا وضع أساسي ومؤسس للثورة أصلاً، وهو ما ينطبق على حالة عدم الإجماع على شخصية وطنية أو طائفية أو سياسية في كل سوريا. ومع أن هذا الوضع «الموضوعي» كان من حسن حظ بشار، ومن سوء حظ المعارضة التي بقيت مشتتة دون إجماع، ولا أملَ فيها تجاه أي إجماعاتٍ قادمة، إلا أنه وضع غير قابل للرد أو الارتداد نحو الوراء، فعلى الرغم من الضغط الهائل للحرب، والمحاولات المتواترة لصناعة الأبطال، وقيادة الشباب و«الجماهير» خلال السنوات الماضية، إلا أن كل الشخصيات التي لاقت إجماعات معينة لدى الموالاة أو المعارضة، لم تتمكن من التحول لرموز مرشدة طويلة الأمد، بل كانت أقرب «للنجوم» التي يسطع نورها ولا تلبث أن تنطفئ ويتم تجاوزها، مما يدل على نهاية تلك الظواهر القديمة «موضوعياً»، ويُرجَّح أن تلك الإجماعات لم تكن إلا مشروطة أو ظرفية أو حاجوية وتابعة للحاجة، فمن الواضح مثلاً أن إجماع الموالين على بشار لا يتضمن أي احترام لشخصه، ولا أي إحساس بعظمته أو عظمة أي من شبيحته الكبار من أمثال عصام زهر الدين أو سهيل الحسن، وبالمقابل لم تجد الشخصيات الوطنية السلمية أو العسكرية أو السياسية في المعارضة أي إجماعات مهمة إلا بعد موتها، وهذا يصح أيضاً بالمعيار الطائفي ثم الديني والإثني، حيث لم تنوجد أي شخصية دينية ضمن أي طائفة أخذت إجماعاً أو التفافاً شعبياً يمكن معه القول إنها استطاعت، أو تستطيع تحريكها ككتلة واحدة.
هذا الوضع الشبابي الذي حرم الثورة من تشكيل البديل المنظم والمنضبط، والذي يبدو كمشكلة اليوم، هو المالك لمفاتيح الحل باعتقادنا، وهو الحامل الموضوعي لتجاوز الطائفية مستقبلاً، وهو المانع «الموضوعي» لنهوض الديكتاتورية من جديد، بعد موتها في الرؤوس والقلوب، وتحطيمها وتحطيم تماثيلها في الواقع.
حول العلاقة بالمجتمع الدولي
أقام نظام الأسدين كيانه، ومنذ البداية، كوسيطٍ أمنيٍ للدول الكبرى والإقليمية في سوريا ومحيطها، ففعَّل تشابكاته الأمنية في قضايا المنطقة، لكي يبقى حاجة ماسة لمختلف اللاعبين، ويضمن بقاءه في السلطة «إلى الأبد»، وهذا الدور الخارجي، الذي انبنى على حساب الشعب السوري، كان مفخرة العهد الأسدي الأول، على اعتبار السياسة الخارجية السورية من أذكى السياسات وألمعها، أما في الحقيقة، فقد كانت تلك السياسة من أقذر السياسات المافيوية حرفياً، كونها تعمل لصالح جميع الأطراف، وتحقق مصالح الجميع باستثناء المصلحة الوطنية السورية، وعلى اعتبارها سياسة أمنية في أصلها وفصلها، فقد كانت تحقق سراً ما تقول عكسه تماماً بالعلن.
وإذا عرفنا أن الأسد الأب بدأ بذلك مذ كان وزيراً للدفاع، عندما سلم الجولان دون قتال (لواءان مدرعان إسرائيليان مقابل تسعة ألوية سورية أمرها الأسد بالانسحاب دون مواجهة)، ثم قام بحربه الخلّبية ضد إسرائيل ليحرر القنيطرة من سكانها، وينزح ثمانون ألفاً منهم إلى نواحي دمشق. لن نستغرب إذاً كيف كان حليفاً موضوعياً لإسرائيل في لبنان، وكيف لعب الدور الأساسي بإخراج منظمة التحرير الفلسطينية منه، ليحتله وينصب فيه «مفخخة» حزب الله «الإيراني»، ويصبح بعدها «عشيقاً مرذولاً» لإسرائيل، ويضمن تماماً ما عاد وقاله حرفياً رامي مخلوف في بداية الثورة، أن أمن سوريا، ويقصد النظام، من أمن إسرائيل. وربما أكثر من واضح اليوم، أن الأسد الصغير لم يعد رئيساً فعلياً لسوريا، بقدر ما هو مندوبٌ سامٍ لإسرائيل، ومندوبٌ عسكري لإيران، وربما نائب وزير الدفاع لروسيا، وحاكم عسكري لمناطقه. كما أنه ليس ممثلاً حتى للعلويين بقدر ما هو يحميهم ليحتمي بهم، ويقتلهم ليقتل بهم.
يمكننا أن نسرد كثيراً من التفاصيل حول الوظائف الأمنية التي لعبها وحققها النظام السوري للدول المتناقضة والمتنافسة، والمتنازعة أحياناً، في المنطقة دون أن يقطع شعرة معاوية مع أي منها، لكن ما نريد التركيز عليه وما يهمنا هنا شيء مختلف، وهو التخوف من انتقال العدوى الأسدية وسياستها الوظيفية للمرحلة ما بعد الأسدية، وهو أيضاً ذلك النوسان المصاحب للثورة بين حدّين متناقضين في العلاقة مع المجتمع الدولي.
الحدّ الأول، هو الخضوع المطلق لما تمليه الدول المتزاحمة في سوريا، وهذا حال العديد من الفصائل المعارضة الثورية، بالإضافة للبيدا الكردية التي تبزُّ الجميع في الوظيفية والأداتية.
والحدّ الثاني، هو الخطاب الوطني الثوري الرافض لأي علاقة تبعية أو خضوع للدول الممولة والمتدخلة، وهو الخطاب الطامح لسوريا مستقلة بقرارها الوطني بعيداً عن المصلحة الخليجية أو الإيرانية أو الروسية أو الأمريكية أو التركية أو الإسرائيلية. وهذا الاستقلال الوطني هو ما نحا نحوه مقال ياسين عند الكلام حول العلاقة بالمجتمع الدولي، القوي والمنحط وغير العادل. فإذا كانت العمالة؛ التي يمثل أقصى حدودها النظام الأسدي اليوم، غير مقبولة، فإن الاستقلال الوطني بالمعيار المطروح، هو أيضاً غير ممكن في المدى القريب وغير عملي سياسياً.
وربما شكَّل هذان الحدان الأقصيان، ما نسميه «وعياً شقياً» عند المعارضة السياسية والشعب السوري بالمجمل، فبينما كان النظام يبيع سوريا لإيران وروسيا، ويقدم مناقصاته الكيماوية لإسرائيل وأميركا، بحلٍّ من أي مبدأ أخلاقي أو مسؤولية وطنية، بل فقط ليضمن بقاءه فوق الخراب، أحرقت المعارضة نفسها في التناقض والنوسان بين ما يرضي الدول المتدخلة وما يرضي الرغبة الشعبية الثورية التي تحاول تمثيلها، والتي لا مكان لها من دونها.
إن انحطاط المجتمع الدولي فيما يخص قضايانا ليس جديداً، وإن وصل إلى حدود جديدة وموغلة في الانحطاط، لكن ذلك لا يجب أن يدعونا لصرف النظر عن مشاكلنا الذاتية أيضاً، وهي كثيرة وكبيرة و«تاريخية»، ونعتقد هنا أن مساحة السياسة وممكناتها مفتوحة بين هذين الحدين الأقصيين، بين العمالة والوطنية المصفّاة، بين تعليق المشاكل على الخارج كلياً، وجلد الذات واعتبارنا «متخلفين» ومرضى لا أمل بشفائنا، إلا بتغيير الرؤوس على ما قاله أدونيس وغيره. ولا بد من التخلّص من تلك الطروحات «الجوهرانية» في سياستنا وثقافتنا، التي عمادها التعالي والخضوع المتماهي بالأقوى والهرب من المشاكل الذاتية، والتي لا توصل فعلياً إلا إلى طرق مسدودة في السياسة كما في الثقافة.
ركز ياسين على خلق سياسة جديدة، و«إبداع مؤسسي» و«تسوية تاريخية كبرى»، واعتبرَ أن المحن والصراعات الكبرى هي بيئة مناسبة لهذا الخلق والإبداع، وبالفعل لابد لنا من هذا الخلق، الذي نرى أساسه في القطع مع مورثاتنا الأسدية، تلك المورثات التي تركت فينا أعمق التناقضات، بين العلاقة العدائية بالعالم والمظلومية تجاه الذات والداخل، العمالة والوطنية، السرية والعلنية، العمالة في السر والممانعة في العلن. لا بُدَّ من التخلص من هذا الحمل «التاريخي» الثقيل في السياسة كما في الثقافة، إن أردنا التأسيس لسياسة جديدة وثقافة مختلفة، وربما بات من نافل القول، أن التخلص من الأسدية ليس إلا البداية لهذا الطريق الطويل.