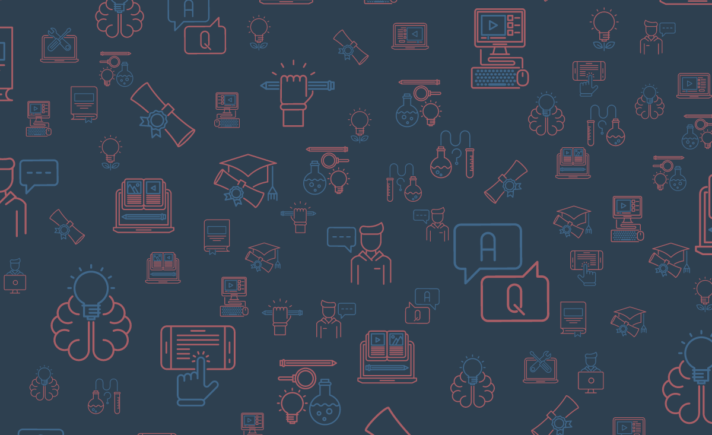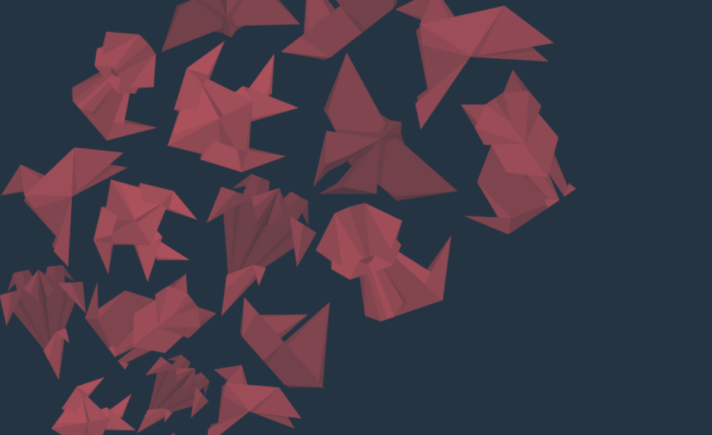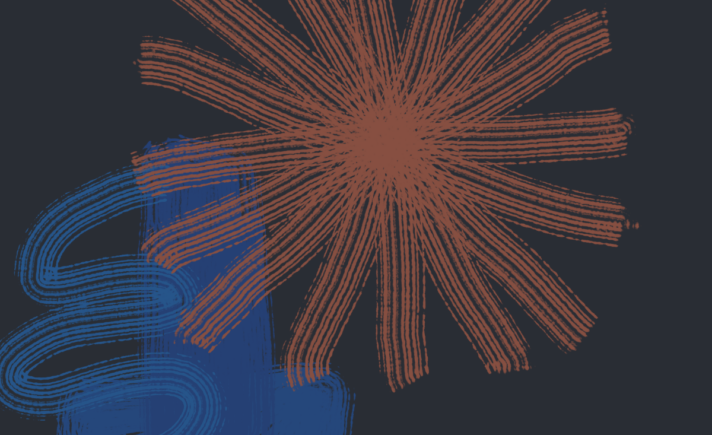منذ أواسط التسعينيات وفي مطلع الألفية الجديدة، نشأت في لبنان عدة مجموعات يسارية حملت نقداً للستالينية، وعبّرَت عن ضرورة تجاوز الإرث الثقيل لـ«الاشتراكية» بصيغتها السلطوية، التي اتخذت شكل البعث والناصرية في العالم العربي، وشاركَ في هذه المجموعات اشتراكيون ديمقراطيون وبيئيون وعلمانيون وأمميون وماركسيون وتروتسكيون وناشطو حقوق إنسان.
انتسبتُ إلى أحد هذه التنظيمات لأول مرة عام 2005، وكان يُعرف بـ«التجمع اليساري من أجل التغيير». منذ مطلع 2011 تشكلَ «المنتدى الاشتراكي»، بعد أن اندمج فيه تجمعان: التجمع الشيوعي الثوري المنتمي إلى الأممية الرابعة، والتجمع اليساري المنتمي إلى التيار الاشتراكي الأممي. كان لانضمامي «للتجمع» ومن ثم «المنتدى» أثرٌ كبيرٌ في تشكل وعيي النسوي
لعبت الرفيقات منذ مطلع الألفية الجديدة وصولاً إلى اليوم، بمن فيهن اللواتي غادرن التنظيم لأسبابٍ مختلفة، دوراً هاماً في التصويب على الممارسات التي تتصف بالذكورية في الاجتماعات، كما نظّمن نقاشات حولها وطرحن القضايا التي من شأن التنظيم أن يحملها، وساهمنَ في الكتابة عنها وخلقنَ شبكات وعلاقات بين التنظيم وناشطات ومجموعات نسوية. هذه المساحة التي خلقنها كانت هامة في حمل التنظيم تدريجياً إلى الانحياز لقضايا المرأة، المساواة والعدالة الجندرية
انتميتُ إلى ما أحب أن أسميه يساراً جديداً، هذا اليسار الذي لا يخجل بطرحه قضايا الحريات والحقوق الجنسية
إلّا أن ذلك لم يكن وليد صدفة، فتجربة الرفيقات في التنظيم لم تكن دائماً سهلة، إذ خسرنا مثلاً إحدى الرفيقات نتيجة تصرف ذكوري لأحد الرفاق، الأمر الذي عرَّضَ التنظيم للمساءلة الداخلية والبحث في تطوير آليات داخلية واضحة للتعامل مع هذه القضايا. فالتنظيمات، حتى تلك التي تحمل خطاباً تحررياً، ينزلق أعضاؤها إلى هكذا ممارسات، ونحن ندخل تنظيماتنا نساءً ورجالاً حاملين أفكار المجتمع الذي نشأنا فيه، ولا نخلعها خلعاً ومرةً واحدة عندما نعدو عتبتها.
يتم تشكّلُ الوعي الفردي والجماعي عبر مسارٍ لا يخلو من الصدامات والنقد والتثقيف والتعلم المستمرين لكافة الأعضاء، إلا أن تطوير آليات داخلية مثل آلية حل النزاعات أو آلية تقديم شكاوى غير كافٍ، إن لم يؤد بدوره إلى تغيرٍ جوهري في فهم الأعضاء للتمييز الجنسي والجندري، وانعكسَ هذا الفهم على سلوكياتهم.
على رفاقنا من الرجال خاصة، أن يعوا أن السلوكيات التي تعبر عن تحيزات ضد المرأة، ليست تعثراً فردياً ولا خطأً شخصياً عابراً، بل هي نتاج منظومة أورثتهم امتيازاتٍ تجاه النساء، وعليهم بالتالي أن يتفحصوها باستمرار، ولا بدَّ من أن يعترفوا أخيراً أن تحرر المرأة يتطلب منهم أيضاً تقديم التنازلات.
ما بين السياسي وغير السياسي
تجربتنا جاءت رداً على تجربة اليسار التقليدي في نسخته الستالينية المهيمنة، في لبنان والعالم العربي ككل، الذي تأثر بقيم أتت بها ورفعتها الأحزاب القومية، ومنها تمجيد العسكرة والزعيم والعائلة النووية وما يلحقها من توزيع جندري حازم للأدوار الاجتماعية. فالمشاريع القومية عادةً ما انطوت على مفاهيم محددة للأنوثة والذكورة، مثل تحديد دور المرأة في إعادة الإنتاج البيولوجي للأمة، والرجل كحامٍ لهذه الأخيرة
نأى هذا اليسار بنفسه إلى درجة كبيرة عن أي نقاش حول مسألة تحرر المرأة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حتى من داخل التراث الماركسي الغني. كما لم يتبنَ سياسياً قضايا النساء في معاركهن من خلال حملات أو مظاهرات وغيرها من أساليب الضغط. فاليوم حين تدعو منظمات حقوق المرأة إلى تحركات حول موضوع حق المرأة بمنح الجنسية لأفراد عائلتها مثلاً، أو من أجل مناهضة العنف الأسري والتحرش الجنسي، قلّما نرى تضامناً فعلياً من قبل منظمات اليسار، الأمر الذي أضعف جبهة الحركة النسائية وقدرتها على مواجهة هيمنة خطاب الطبقة الحاكمة الذكوري والطائفي.
وحتى عندما عبّرت هذه القوى عن حساسية تجاه القضية النسوية، اعتمدت نهجاً تنظيمياً فصلت فيه بين ما هو «جدي» و«سياسي» وما هو «ثانوي» و«غير سياسي» مثل قضايا المرأة. وفي مراحل سابقة تم إنشاء «لجان مرأة» احتوت نشاطات النساء، ولم تتمتع بأي نوعٍ من الاستقلالية، وكانت تتعرض لرقابة مباشرة من قيادة الأحزاب. إثرَ ذلك تم صرف نسوياتٍ، أو دفعهن للاستقالة من تنظيمات يسارية انتمين لها نتيجة نشاطهن النسوي. وهكذا فإن تجربة اليساريات النسويات غالباً ما كانت خارج اليسار الرسمي أو في نزاعٍ معه وفق ما توثّق الباحثة برناديت ضو
توثِّقُ رفيقةٌ اشتراكيةٌ-نسويةٌ أحد جوانب توتر العلاقة بين اليسار والناشطات النسويات، ففي عام 2011 خرجت مظاهرات في لبنان تحت شعار «إسقاط النظام الطائفي» بوحيٍ وتأثيرٍ من الثورات العربية، وفي أحد الاجتماعات التحضيرية لواحدة من المظاهرات التي رفعت مطلب المساواة، طرحت عدد من الناشطات أن تكون مقدمة المظاهرة نسائية، وأن تُقَدَّمَ بذلك رسالةٌ رمزيةٌ سياسيةٌ أقوى لناحية تقدم النساء صفوف المتظاهرين. كان مجرد طرح الفكرة، كما كتبت: «كفيلاً بإثارة بركان داخل الاجتماع، حيث تسابقت «القيادات» (جلّهم من اليساريين والعلمانيين) على رفضها، شكلاً ومضموناً (…) علماً بأن الرفض أتى بوضوح من موقع ذكوري جداً، يعتبر أن هذا الطرح لا يحمل بعداً سياسياً».
تعاطي هذا اليسار مع قضايا النساء كقضايا ثانوية وغير سياسية، هو موقفٌ طفوليٌ يتماهى مع رد الفعل السائد بأن النساء يمتهنَّ «النق». وهو قاصرٌ عن رؤية التمييز البنيوي الذي تتعرض له النساء، سواءً على مستوى القوانين التي تحكم العلاقات داخل العائلة، وعلاقات العمل، أو على صعيد النظام السياسي. علماً أن ما تصفه الرفيقة بالتعاطي الذكوري لا يتجلى بالتعاطي مع النساء حصراً، بل مع كل من يعبّر عن سلوكيات أو هويات جندرية خارج الأنماط المهيمنة الأنثوية والذكورية
إن اعتبارَ النضال لتحرر المرأة هو نضال لتحرر المجتمع ككل، هو من منطلقات أي يسارٍ تحرري، فالتمييز ضد المرأة هو تمييز بنيوي ينعكس قانوناً ولغةً وممارسةً وفكراً. تغيير ذلك كله، يتطلب تضامن جميع المتضررين والمتضررات من هذا النظام، أليس هذا ما يفترض أن تكون عليه معركة اليسار؟ إلا أنه على قدر ما يتوقع المرء أن يكون اليسار الحليفَ الطبيعيَ للنساء، على قدر ما فشل في تحقيق ذلك في كثيرٍ من المحطات.
أولويات النساء وأولوية التغيير
بالعودة إلى تجربة الرفيقة التي دفعتها وغيرها من الناشطات للتوقف عن حضور الاجتماعات، تقول: «المشكلة كانت في ظهور كراهية للنساء، غير مسبوقة، تجلّت بسحب هذه المسألة من التصويت، من خلال التهديد والاستهزاء، بالإضافة إلى الاستيلاء على إدارة الجلسة وخطفها. كأنما هناك حدث طارئ جداً استدعى ذلك. تخلل ذلك صراخٌ مستمرٌ لم يتح لأيٍ منا أن يقول كلمة واحدة. فَحوى الصراخ: نحن في ثورة الآن، ليس لدينا الوقت لمناقشة مسائل سخيفة»
تجربةٌ مماثلة تتحدث عنها الناشطة النسوية رين نمر، التي نشطت في تحالف «الشعب يريد» خلال الحراك الشعبي الذي قام إثرَ كارثة النفايات في لبنان في صيف 2015، تقول رين: «النساء متى بدأن بمواجهة النظام الذي يقمعهن، لا يواجهن حصراً رجال الأمن وعنف الشرطة. فالنساء أيضاً يواجهن التصرفات الذكورية ومحاولات إسكاتهنّ وتهميشهن وإقصائهن المستمرة داخل الاجتماعات التي تحضر لهذه المظاهرات. هذه التصرفات تصدر من مجموعات تتحدث عن التغيير ومناهضة القمع. وهنا أريد إعطاء بضعة أمثلة: ففي الاجتماعات، وخاصة الاجتماعات التنسيقية (جمعت عدة مجموعات ومنظمات وناشطين من يساريين وغير يساريين)، في أكثر الأحيان كان هناك تمثيل قليل للنساء داخل الاجتماعات، حيث الكلمة الأعلى للرجل الذي يرفع صوته. وعندما تبادر النساء للحديث يتم تجاهلهن أو تسكيتهن. كثير من النساء اعترضن على هذه التصرفات. إلا أنهن عندما اعترضن ووجهِن بردودٍ من نوع: بدنا نسقط النظام الآن، أم تريدين منا الانتباه إلى نبرة صوتنا؟، أو مثلاً: لا تكوني بالغة الحساسية، ولا تأخذي الأمور شخصية». تضيف نمر: «عندما حصل تحرش جنسي بالمتظاهرات، هناك نساءٌ تجرأنَ على الحديث بالموضوع وبادرت «صوت النسوة» لتوثيق هذه الممارسات. وبدأ يُطلب منا أن نبرهن بالدليل أن التحرش حصل، كأننا مضطرات ليس فقط أن نتعرض للتحرش، بل أن نبرهن للناس أننا تعرضنا له. وقال العديدون إن ما حدث «مبالغ به»، وهو ما أعتبِرُهُ أيضاً محاولةً لإسكاتنا. كما تم استعمال شهاداتنا حول التحرش من أجل تسجيل النقاط إن من طرف إعلام السلطة الساقط، أو من جهة أطراف من ضمن الحراك التي ردت على هذا الإعلام. طُلِبَ منا أن نسكت كي لا نضر بصورة الحراك. هذا ما لا أفهمه! (…) إذا كانت المجموعات القيمة على هذا الحراك لا تريد أن تضر به، عليها أن تعترف بهذه الممارسات، وأن تدينها وتفتح المجال لكي تخرج مبادرات ومطالب بتجريم التحرش قانونياً»
كتاباتُ ونقاشاتُ النساء عن التمييز الذي يتعرضن له في دوائر الناشطين جدُ ضرورية، لأنها تضيء لنا على مكامن الخلل في مقاربة مسألة المرأة، وتبيّنُ كيف قد يرمي اليسار وغيره من القوى الساعية للتغيير جانباً بجسمٍ واسعٍ من الناشطين والناشطات والحملات التي نشطت في السنوات الماضية في النضال من أجل المساواة والحقوق الاجتماعية بوعيٍ أو بدون وعي، بقصدٍ أو بغير قصد، وبحججٍ أو بدون حجج.
ومن بين الحجج المستعملة في دوائر يسارية أن النضال من أجل حقوق المرأة مستورد من الغرب، أو تقوده منظمات ممولة، أوبحجة عدم الاصطدام مع «أفكار المجتمع المحافظ»، التي أوصلت هذا اليسار إلى مكانٍ أصبح فيه يطبّع مع هذه الأفكار بدلاً من تحديها والسعي لتغييرها، مستبطناً الجوانب الأكثر محافظةً من المجتمع. ومن ذا الذي يهدد أخلاقيات المجتمع المحافظ أكثر من النساء؟! خاصة متى طالبن بحق التصرف بأجسادهن وحقهن بحمايتها من العنف؟ فلطالما كانت أجساد النساء مساحة للصراع والهيمنة السياسية. في الثورات العربية مثلاً، كان ذلك واضحاً جداً. اتُهمت المتظاهرات تحديداً بانعدام الأخلاق من قبل مناصري الأنظمة سواء في مصر أو اليمن أو البحرين، وتم اتهامهن بالتخلي عن أدوارهن كبنات مطيعات وأمهات وجرى استدعاء خطاب الفضيلة والشرف، كما قام العسكر بمصر بفرض فحوصات عذرية على النساء المتظاهرات، لتخويفهن وتعييرهن اجتماعياً وهذا كله بهدف تقييد نشاط المرأة السياسي جسدياً
وعوضَ أن تتلقف القوى الثورية هذه القضايا باعتبارها جزءً أصيلاً من معارك الثورة والحراك السياسي الذي لعبت النساء دوراً أساسياً فيه، جرى السكوت عن الموضوع. وبسبب اعتبار هذه القضايا غير سياسية، أو غير ثورية بالشكل الكافي، وبسبب خليطٍ من شعبويةٍ عبَّرَ عنها أحد الرفاق في مقابلة أجريتها في سياق هذا المقال، قائلاً: «قضايا النساء غير جاذبة للمجتمع مثل لقمة العيش»، ومن هيمنة توجهٍ سياسيٍ محافظٍ اجتماعياً، نأى هذا اليسار بنفسه عن نقاش هذه القضايا أو طرحها بالقوة التي تستحق.
من الخطأ الافتراض إذن أن هذا التغييب عرضيٌ، بل هو نتاجٌ للثقافة السياسية المهيمنة داخل التنظيمات التي تعمل على التغيير. ثقافةٌ تعتبر أيضاً أن هناك سلة أولويات «ثورية» لا تقع النساء من ضمنها بالطبع! عبّرَ عن ذلك أيضاً صراخ ذلك الرفيق: «نحن في ثورة الآن، ليس لدينا الوقت لمناقشة مسائل سخيفة».
يجب أن يعلم رافعو خطاب الأولويات أن خطابهم هذا يؤدي إلى تهميش قضايا المستغَلّين والمستغَلّات، وإسكات مثيريها. بالفعل، نحن نعاني بسبب تراكم كثيرٍ من الأولويات نتيجة تفاقم أوجه الظلم والاضطهاد، لكن القول بسيادة أولوية على أخرى هو تفريط بالعدالة وتدعيم للظلم. قالتها أيضاً أودري لورد: «لا يوجد نضال أحادي، لأننا نعيش حيوات ذوات قضايا متعددة». وإن كان من أهمية للتيارات النسوية، خاصة النسوية السوداء، والنسوية ما بعد الكولونيالية والنسوية الاشتراكية، فهي نقدها للنسوية الليبيرالية التي لا تسعى لتحدي النظام الاقتصادي والسياسي غير العادل بقدر ما تسعى لإصلاحات جزئية فيه، وذلك من خلال الإضاءة على تداخل وتشابك قضايا التحرر والعدالة، بمعنى أنه لا يمكن تناول حتى قضايا تحرر المرأة بمعزل عن مسائل أساسية كالاستغلال الطبقي والتمييز العنصري والاحتلال. أوجه الاضطهاد هذه تتفاعل مع بعضها بعضاً، ولا يمكن فهمها بعزلها عن بعضها. وبالتالي، الجندر ليس المحدِّدَ الأوحد، ولا يختصر كامل جوانب تجارب النساء، إذ من الصحيح القول إن النساء، على اختلاف طبقاتهن الاجتماعية، يتعرضن للتمييز، إلا أن حدة هذا التمييز تتفاوت باختلاف الانتماء الطبقي والأصول الوطنية والعرقية، فالتمييز الذي تعاني منه العاملات الأجنبيات في المنازل في لبنان، على سبيل المثال، متعدد الحلقات: تمييزٌ مرتبطٌ بأنهن ينتمين للطبقة العاملة، وبأنهن نساء، وبأنهن يأتين من بلاد «العالم الثالث»، ولأنهن يعملن في عمل غير مقدّرٍ ومثمنٍ اقتصادياً أو اجتماعياً لارتباطه تاريخياً بعمل المرأة.
تجربة العاملات هذه تختلف عن تجربة التمييز الذي تتعرض له النساء اللبنانيات من الطبقة نفسها، والتي بدورها تختلف عن تجربة نساء الطبقة الوسطى أو البرجوازية. هذه كلها نقاشات وصراعات هامة جرت بين التيارات النسوية المختلفة، وبقيت إلى حدٍّ بعيد خارج دوائر اليسار التقليدي، والتي من شأنها أن تكون حاسمةً في تعزيز فهمنا لكلٍ من مسألة تحرر المرأة والاشتراكية، والترابط بين حركات تحرر المرأة واليسار.
الميكانيك
وقعت أجزاءٌ من اليسار التقليدي في فخ المقاربات الاختزالية لتحرر المرأة، وهي النزعة التي ترى أن الصراع الطبقي سيؤدي ميكانيكياً إلى حلِّ مسائلَ كالتمييز القائم على أساس الجندر والجنس. هذه المقاربة تختزل قضايا الاضطهاد بقضية الطبقة، ولا تقدم إجابةً على سؤال أساسي مطروح على كلٍّ منا: كيف نواجه التمييز الجنسي داخل صفوف الطبقة العاملة نفسها؟
لا يمكننا توقع أن حل التناقضات الطبقية يؤدي إلى حل كل التناقضات الاجتماعية الأخرى تلقائياً، بل يجب أن نعمل على حل التناقضات الاجتماعية الأخرى، كالتمييز ضد المرأة والعنصرية والطائفية، بوصفها مشاكل قائمة بذاتها. لا شكَّ أن الحل التاريخي للتناقضات الطبقية قد يفتح المجال أمام مسار تحررٍ اجتماعي، إلا أنه بنفسه لا يؤدي بالضرورة إلى ذلك.
كاشتراكيين نعتبرُ أن التناقض الاساسي بالفعل في ظل النظام الرأسمالي هو التناقض الطبقي، إلا أن التحرر الطبقي ليس عملية ميكانيكية، بل يتطلب تدخلاً وصراعاً سياسياً، ويتطلب بالضرورة تضامناً طبقياً بين جميع المستغَلّين والمستغَلّات، المنقسمين والمقسمين بين هويات وانتماءات اجتماعية متعددة: جنسية وجندرية ووطنية وطائفية وغيرها. إلا أنه لا يمكن توقع هكذا تضامن من دون تدخل من القوى اليسارية، وتلك التي تتبنى أجندة تقدمية دفاعاً عن جميع المستغَلّين والمستغَلّات. وهذا التدخل يتطلب أن يكون اليسار مجهزاً بالعدة الفكرية اللازمة التي ترى هذه التناقضات داخل الطبقة العاملة نفسها، لا أن يكنسها تحت السجادة ويتهرب من مواجهتها بحجة أنها ستحلّ نفسها بنفسها في يوم غير منظور تقوم فيه ثورة اشتراكية.
يجب مواجهة حقيقة وجود تمييز ضد النساء، وهذا التمييز يستفيد منه حتى الرجال المنتمون إلى الطبقة العاملة. وبالفعل كان لينين صريحاً وشجاعا ًأكثر منّا اليوم بالحديث عن هذا الجانب قائلاً في إحدى رسائله إلى كلارا زيتكن: «هل هناك أي دليل أكبر على قمع النساء من مشهد رجل يراقب بهدوء امرأة تفني نفسها في عمل تافه، رتيب، يستنزف وقتها وجهدها، مثل عملها المنزلي، يراقب روحها تتآكل، ذهنها يزداد عتمة، تخفت نبضات قلبها، وتفتر إرادتها؟ عدد قليل جداً من الأزواج، حتى البروليتاريين، يفكرون في مقدار ما يمكنهم تخفيفه من أعباء وهموم زوجاتهم، أو إراحتهن تماماً، لو قدموا لهن يد العون في «أعمال النساء». ولكن لا، هذا من شأنه الحط من «تميّز وكرامة الزوج». هذا الأخير يطلب أن يتمتع بالراحة والسكينة (…) علينا اقتلاع وجهة نظر مالك العبيد القديم، سواء في الحزب أو بين الجماهير. هذه واحدة من مهامنا السياسية، إنها مهمة ضرورية على وجه السرعة»
واحدةٌ من منطلقات التراث الماركسي إذاً، أن تحرّرَ المرأة ليس شأن النساء فقط، بل شأن المجتمع ككل، والتيارات الثورية اليسارية على رأسها. وكيساريين، مهما تكن مدرستنا الفكرية، لا يمكننا النظر إلى مسألة تحرر المرأة إلا بوصفها جزءً لا يتجزأ من عملية التحرر الطبقي. إلا أن هذا الأخير لا يمكن اختزاله في حيّزه الاقتصادي البحت، بل يشمل أيضاً الحيّز الإيديولوجي والثقافي والاجتماعي في إطار النضال ضد أفكار الطبقة الحاكمة المهيمنة الذكورية والعنصرية والطائفية، التي تقسم وتضع العمال في مواجهة بعضهم بعضاً، فكما يكتب ماركس وأنجلز: «إن أفكار الطبقة الحاكمة هي الأفكار المسيطرة في كل العصور، أي أن الطبقة المتحكمة مادياً في المجتمع هي نفسها الطبقة المتحكمة فكرياً فيه. الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج المادي ووسائل تصريفه، لديها في الوقت عينه السيطرة على وسائل الإنتاج الذهني. باختصار: أفكار الذين لا يمتلكون وسائل الانتاج الفكري تبقى محصورة فيهم وحدهم. الأفكار المسيطرة ليست أكثر من انعكاس لعلاقات السيطرة المادية في المجتمع، ليست أكثر من هذه العلاقات متمثلة ذهنياً»
ما العمل؟
السؤال الأساسي بالنسبة لي هو كيف يمكنُ ألّا يُقابَلَ شعار «النظام الأبوي قاتل»
أولاً، من الضروري إعادة التأكيد على ما يبدو «بديهياً»: الأفكار المتحيزة ضد المرأة لا يمكن أن تكون قاعدة للفكر الاشتراكي. لا بل إن أساس الفكر الاشتراكي هو النضال من أجل وإلى جانب كل المظلومين والمستغَلّين ومن أجل تحررهم، ومن بينهم النساء كفئة مورِسَ، وما زال يُمارس عليها، قهرٌ تاريخي.
ثانياً، هنالك ضرورةٌ للتصدي للدعوات إلى تأجيل قضية المرأة بدعوى أنها ثانوية بالنسبة للصراع الطبقي، فكيف يمكن كسبُ النساء إلى جانب مشروع اليسار إذا ما قيل لهن إن قضاياكن ثانوية؟!
ثالثاً، ثمة ضرورة ماسة ومباشرة لتحقيق مصالحةٍ بين السياسات النسوية واليسار على صعيد الممارسة، بإخضاع بنى اليسار وأطر التعبئة وآليات وأنماط التفاعلات الداخلية فيه للتمحيص النسوي المستمر، عن طريق التقييم والتفكير بمفاهيم وأدوات التعبئة والنضال
وأخيراً، هناك ضرورة لوجود التنظيم الذي يوفِّقُ ما بين قضايا النساء وحاجات البناء السياسي الأوسع. وهذا أمرٌ ليس سهلاً في ظل التوتر القائم، ولكن لا بدَّ منه إذا كان اليسار يعبّر عن التزام فعلي بالأجندة النسوية، وإذا كانت النسويات يُرِدن دفع معاركهن في إطار تحالفات أوسع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن دون شكٍّ هناك مسؤولية مضاعفة اليوم على كل من ينتمي إلى الاشتراكية والنسوية معاً، في تحقيق ذلك.