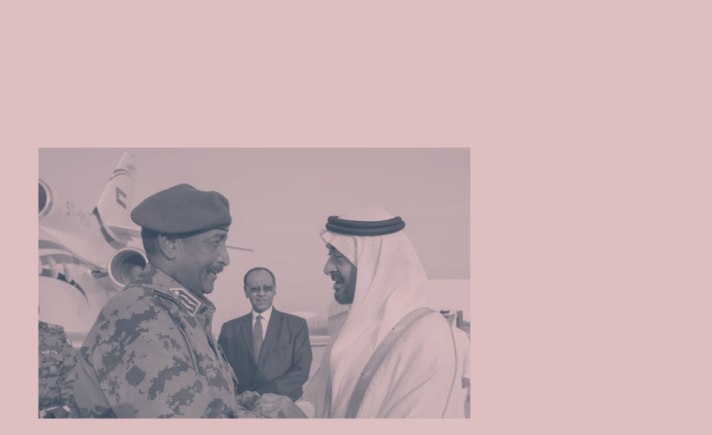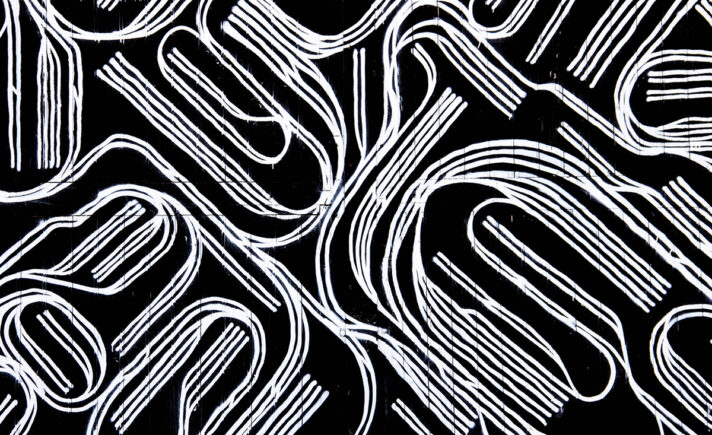في كثير من أنظمة الحكم التي تقودها أحزاب، لطالما تقصّد الحزب إدماج بنيته بالدولة ومؤسساتها، ليتحوّل الحزب الحاكم تدريجياً إلى الشمولية، إلى إرجاع كل ما للدولة إلى النظام، وكل ما للنظام إلى الحزب، وبالتالي يتم اختصار الدولة بالحزب الحاكم. وهذا الإرجاع والاختصار والاستحواذ يشمل البنى الفوقية والتحتية التي تقوم عليها الدولة. فحتى معنوياً، صار إسقاط نظام حكم ما مُروّجاً له على أنه إسقاط للدولة، وإن كان ثمّة من يُلام هنا فهو النظام الذي استحوذ على الدولة وبُناها.
تتضح معالم ذلك كلّما التصقت الأحزاب الحاكمة بإيديولوجية ما، فتملك بذلك المبرّر بل المحفّز «الأخلاقي» و«الشرعي» للإمعان في الشمولية والاستحواذ، إيماناً منها بأن الإيديولوجية التي تتّبعها ضرورةٌ للدولة والوطن والشعب، لخلاصها جميعها من هلاك أرضي يتمثّل بالمستعمر والإمبريالية غالباً، أو من هلاك سماوي يتمثّل بجهنّم. ولا تكتفي رؤية الحزب بضرورة الإيديولوجية عينها بل تتعداها إلى ضرورة أن يكون الحزب ذاته دون غيره، هو المتحكّم الشمولي بمعيّة الإيديولوجية عينها، وهو ممثلها الأكثر إخلاصاً لها، فهنالك دائماً الكثير من المحرّفين والمنشقّين المدّعين لاتباعهم هذه الإيديولوجية أو تلك، برأي الحزب، وهم حتماً خارجين عن الحزب، وهم دائماً ضمن «الآخرين».
والكلام هذا نجده في الأحزاب القومية والشيوعية والإسلامية والليبرالية، حين تتحوّل مرجعياتها الفكرية إلى إيديولوجيات متحكّمة. ومن هنا يبيح الحزب الإيديولوجي الحاكم لذاته اتباع كافة الأساليب للإبقاء، لا على حكمه فحسب، بل على السطوة التي يتمتّع بها هذا الحكم القائم على ديكتاتور متحكّم بالحزب والدولة. وهذا الديكتاتور هو ما قصده ليون تروتسكي حين قال بأن البروليتاريا (الطبقة العاملة) تُختزل في الحزب، والحزب في لجنته المركزية، وهذه الأخيرة في الأمين العام، فيُختصر الشعب كلّه بشخص الحاكم وتصبح قرارات الأخير ونزواته رغباتٍ شعبية. جوزيف ستالين المقصود به هنا.
وللتحكّم بالحزب بهذا الشكل الحديدي، كان لا بد أن يُبنى التحكّم على الترهيب، وكان لا بد للترهيب داخل حزب كهذا أن يأتي من طرف خارج الحزب بنيوياً، وأقوى منه، فكانت الشرطة السوفييتية. في كتاب التعقيد، عودة نقدية إلى الشيوعية للفرنسي كلود لوفور نقرأ: كان ستالين يستعمل فعلياً الشرطة للسيطرة على الحزب، مثلما استعمل الحزب للسيطرة على البلاد، لكنه كان يفعل هذا بصفته زعيم الحزب، لا مجرّد زعيم للشرطة، كان على ستالين أن يحفظ للحزب دوره الأعلى لأنه كان تجسيداً للأهداف الإيديولوجية للنظام وبالتالي أساس شرعيته.
نعرف أن نظام الأسد نقل من التجربة السوفييتية أسوأ ما فيها، في كل ما يخص أساليب التحكّم الشمولي والقمعي وإدماج الحزب بالنظام والنظام بالدولة، وبعد ذلك (وقبله) إيجاد طرف خارج البنية الحزبية للتحكم بالحزب والدولة، وضِف عليها أنها إيديولوجية قومية (بعثية) جعلته أقرب للحزب النازي كحركة قومية اشتراكية، منه للحزب الشيوعي. كما تحكّم ستالين بحزبه وبالتالي دولته من خلال الشرطة (السرية تحديداً) كذلك فعل هتلر، وكذلك فعل حافظ الأسد ويفعل ابنه بشار. معروف أن الحزب الحاكم في سوريا، «حزب البعث العربي الاشتراكي»، لم يكن يوماً حزباً حاكماً بالمعنى الفعلي للكلمة، بل كانت دائماً (وما تزال) أجهزة الأمن والمخابرات هي المتحكّمة بالحزب وقياداته وبالحكومة ووزرائها وبكل مفاصل الدولة. ومعروف أن عنصر أمن أمّي في سوريا قادر على إهانة أساتذة في جامعاتهم وأطباء في عياداتهم. فكان كل من حافظ وبشار أساساً رؤساء أجهزة الأمن، وهم بذلك رؤساء حزب البعث والدولة السورية المستحوذ عليها من قبل الحزب المستحوذ عليه هو والدولة من قبل أجهزة الأمن المبنيّة، ضمن قياداتها تحديداً، على أسس طائفية ومناطقية لضمان الولاءات. كانت الشوارع والأحياء السورية ما قبل الثورة تمتلئ بلافتات وملصقات وصور لبشار وحافظ وشعارات حزب البعث، ولم تمتلئ بما يشير إلى أجهزة الأمن بكل الأحوال، فالحكم العلني هو الشكلي والمشير إلى الحزب الحاكم، هذا الشكل الذي يحاول النظام السوري إبرازه، فما قاله لوفور عن ستالين الدولة والحزب والشرطة ينطبق تماماً على النظام السوري الذي باع السوريين والفلسطينيين والعرب شعارات القومية والحزب الإيديولوجي المؤمن بالـ «وحدة، حرية، اشتراكية»، وبالـ «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة». وهي شعارات شكلية ذات صلة بالإيديولوجيا التي احتاج النظام السوري إلصاقها به كونها أساس شرعيته (سورياً وعربياً)، ولأنها المبرّر لحكم البلد بالشكل الشمولي والقمعي الذي كان عليه.
وممارسات نظام الأسد القمعية ما قبل الثورة وبعدها كانت بصفته الشكلية، أي حزب قومي ودولة أساسية في محور الممانعة يحارب مؤامرات يحبّ أن يسمّيها «صهيو-إمبريالية» (ثم أخبرَنا أن أداتها هو الشعب السوري)، لا بصفته الفعلية العميقة كرئيس شبكات مخابرات تحارب شعباً طالب بحريّته وبإسقاط حكمها، وهذا ما كُتب أعلاه عن ستالين، فأساس شرعية نظام الأسد كان ما رُوّج له كدولة ممانعة لإسرائيل وكدولة عروبية تنادي بوحدة الأمة وحريتها، وهذه الشرعية الشكلية وُجّهت للعرب وفُرضت على السوريين، شرعية مبنيّة على شعارات لم تتعدَ الملصقات والمايكروفونات، شعارات كانت تغطّي قبضة أمنيّة تحكّمت بالبلد بالدم والحديد. فنجد الآن أن نادي معجبي ستالين كممثل للشيوعية (أو الشيوعية، بأل التعريف)، هم أنفسهم نادي معجبي الأسد كممثل للقومية (أو القوميّة، بأل التعريف)، الأول كسب شرعيته بتمثيله والأخير كذلك، الأول حكم بما هو خارج هذا التمثيل وكذلك الأخير. أما ضحاياهما فكانت مجرّد أدوات أو عقبات كان لا بدّ من التخلّص منها.