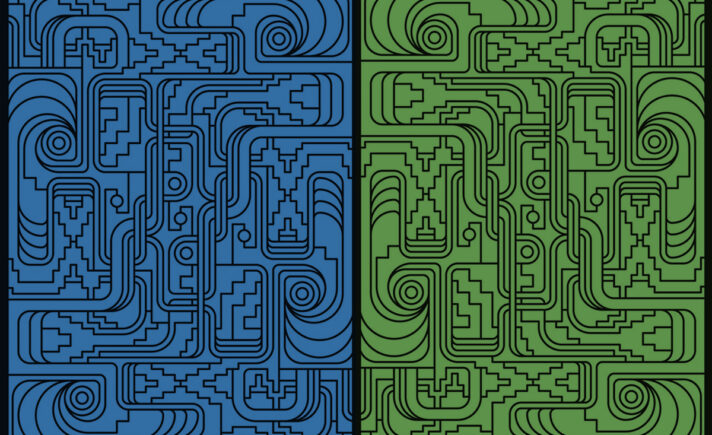قبل مائة عام، كانت الإمبراطورية العثمانية تعيش آخر عهدها، يحيط بها المتمرّدون من الجهات الأربع، إضافة إلى جيوش العالم الحديث، فيما نخبتها ممزّقة وسلاطينها حائرون ومؤسّساتها هرّأها الفساد والإفلاس. كانت السردية الكبرى التي أسس عليها «الرجل المريض» بقايا شرعيته هي التصدّي للمؤامرات، ورفض بيع فلسطين، والوقوف حصناً في وجه الغرب وأطماعه… وكان لذلك شعبية واسعة بين الرعايا، ولا سيما سكان المدن من المسلمين السنّة، بينما تغلي البوادي والأرياف وأسلحة الإنكليز، متحيّنةً ساعة «المؤامرة» التي ستطوي، بعد سنوات قليلة، ثمانية قرون من الهيمنة التركية على بلاد الشام. كانت «المؤامرة» مزيجاً من دولة فاشلة وحاكم سفّاح ورعايا غاضبين وجائعين، وعدوّ متربّص.
«ثوار الناتو» أخفقوا في بناء الدولة العربية التي أملوها، ووقعوا فريسة لظرف إقليمي ومكر استعماري مؤلم، قسّم البلاد واحتلّها وكرّس بين أهلها رواية ذات بُعد واحد: مؤامرة غربية صهيونية أطاحت بالسلطان المقاوم! بعد سنوات، كفّت «المؤامرة» عن كونها مؤامرة، وتفكّكت إلى «سياسة» انتدابية لم يحتج السوريون إلى الباب العالي للتصدّي لها، أما «الصمود» فغدا نضالاً سياسياً شعبياً تُحشد له الصحف والمظاهرات والإضرابات والأحزاب والمجالس.
واستمرّت الممانعة سرديةً متجذّرة في وعي السوريين بأنفسهم وبالعالم، وبقوا، حتى سنوات قليلة خلت، يؤمنون بها ويُخلصون في دعمها والافتخار بها.
لكن التسميم الذي تعرضت له الحياة السياسية السورية جراء هذه السردية، منذ «6 أيار» وحتى «فرع فلسطين»، جديرة بالتأمل والشكّ وإعادة تعريف «العدوّ».
كَسائر العقائد والسرديات الكبرى، نبعت الممانعة من نزعة محقّة، لكنها، مع كثرة التوظيف السياسي لها والشعور معها بالاكتفاء المعرفي والأخلاقي، تحوّلت من قيمة إلى أداة، ومن إيمان إلى طائفة، ومن انتفاضة إلى خراب معمّم. هي ثورة عالمية فاشلة ضد الإمبريالية، خطفتها السلطات ودجّنتها لتحارب خصومها وتبحث عبرها عن مزيد من النفوذ. اشتغلت قوى الممانعة على تأبيد سؤال الخطر، والتوجّس كأقلية من العالم، وإبقاء المؤامرة طبلاً كبيراً لدى الزعماء وكبار اللصوص حولهم. أما الواقع فمُبهم تماماً، وعصيّ على التحليل والتفكيك والتفسير. والقضية مجمّدة في برّاد القيادة الحكيمة، «بالحفظ والصون»، معزولةً عن الجماهير، وما من شغل نظري أو سياسي يستوعب تعقيداتها ويدفعها أو يدفع التفكير فيها إلى الأمام. الوطنية كذلك اختصاص السلطة، وحدها تعرّفها وترسم حدودها و«تهدي» إليها المواطنين، وهي وطنية جيوستراتيجية، لا مواطنين فيها ولا مجتمع، والشعب فيها مستقيل سياسياً لصالح حاكم غامض يعتاش على خوف محكوميه من «العدوّ».
مذ ثار السوريون يطالبون ببلادهم، تحفّظت الكثير من قوى اليسار والمقاومة العربية والعالمية، وهي التي لم تطلق الثورة، ولم تدعُ إليها، وليس في رصيد معظمها كلمة واحدة عن حرية سوريا وكرامتها المراقة في الأقبية منذ نصف قرن، طالَبتها بثورة مدنية سِلمية لا تلطّخ وجهها الرهيف، ثم حين «انحرفت الثورة عن مسارها»، وما غيرُ «المسار» انحرف عن الثورة، أخذت تنعي على السوريين انتفاضتهم وتؤكد لهم انتهاءها. الحرب الأهلية التي «حذّر» منها القوم صارت واقعاً يقاتلون عنه وفيه. الحزب الذي كان يرفض «العمالة» كوجهة نظر غدا ميليشيا جهادية في سبيل حكم عائلة، والنظام الذي كان أول إصلاحاته الرصاص الحيّ، ثم التخوين والتنكيل الشرس وصولاً إلى القصف بالطائرات والسكود ثم الأسلحة الكيماوية، لم يكن سوى قوة احتلال غاشمة. أما طهران، عاصمة الاستعمار الممانع، فقد مدّت إسرائيلَها بكل عُدَد السحق والتزوير. هكذا يرى السوري الممانعة لا تقدم سوى مشروع استعمار مضادّ، وهو استعمار قميء الكذب شديد الشرَه سخيف الحداثة متواضع المنجزات، يتأرجح في فلسطينيّته بين الأبويّة والتألّه. فبأيّ مظلومية وبأي يسار يَدين أيتام «المقاومة»؟ ومن هم حقاً «العثمانيون الجدد»، القتلة المتاجرون بفلسطين والإسلام؟ وبأيّ فلسطين بعد الكيماوي يؤمنون؟
اللافت أن كل ما تُدان به الثورة السورية تُدان به قوى المقاومة نفسها في لبنان وفلسطين، فالأسئلة السياسية لمجتمعاتنا لا تكاد تختلف بين عدوّ صهيوني ممانع وعدوّ صهيوني عادي. هل أجمع اللبنانيون أو الفلسطينيون مثلاً على خيار المقاومة المسلّحة يوماً ما؟ أم هل نجا أي من البلدين من «حرب أهلية» أو «عسكرة» أو «أسلمة» أو «تدخل خارجي»؟ بل إن قادة وحلفاء التحرير ابتلعوا في كلا البلدين معظم ثمراته، وفي كلا البلدين تحولت التنظيمات إلى أنظمة يشبّهها خصومها بالعدوّ. وفي كلا البلدين ترى من يدعون للمقاومة الأليفة ويشكّكون في جدوى «الحل العسكري» ويفتّشون، إزاء شراسة المحتلّ وعناد داعميه، عن «حل سياسي» يُريح ضمائرهم… فأين أصحابنا من كل هذا؟
بلى، إن أي ثورة هي حليف لقوّة ثالثة متربّصة بعدوّها، ولا يمكن للثورات وليس مطلوباً منها أن تعتزل السياسة في حربها ضدّ هذا العدوّ. وإن أي جيش تحرير هو جيش احتلال بالتعريف، يحتل ما يحرّره بسلطة القضية والسلاح. ولربما، ولربما جداً، تتقلص القضية مع الوقت وتتحول إلى أداة بيد السلاح، ويتحول أَبَوات الثورة إلى أَبَوات سلطة، ويستثمر النظام الجديد ولاء الناس لقضاياه كما فعل القديم مع الولاءات القديمة… حدث من قبل في فلسطين ولبنان. فيا جيشنا الحرّ، أمامك عدوّ يمثّل ما تفعله بالفاتحين الطائفية والبصائر القاصرة ونزعات العلوّ في الأرض: كان مجاهداً فأصبح بيّاع مجاهدين، وكان محرّراً فصار طاغية.
الشباب السوري الثائر الذي هتف لغزة وحيّى سامر العيساوي أصدق في وطنيته من المَسيرات المُسيّرة والأعلام التي تزاحمها صور الطغاة، وهو شباب لا يعاني عقد النقص التي تعانيها المعارضة تجاه خطاب النظام ودولته وداعميه، ولن يَقبل بلادَه بِنتاً يَصون شرفها أبٌ قائد ويعلّمها الولاء للعائلة.
الأرجح أنه لا فائدة من الإلحاح على أبطال المشهد الماضي ومُخرجيه. كل الأسئلة اليوم موجهة للسوريين وثورتهم، تلك المُلقاة مكتوفةً في اليمّ، والتي ما زالت الأجدر بتحدّيات المشرق وأسئلته الكبرى.