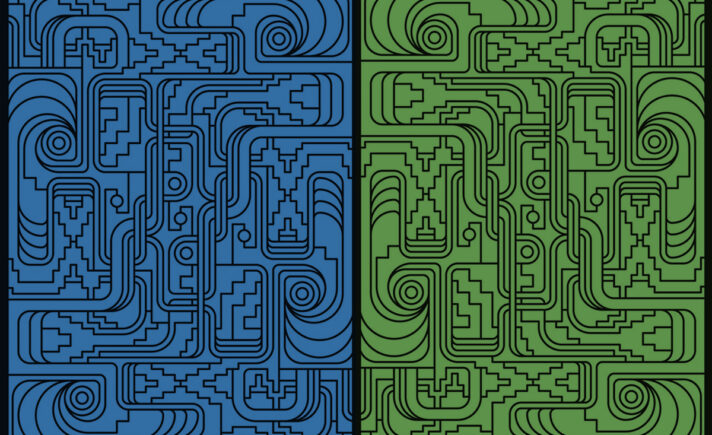تلاطم الكثير من الرثاء والجدل حول نعش الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، الذي لقي حتفه إثر انفجار مشبوه في جامع الإيمان الدمشقي الخميس الماضي ودُفن بالقرب من ضريح صلاح الدين. العالِم الذي حظي بشهرة طيبة فقدها خلال عامين من الثورة، نال قبراً قرب الملك الأطيب شهرةً في تاريخنا، نحن المعروفين بحبنا للعلماء وكرهنا للملوك. أسئلة كثيرة يمكن طرحها عن الدين والسلطة ودين السلطة وسلطة الدين انطلاقاً من تلك المفارقة، في بلاد كانت عاصمة الثقافة الإسلامية طوال عصور الانحطاط.
قضى الأشعريّ الراحل حياته مكرّساً لتقاليد تلك العصور، معبّراً في مواقفه وكتاباته عن اتجاه اجتماعي وفكري محافظ جداً يرفض التجديد والانشقاق. كان خصماً عنيداً لكل أطروحات النهضة، ليس فقط في سجالاته ضد الماركسية والوجودية والديمقراطية والقومية العربية…، بل حتى التجديدات النابعة من عمق التدين الإسلامي ارتاب بها، فالوهابية عنده مؤامرة بريطانية، والإسلام السياسي طيش ومروق وفتنة، وشيوخ عصر اليقظة (الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي…) محض ماسونيين تآمروا على الخلافة.
لكن الأشهر عنه كان موقفه الكارثي من ثورة بلاده. كان البوطي الممثل الأبرز للإسلام البرجوازي السوري، الإسلام المغرور والخائف في آنٍ معاً، والممسوخ أقليةً تعيش كغيرها تحت جناح النظام. لكنها أقلية مدلّلة! لأغنيائها ولرجال دينها كلمة عند السلطة لا تكاد تُردّ، ونمت لها حركات دعوية ومعاهد شرعية وجمعيات خيرية وتقاليد لم يكن يرى النظام في أي منها ما يهدّده، ما دامت مجفّفة سياسياً ومراقَبة مخابراتياً وتعود عليه بالرضا العامّ. «الإسلام» هو هذه الطائفة بالنسبة للبوطي، وهي عرضة أبداً للمؤامرات والمخاطر، وكغيرها يهدّدها الإسلاميون: يهدّدون تاريخها ورموزها وأبناءها وعلاقات المعرفة والسلطة القارّة فيها منذ قرون. هذا وقد عرف الطاغية الأب كيف يقدّم نفسه للدمشقيين كبعثيّ مؤمن ومعتدل، وصار عند البعض أميراً يحمي الدين وتدعو له المنابر، وكالعادة عادت السلطة السياسية ركناً ركيناً من المؤسسة الدينية. هذا الإسلام، الذي رأى في كل خصوم النظام خصومه، والذي لم يرَ الاستبداد إثماً، ولا الظلم كبيرةً، ولا الفقر كفراً، والذي كان واعظاً مسترحماً في أشدّ خلافاته مع الحاكم، كان طبيعياً أن يكون الدينَ الرسميّ لدولة الأسد. هو أكثر من مخاوف طائفية أقلوية، وأخطر من رجال دين مقرّبين: هو جزء حقيقي من النظام، جزء من فكره وأفيونه واقتصاده ونخبته المرفّهة، وبالتالي عدوّ طبيعي لأي ثورة.
هذا يقول الكثير في نقد التأويل الإسلامي أو السنّي للثورة السورية.
لكن الإسلام الرسمي لم يكن وحده، فإسلام «الحاكم الصالح» كانت تنافسه في التزلّف علمانية «المستبدّ المستنير»، وكلاهما فكر شعبوي، كلٌ على طريقته، يوبّخ المجتمع على فساده ويدعو للرئيس بالخير والبقاء. وبينما ورثت هذه العلمانية خطاب «حماية الأقليات» الاستعماري، ورث ذلك الإسلام خطاب «حماية الهوية» العثماني، ولم يزل الطرفان يتخانقان في ظل النظام ويُزايدان في الولاء له حتى ثار الناس على الثلاثة!
عبّر ناشطون وناشطات منذ البداية عن الخطر الذي يمثّله البوطي على الدين والوطن، وعن ضرورة نقد خطابه الديني وإسقاطه كرمز. غضّوا النظر عن الفقيه الجليل والكاتب البارع والصوفي الرقيق، وركّزوا في رصيد الشيخ على فكره الرجعيّ ونبرته التحريضية ووعظه السلطاني القديم، وبسرعة تحوّل ما كان نفوذاً شعبياً واسعاً إلى مزيج من الخيبة والغضب والسخرية، والتنوّر.
الخروج الجماعي من عباءة إسلام سلطاني خطوة فارقة، وإن ليست كافية، نحو تحرير الإسلام من التسلّط والاستغلال، ومن التراث الذي طال عليه الأمد وتحجّرت فيه أرواح المسلمين. لكن يبقى سؤال البديل. فالشرعية الدينية الجديدة، التي نُسفت على أساسها شرعية البوطي، لم تكن بِنت الثورة والمجتمع الثائر وحدهما، بل كانت إسلاماً قديماً صحا وأعيد إنتاج خطابه وتدويره في ظروف السوريين الجديدة، وهو «إسلام رسمي» آخر لـ«سلطان» منافس، وجد في الثورة حليفاً له ضد العلمانية أو ضد الشيعة أو ضد التصوّف. ليس الخطاب الإسلامي الصاعد مستقلاً وحرّاً إذن، وهو، ولا سيما في ظروف العنف اليوم، يُبدي ألقاً أقلّ بكثير من الإسلام السوري العريق، ويخلق في نفوس كثيرة غصّة وحنقاً على الخريطة الدينية الجديدة، أن كيف ينقرض إسلام صوفي وادع لصالح إسلام عُصابي ممتلئ طيشاً وعنفاً ورغبةً في تحطيم العالم؟
لكن لا شيء أكثر سلبيةً واستلاباً من التحمّس الأعمى للإسلاميين الجدد، إلا النحيب والردح الذي يكتفي بشتم «النفط» والغرب والفقراء، ولا يرى في الإسلام الجديد غير ذئب همجيّ. على «الإسلام الشامي» أن يتحرّر قليلاً من الخوف، وكثيراً من حضنه السياسي الفاجر، وأن يسأل خطاياه المتراكمة وسذاجته السياسية وفكره البابوي وكفره بالتغيير وبالثقافة، وسُكناه الطويلة بين القصور وتكايا الدراويش. إن صحوة الإسلام السياسي في سوريا، بالتزامن مع ربيع إخواني وسلفي على طول العالم العربي، هي انتقام لنصف قرن من السحق والحرمان، وصعود لشرائح كثيراً ما عجز الإسلام السائد عن مدّها بالسند الاجتماعي والروحي، وتلبية لحاجة الكثير من الثائرين لتبرير ديني وحليف نفسيّ وأيديولوجيا حرب.
لكن ماذا عن المستقبل؟ ما احتمالات إنتاج خطاب إسلامي أعدل وأعقل، أقلّ كِبراً وأشدّ انحيازاً للضعفاء، وفي نفس الوقت أكثر قوةً واستقلالاً عن القوى؟ الحرب تعلو على أصوات التحليل، ولا يبدو بعد ما إذا كان الذين خرجوا من إسلام النظام سيأسِرُهم إسلام «التنظيم» أم لا. لكن الأفق واسع. ثمة جيل من الشباب المتديّن خارج من الجماعات والأحزاب ناقد لها، وثمة قراءات مدنية وديمقراطية وأناركية للإسلام تحوز مع الأيام قدراً أكبر من الاتّساع والاتّساق. ولقد نكون والإسلامَ في حال أفضل لو قابل صعودَ الإسلام السلفي صوفيةٌ ناهضة، أقل كسلاً وأكثر شباباً وأشد اندفاعاً في الدفاع عن الحق والعدل والجمال. ما زال لدى الإسلام الكثير ليقوله عن الجهاد والشريعة والمرأة والحكّام والطوائف… إن إسلاماً دحر الفرنجة وقاتل الفرنسيين وفتن الشرق والغرب، جديرٌ أن يكفّر عما فعله بنا وبنفسه.